بعد مسيرة من التشرّد الشاعر هاشم شفيق: لندن منحتني الحرية ورفعت الحجاب عن ذهني
بيروت - إسماعيل فقيه 16 مارس 2019
الشاعر هاشم شفيق

الشاعر هاشم شفيق
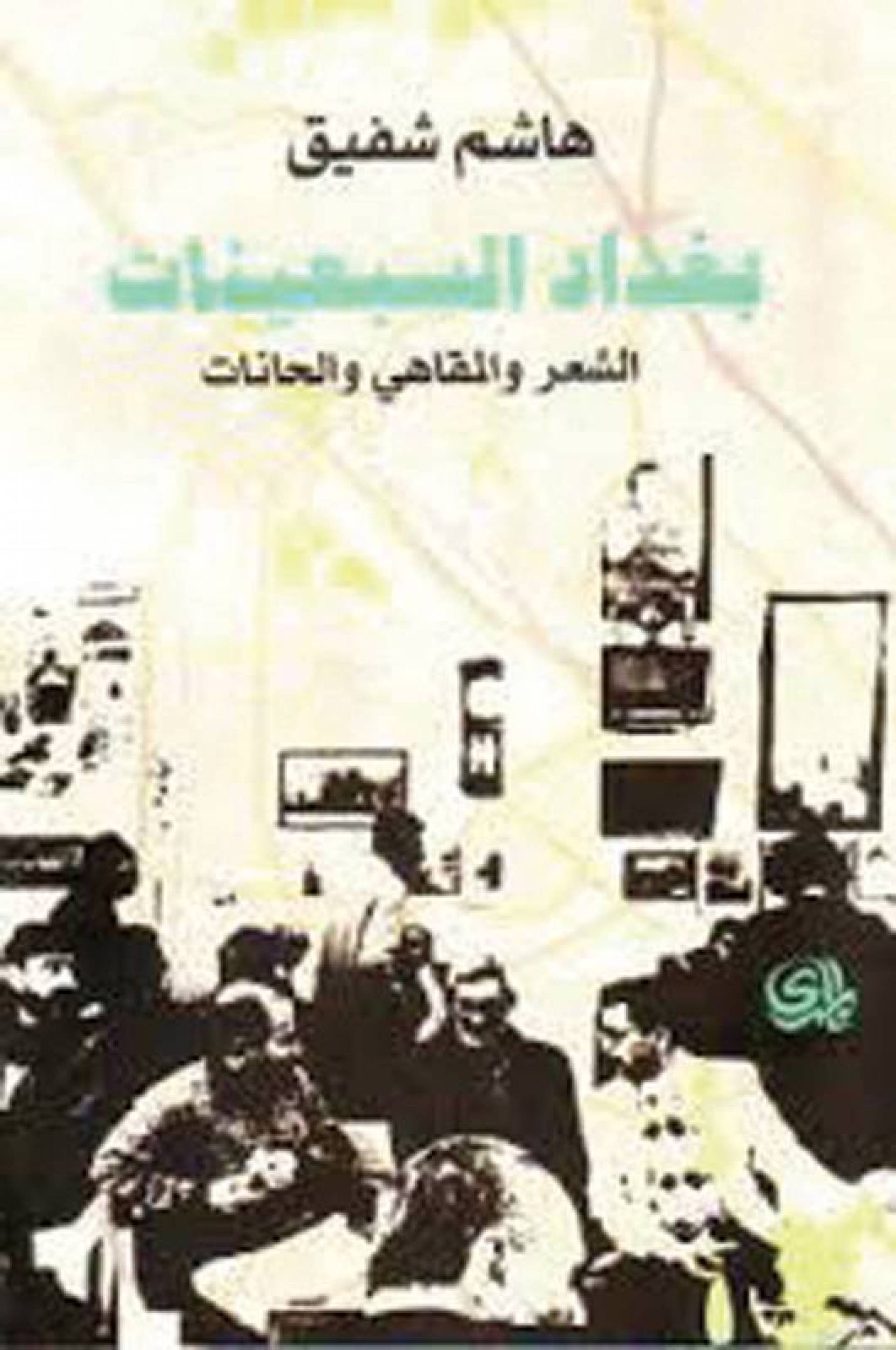
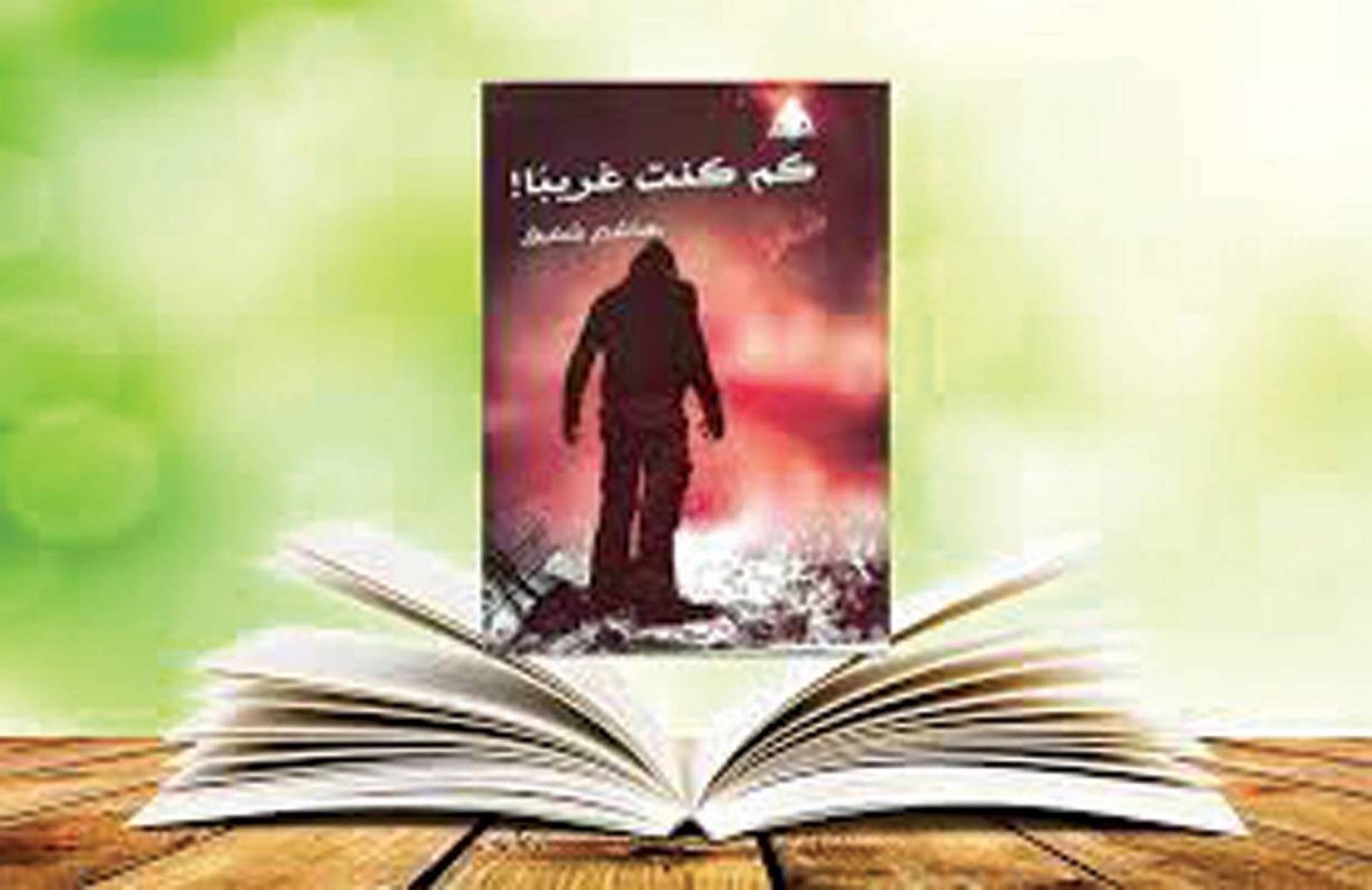
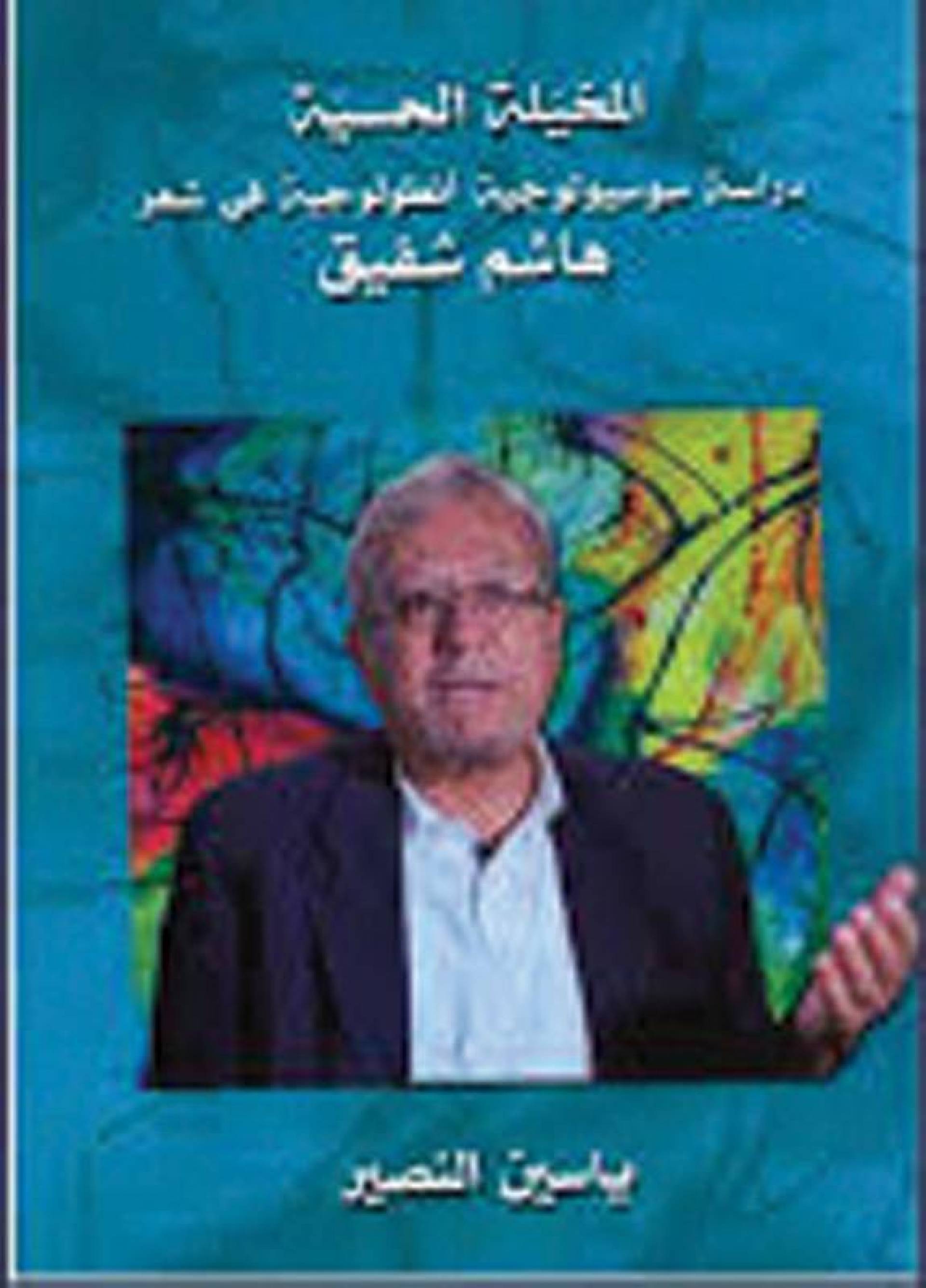

- أين تعيش اليوم، وماذا تفعل في غربتك القاسية؟
منذ أكثر من ربع قرن وأنا في لندن، أقرأ وأكتب وأعيش. لندن منحتني الحرية، ورفعت الحجاب عن ذهني. لقد عشت في دمشق وبيروت وقبرص وبراغ. في بيروت ذقت ويلات الحرب اللبنانية، ونجوت بأعجوبة خلال حصار بيروت، حيث إن المركز الإعلامي الذي كنت أعمل فيه قد تعرض للقصف مراراً من جانب القوات الإسرائيلية. كنت أمشي بين القذائف. لم أكن آبه للموت حينذاك، وهو يتقدم من كل اتجاه. كنت ثورياً وماركسياً وفتى عاشقاً، وأظن أن العشق هو الذي أنقذني من الموت والنهايات المُحتَّمة، وهو مَن أبقاني حياً حتى هذه اللحظة.
أنا الآن متفرِّغ للكتابة، أكتب بشكل منتظم لصحيفة عربية، وأنشر مقالات نقدية وأدبية. أكتب شعراً كثيراً ولكنني لا أنشره الا بمحض المصادفة. فدور النشر تطلب من الشاعر أنْ يدفع لها، وأنا منذ فجر أشعاري الأولى عاهدتُ نفسي على ألا أنشر كتاباً على نفقتي الخاصة، وقد حدث ذلك في مجموعتي الأولى «قصائد أليفة» التي طبعتها «وزارة الثقافة» العراقية، فحصلت مقابل نشرها على مكافأة نقدية، كانت بمثابة حق المؤلف على الكتاب. كنت حينذاك شاباً في أواسط العشرينات، ولم أكن أمتلك في غرفتي سرير نوم، فذهبتُ واشتريتُ سريراً لي، بدلاً من «الكنبة» التي كنت أنام عليها. آخر مجموعة صدرت لي هي «شال شامي»، وصاحب الدار شاعر شاب، قدّم لي نسخاً كتعويض عن الحقوق، وهذا بحد ذاته يُعدّ كرماً منه، حيث إن الدار هذه لا تزال في خطواتها الأولى. أما المجموعة التي سبقتها، وهي «كتاب الأشياء» فقد طُبِعَتْ في دار «بلومز بري» البريطانية ـ العربية، ودفع المشرفون على الدار حقوقي كاملة، نظير ذلك. أنا اليوم أنتظر مثل هذه الفرص، وهي فرص نادرة وقليلة في زمن صار الجميع فيه يهاب نشر الشعر، ويتحاشاه تحت ذرائع ومسميات عدة، مثل سوق الكتاب الشعري في حالة كساد، أو هبوط وتراجع، أو زمنه قد ولّى والآن هو زمن الرواية، وغيرها من الحجج والمسوّغات التي يتقن أصحاب دور النشر التبشير بها، ومن ثَمَّ تسويقها الى الشعراء والكتّاب العرب.
- ماذا قال لك الشعر من جديد، وإلى أين أوصلك؟
الشعر فن لا يكشف عن محتواه بسهولة، وانما يسترعي التمحيص والتأمل والتفكير. وهو فن التحليق الى الأعالي، والرؤى المهاجرة خلف التخوم والأقاصي والمنعطفات المجهولة والغامضة. كما أن للشعر كشوفاته وسياقه الذي يحتفي بالحياة والكون والأشياء. كل شعر هو موقف، وأقصد هنا الشعر الحقيقي الصادر عن شاعرية حقة، موقف من الحياة وتفاصيلها الكثيرة والمعقدة، موقف من الإنسان في معاناته الوجودية، موقف من الطبيعة التي تكاد تكون الأخت الكبرى لنا، موقف من الذات والعالم. الشعر هو موقف أزلي من الإنسانية جمعاء، فالبشر هم إخوة حيثما كانوا، وكيفما بدا جنسهم وعِرْقهم وديانتهم ومذهبهم، وأينما حلّوا... الشعر لغة الآلهة، وهو مادة سحرية معجونة بالهواء، وقد يُصبح بذلك خبزاً أو طيفاً أو نسيماً، ولهذا فهو منحاز الى البشرية من دون تمييز فوق هذه الأرض التي لم تعد تقبل بالآخر، ولم تعد تتماهى وتتآخى وتتكافل. ثمة زمن وحشي آخر حلّ، زمن قوميات وصراع هويات وحضارات. وهنا يأتي دور الشعر لكي يجنح بلا تردد صوب الأخوّة الإنسانية، مهما ظهر في الحياة من أعطاب وفجوات كبرى وأسافين. مهمة الشعر هنا هي هدم الأسوار ورفع الحواجز التي تحجب الرؤيا والفن وتحاول وأد الجمال والرومانسيات والعوالم الشاعرية.
- كيف ترى وطنك والإنسان من مكانك البعيد؟
وطني لم يعد وطني، إنّه بلاد مذهبية، ثمة صراع واضح على المال والسلطة، والبلاد هي بلاد منهوبة ومنكوبة، والإنسان فيها يحيا حياة العبودية والقهر والإذلال، في زمن قادة منبوذين وأنذال ومُسيَّرين ومحكومين من الخارج. لا هُوية للعراقي سوى الانحناء وقول كلمة نعم بدلاً من لا. هويته الوحيدة هي تقديس الماضي وتأليه القوى النائمة في بطون التاريخ، وعبادة الصورة، وتجليل كلّ غاية دموية ثأرية. انتسبت الى البعيد، وصارت جزءاً من التقليد، لكي تكون النتيجة كما هي عليه اليوم. عزل وتنابذ وكراهية مُثلى تسود المجتمع العراقي، يُعمِّقها الشعار والراية والعقل الأسود الذي لم يكتفِ بالتجارب، لا بل أوغل في تمهيد المسار الجديد بعد تغيير النظام الديكتاتوري السابق. اليوم يتم القتل على الهُوية والاسم، لا بل وصل الأمر الى كل شخص وسيم وبهيّ الطلعة، أو له آراء وأفكار مغايرة للسائد، فيُختطف ويُعذّب أثناء الاختطاف، ثم يُقتل برصاصة في الرأس، كما حدث مع الفنان المسرحي كرّار نوشي. اليوم وبعد انتشار الأمراض التي تصيب العراقيين مثل السكري وأمراض القلب والكلى والكبد، وازدياد عدد المتعلمين في العراق وعودة بعضهم من الخارج، بدأ قتل الأطباء، خصوصاً أولئك المُساندين للفقراء، ناهيك عن الخطط المُبرمجة والنافذة منذ زمن، والداعية الى تصفية أساتذة الجامعات والعلماء والمتنورِّين الكبار، والمتخصّصين في البحوث العلمية.
- هل زرت بلادك، وماذا رأيت وبمَ شعرت؟
أجل زرت العراق، وكانت الصدمة كبيرة. بلدي تغيّر كثيراً، ومن هنا وجدتني غريباً فيه، أجول في أرض غريبة عني. الناس بدّلوا جلودهم، البعثي السابق انشقّ الى نصفين، النصف الأول صار لطّاماً وسبّاقاً لتقبيل يد الدجّالين، ممن يُسمّون أنفسهم بالسادة، وهم أشد البعد عن الانتساب الى أهل البيت الكرام. السيِّد الذي يحكم الآن، ويضع العمامة، يده ملطخة بدماء العراقيين. إنه لص كبير ودجّال ومتآمر مع الخارج، وخصوصاً دول الجوار. أما النصف الآخر فقد ذهب وصار داعشياً، يدافع ويناضل ببشاعة وقسوة وعنف لا يضاهى عن الماضي المندثر. لقد جسّدتُ كلَّ ما رأيتُ وشاهدتُ ولمستُ من تجارب شخصية، وواقعية ويومية، تفصيلية في كتابي « بغداد السبعينات، الشعر، والمقاهي، والحانات» وهو كتاب نثري وسيرة أدبية، وفي روايتي الثانية التي صدرت قبل خمسة أعوام «أشهر من شهريار»، وكذلك في ديواني الذي يصدر حالياً في القاهرة بعنوان «كم كنت غريباً».
- هل أنتَ حزين أم سعيد اليوم ولماذا؟
أنا حزين بلا شك لما أصاب المنطقة العربية من كوارث وهزّات ودمار وخراب شبه كامل. العراق المتمثل بخراب الفلوجة والموصل، وخراب سوريا وأجزاء كبيرة من أراضيها. سوريا الجميلة والمحبوبة بين البلدان العربية. سوريا الغنج والدلال والنِعم الأرضية، شُرِّد أهلها الى شتى البلدان، وهُجِّرتْ عوائلها بالملايين، وتم قتل الآلاف من خيرة أبناء هذا الشعب العربي، الذي كان يُعَدّ رمزاً للقيم الحقيقية الأصيلة، ومثالاً للعيش المشترك في المنطقة العربية.
اليمن وما يسوده من حرب مدمّرة، وما يفتك به الآن من أمراض. اليمن السعيد لم يعد سعيداً لعقود لاحقة... ليبيا والتناحر الواضح والفاضح في سياستها التي صارت نهباً للميليشيا العنيفة والمتطرفة، ورحيل العقول الراجحة والمُسالمة والمُحبّة للتآلف والتعاضد، لترتع في ظلامها الآن الضواري والأفكار التدميرية التي تحاول رسم سياستها ومستقبلها المعتم والمجهول... أما سعادتي فيمكن تلخيصها في تواصلي مع القراءة والكتابة ومع مَن أُحب.
- ما أخبار الحب، هل دهمك مجدداً؟
الحب يدهمني في كل لحظة، لأنني كائن هش ورقيق، وقد تطيحني نسمة إذا كانت تقصدني. الحب الآن وأنا في هذه السن، اتخذ مسلكاً آخر، ومفهوماً مغايراً، وطريقاً عامَّاً، متعدداً، متشعِّباً ومختلفاً عما هو متعارف عليه. الحب بين ذكر وأنثى، بين عاشق ومعشوق، هذا الحب الفيزيائي موجود فيَّ ومترسخ، وهو ما يجعلني أعمل وأكتب وأنشر وأتضامن وأختلف مع الآخر، لأكون أنا في النهاية. هذا الحب المتعارف عليه، متوافر في عمق أعماقي. إنه منجم الذهب الذي أضاء جميع فصول حياتي، ولكنني الآن دخلت طوراً جديداً مع الحب، فأنا مُحِبٌّ ميتافيزيقي، أو محب بوهيمي، أحب الفراشات وأنواعها، ديواني الجديد وهو عبارة عن قصيدة نثرية طويلة سمّيته «أستعين بفراشة». أنا اليوم أتماهى مع حركة الفراشات وتحولاتها، وأحياناً أرى الفراشة فتاة حالمة تعبر أفق مخيلتي.
- أما زلت تكتب الحب في أيامك وغيابك؟
أنا كائن مُحِب. الحب صنعني وصيَّرني عاملاً في خدمته. أنا خادم الحب، وأجير لديه. أجري هو الكلمات، الكلمات العاشقات. يمنحني الحب مقابل العمل لديه، قصائد في منتهى الرقة والجاذبية والشفافية، وهذا يسعدني كوني مدللاً عنده. أظن أنه يعاملني معاملة مختلفة عن الآخرين. هذه الصيرورة الفنية اللافتة، كيف لا أعشقها، وقد تجلتْ في أكثر من ديوان، وبالأخص ديواني الذي أعتبره نقطة تحول في سياق تجربتي الشعرية «غزل عربي» الذي صدر قبل أكثر من عقد عن «دار رياض الريس»، والناشر هو صحافي وكاتب مرموق أولاً، وناشر ثانياً، ويُقدِّر الإبداع والجهد الفني والمعرفي، وقد طبع منه دفعة واحدة خمسة آلاف نسخة. في هذا الديوان صببتُ كل تاريخ عشقي الطويل، ونثرتُ الغزل المُرمَّز على صفحاته الكثيرة.
أما الديوان الآخر الذي حمل قصائد غزل وحب وعشق أخرى، فهو ديوان «الرجل الرومانسي»، ولكن صدوره تعثر بحيث لم يصدر حتى كتابة هذه السطور، وما زلت أبحث عن ناشر يقدِّر مضمونه ومعانيه، ويطبعه على نفقته الخاصة. وهنا تنبغي الإشارة الى أن قصيدة «أستعين بفراشة» وهي لم تنتهِ بعد، وأظن أنها ستشكل ديواناً شعرياً صغيراً، هي آخر ما كتبت، وفيها يعود الحب متجلياً في أكثر من صورة وهدف ورؤية. هنا شعر الحب غدا شكلاً آخر، واتّخذ نهجاً وسبيلاً مختلفين عما كنت أكتبه من قصائد حب. هنا في هذه القصيدة التي لم أنشرها بعد، ثمة رؤى فلسفية وروح عرفانية وجهد هرمسي يستبطن القصيدة، ليجعلها تتجه وتسير باتجاه نواحٍ نافرة، وغير مهمومة بالتنميط الشعري السائد في شعر الحب الآن.
- متى تصل الى مبتغاك في الحياة، وهل ترى مستحيلاً يحول دونه؟
الإنسان بطبيعته غير قنوع وراضٍ ومكتفٍ بما مُنح وأعطي ووُهِبَ خلال مسيرته في الحياة. أنا بطبيعتي لست طمّاعاً، ولا باحثاً عن الجاه والمال والسلطة. هذه الأمور لا تعنيني أبداً. الشعر هو غايتي الوحيدة. الجوائز أيضاً لا تهمني، فوراءها تقف المصالح والمنافع المتبادلة والتدليس، وأنا لا أملك شيئاً لكي أقدّمه لهذا المُحكِّم أو ذاك. منذ ما يُقارب الثماني سنوات، قدّمتُ لجائزة «سلطان العويس» أعمالي الشعرية، ذلك أنني أراها نزيهة، وغير متحيِّزة، وقد مُنِحَتْ لشعراء مبدعين يستحقونها، ولكنني ما زلت أنتظر، ولا يهمني إذا نلتها أم لا، فجائزتي هي مواصلة كتابة الشعر الذي أقدسه تقديساً خاصاً. لقد صدرتْ لي أربع وعشرون مجموعة شعرية، آخرها في القاهرة، وهو مجلّد يضم أربع مجموعات شعرية جديدة، لم تصدر من قبل. ولي في رصيدي غير المنشور ستٌ وثلاثون مجموعة شعرية موزونة، هي حصاد العمر الوفير، ولكن المعضلة التي ستواجهني هي مَن سيطبع هذا الخزين المُنضَّد والمصفوف على شكل مجموعات شعرية جاهزة للطباعة، دار نشر كريمة، أو مؤسسة ثقافية مرموقة، أو دولة عربية تهتم بالشعر والثقافة والأدب، وهذه لا توجد إلا في الخيال!
- بعد التجربة الطويلة في الشعر والحياة، ماذا ستقول بعد؟
هناك المزيد من الأمور والتفاصيل الصغيرة المهملة والمنسية والهامة في الوقت عينه، لم نكتب عنها بعد، وهناك الكثير من الحب الذي سيجعلنا نخترق تياراته لنغوص في الأعماق بحثاً عن الجواهر التي ستنير ما تبقى من حياتنا.

