الشاعر وديع سعادة العائد من مهجره القسري لم يترك مسقط روحه


غادر الشاعر وديع سعادة وطنه لبنان منذ ما يفوق العقود الثلاثة، مهاجراً الى أستراليا، ومنذ تلك المرحلة وهو في طريق الذهاب الى أقصى الغياب. لكنه لم يصل الى الهجرة بقدر ما بقي خارجها، جاثماً في الحضور الدائم، في ظلال مكانه الأول، وطنه. وطأ أرض الهجرة ولم يطأ مداها المفتوح، فبقي في الذاكرة ينشد الحنين الى مسقط روحه. ولد عام 1948 في قرية شبطين في شمال لبنان، وعمل في الصحافة العربية في بيروت ولندن وباريس، قبل هجرته إلى أستراليا في أواخر عام 1988، وما زال يعمل في مجال الصحافة والكتابة، والأهم أنه يواصل القصيدة، يكتبها وتكتبه. صدر لوديع سعادة أكثر من عشرة دواوين شعر، باكورتها «ليس للمساء إخوة»، «المياه المياه»، «رجل في هواء مستعمل يقعد ويفكر في الحيوانات»، «مقعد راكب غادر الباص»، «رتق الهواء»، «بسبب غيمة على الأرجح»، «قل للعابر أن يعود... نسي هنا ظله»، و«من أخذ النظرة التي تركتها وراء الباب؟»، وسواها من الأعمال الشعرية والنثرية الرائدة.
في كل عام يعود وديع سعادة الى مسقط رأسه، يزور وطنه، بل يعود لزيارة وطنه، كما يقول. لا يترك أستراليا، ولكنه يعود الى وطنه، ليرى ويسمع صوت الحياة التي صنعته وصقلته، وأنتجت قصيدته. بل ربما يزور أستراليا ويعود الى لبنان، والعكس بالعكس. وفي عودته الآنية، وصل الشاعر الى شبطين، وتلقّفته أرضه، وتلقفها، عانقها وعانقته، وكانت لبيروت الحصة الأولى من إطلالته الأولى، بجلسة شعر، أمسية شعر أحياها في «زويا» في شارع الحمراء، حيث تحلّق حوله عشاق قصيدته، وكذلك كان لنا معه عناق من نوع آخر وأشواق حميمة، حيث التقيناه في حوار ثقافي شعري، في ليل بيروت الذي يعشقه، وغلب فيه الحنين على كل شيء.
قال الشاعر وديع سعادة في مستهل الكلام: «رغم عودتي وحبّي وأشواقي لوطني، أشعر اليوم، وكما في السابق أن لا مكان لي. لقد تغير مفهوم المكان، وحنين المكان. أشعر اليوم أنني، مثل سواي، أعيش في الزمن، لا في الجغرافيا الثابتة. لم يعد يعيش في زمننا ذاك الفلاح الذي يتشبث بأرضه وترابها وأشجارها وزهورها. نحن اليوم سيّاح في أرض الزمن المتحرك، نصول ونجول كمن يتحرك في المتاهة. نطير ونمشي ونحطّ ثم نعود ونتحرك ونطير، من الحنين الى الغربة والمطارات والمدن البعيدة الى المتاهة المتجددة. إننا نعيش مع الجحيم وربما في قلب الجحيم. لقد تغيرت الحياة، وانقلبت رأساً على عقب».
ولدى سؤاله عن لحظة ولادته ومجيئه الى الحياة، أجاب وديع بنبرة دامعة: «الحياة يا صاحبي جميلة ولكنها صعبة وقاسية، قد ندركها وقد لا نستطيع إدراكها... مرة كان والدي في أيام الحرب يبحث في البراري عن عظمة، ليطحنها بحجر ويسدّ جوعه. من نسل تلك العظام المطحونة خرج أطفال، كنت واحداً منهم؛ كنت ابن عظمة مطحونة. وما زالت الحياة تطحنني وتطحن زمني وخطواتي».
استرسل الشاعر وديع سعادة في الحديث عن طفولته، وعن علاقته بالمكان الأول، عن البيت والعائلة، عن علاقته بوالديه، وماذا تبقى من كل ذلك في شخصيته على الصعيدين الشعري والإنساني، وعن فكرة الأبوّة في الشعر، فقال: «أنا قروي ابن قرية وديعة تقع في شمال لبنان، وُلدتُ في بيت متواضع سقفه وأرضه من تراب، وعشت طفولتي مع الشجر والتراب، وأظن أنني لا أزال أحمل ذاك التراب إلى اليوم في قلبي، وأينما ذهبت وحللت».
وأضاف قائلاً: «أنا ابن تلك الطبيعة البريئة، ابن ذاك الزمن الفاتن، وكذلك ابن القسوة التي يعانيها القرويون، لا سيما الفقراء منهم. فأبي مثلاً لم يكن يملك ثمن لعبة يشتريها لي، وعلّمته تلك الظروف الصعبة أن يكون قاسياً أيضاً مع أولاده، لكنه بالتأكيد كان يحبّني، وتعلمت منه ومن أمي أن أحب الناس، وكذلك الطبيعة والحيوانات. لا شك في أن تلك الطفولة كان لها تأثير كبير فيّ، على الصعيدين الإنساني والشعري. فأنا ابن تلك الطفولة أولاً، وابن كل ما مرّ في حياتي بعد ذلك، وكل ما عرفته من أمكنة وناس وزمن. أما بالنسبة إلى الأبوّة في الشعر، فأعتقد أن كلاً منا هو ابن كثيرين، شعراء وغير شعراء، مرّ بهم وتركوا أثراً ما في شعره وفي مفاهيمه الحياتية، وكذلك هو ابن كل التجارب التي خبِرها في حياته. لذا، لا أعتقد أن لأي شاعر أباً واحداً، وكذلك أنا لست أباً لأيّ شاعر».
وتأخذه الذكريات الى الماضي الجميل الذي عاشه في بيروت، فيتذكر الشاعر تلك الليلة «الساحرة» التي أمضاها في بيروت، ويقول: «التقيت بالشاعر العراقي الراحل سركون بولص في مقهى «الهور شو» في الحمراء، ثم ذهبنا الى الكاتبة الكبيرة غادة السمّان التي كانت تشاركنا الجلوس في المقهى، وقلنا لها اطلبي ما تتمنين، فقالت: أريد أن تدفنوني الآن في مقبرة بيروت. وبالفعل نهضتُ وسركون وأمسكنا بيدها وذهبنا بها الى مقبرة الباشورة، وسط بيروت، وتمدّدت غادة هناك على بلاطة في المقبرة وقالت: هذه راحتي الآن تكتمل. وكم ضحكنا بعد تلك الليلة المجنونة والجميلة».
هو عاتب كثيراً على ما آلت إليه الظروف في وطنه، لذا يتابع الشاعر حديثه بنبرة حزن واضحة ويقول: «أنا عاتب وحزين وقلق ومُتعَب، وكل هذا التعب نابع من حسرتي على وطني، لأنه لا يزال بلا مسافة. فلا مسافة حضارية قطعها أو يريد أن يقطعها ويعبرها. في وطني اليوم، لا قيمة للإنسان، لا معنى للحضارة، يضربنا التخلف من كل حدب وصوب. أين حقوق الإنسان؟ أبسط حقوقه مفقودة. وأشكر نفسي لأنني نجوت بعائلتي وأخرجتها من وطني الى بلاد تحترم الإنسان وحقوقه، بعكس ما يحصل في بلادي!».
وسرعان ما ينتقل الشاعر الى الحديث عن الموت. ففكرة الموت تتجسد بوضوح في أفكاره، وهو يتطلع الى الموت من زاوية الاعتراض على «صعوبة الحياة وتخلفها»، ويجرؤ والحسرة في قلبه، على القول بلغة دامعة وقاسية: «فكرت كثيراً في الانتحار، لكن ما منعني من ذلك، هو خوفي على ابنتي وما سيحلّ بها من صدمات ونكبات. يغريني الموت، لأنه الراحة والطمأنينة، وأنتظره بشغف».
قصيدة النثر ترفد الشاعر وديع سعادة بالكثير من الأمل في التطور الشعري، ويرتفع منسوب طموحه لبناء القصيدة المحدثة، وعن ذلك يقول: «لا نهاية للطموح الشعري، لكن قصيدة النثر ليست سهلة، وليس كل من يكتب قصيدة نثر هو شاعر».
ويتحدث الشاعر وديع سعادة عن تقلّص حضور قصيدة النثر والشعر بشكل عام في زمننا الراهن، وعن حال الثقافة فيقول: «لا شك في أن قرّاء الكتابة الورقية يقلّ عددهم يوماً بعد يوم، فالعالم يتغير ونأمل فقط أن يحافظ هذا التغيير على الثقافة، شعراً أو نثراً، سواء من خلال الكتابة الورقية أو أي وسيلة أخرى. أما الثقافة فهي أيضاً احترام الاختلاف، في الرأي والمعتقد والممارسة وما إلى ذلك. لذا، فتعدّد التيارات في أيّ مجتمع هو علامة إيجابية، شرط أن تتعامل هذه التيارات مع بعضها البعض بديموقراطية. من هنا، فإن الثقافة والحرية في المجتمع العربي وفي أيّ مجتمع آخر لا تتحققان إلا بهذه الديموقراطية».
منابع خياله الشعري غزيرة، ويتحدث عن هذه الينابيع بلغة الشعر، فيقول: «إنها تنبع من عمق الماضي والحاضر والمستقبل معاً. الشعر في حياتي هو لغتي وقولي ومساحة عيشي»... وقد كتبتُ ذات مساء: «بينما كنت تعبر أمكنة واسعة/ كان ثمة شيء يشبه الحب يتذكرك/ أما الآن وقد قطعت شوارع غير مدثرة/ وودّعت أرصفة كثيرة/ فالأمل الذي أراد التحدث إليك عند كل خطوة/ يكف عن النداء/ أنت يا من حسب أنه عبر كل الأشياء/ جلست وقتاً أطول في مقهى الماضي...».
يعترف وديع سعادة بأن مخزون الشاعر الشعري هو «مخزون العالم»، ويقول: «بقدر ما يكون الشاعر على تماس مباشر مع العالم، يستطيع بلورة قصيدته وتوجيهها... الاحتكاك بالحياة، بكل ما فيها من ويلات وجمال وحب وعذاب، أمر فعال يبلور القصيدة في أعماق الشاعر».
عن الحب
عن الحب والمرأة قائلاً: «من في قلبه وشعره محبة للإنسان، تكون في قلبه وفي شعره محبة للمرأة والرجل معاً بلا تفرقة بينهما. أنا لا أكتب للمرأة ككيان منفصل، بل أكتب للإنسان عموماً، وهذا يعني أنني أكتب للمرأة أيضاً، بعيداً عن شعر الغزل الذي بات مستهلكاً ومكرراً منذ ما قبل قيس حتى اليوم».
«الحب هو النشاط الحيوي الوحيد الذي يحرك العالم»، يقول سعادة ويضيف: «لأن مفعول الحب في الذات البشرية يحقق الأمان والطمأنينة، ويساهم في بلورة وعي الحياة. الحب مسافة عيش وحياة، يسلكها الإنسان، ويتمنّى أن تستمر، لكنها محدودة، ولها نهاية، لذلك لا بد للإنسان من أن يعي الدرب، درب الحب، يجب ألاّ يفوته ويتركه بسرعة. ولكن أيضاً أعتقد أن الأمر ليس بيد الإنسان وحده. الحب حالة قائمة على نشاط الإنسان ووعيه. الحب ليس محصوراً بين رجل وامرأة فقط، بل إنه قائم في كل شيء، في كل مكان وزمان. الحب مناخ الحياة الأجمل، لا يمكن إلا أن يكون كل الفصول الساحرة للإنسان وسائر الكائنات».
كلام كثير وأحاسيس فوّارة بثّها الشاعر وديع سعادة في حوارنا المشوق. كان يتحدث كما لو أنه يغني ويسلطن طرباً. لم يكن يريد لحوارنا أن يتوقف، لكن ليل المدينة أطبق علينا، وكان لا بد من الانصراف، فذهبنا سوياً، وديع وأنا في سيارة واحدة، ثم افترقنا، كلٌ الى بيته... وبقيت الصور في المخيلة، صور المدينة في لحظة الشعر، كأنها العالم كله هنا.
شاركالأكثر قراءة

أخبار النجوم
الجمهور يطالب سيلينا غوميز بالانفصال عن زوجها...

أخبار النجوم
سلافة معمار وابنتها في "سعادة المجنون"... شبه مذهل

إطلالات النجوم
كيت موس بإطلالة تكسر القواعد في باريس

عائلات ملكية
كيت ميدلتون تمنح الأمير ويليام إطراءً عفوياً...

إطلالات النجوم
جينيفر لوبيز تتألق بإطلالة مستوحاة من موضة...
المجلة الالكترونية
العدد 1093 | شباط 2026

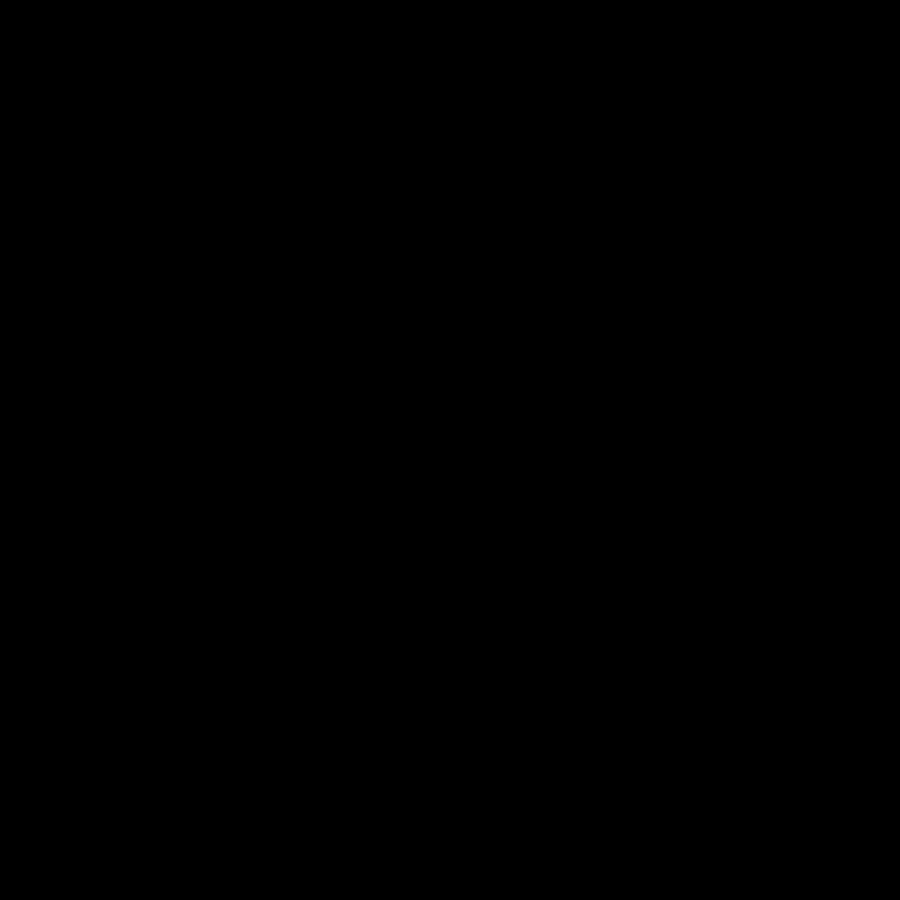
 إشترك
إشترك












