الشاعر اللبناني جودت فخر الدين: أبذل في قصائدي محاولات لتخفيف المواجهة مع الموت




جودت فخر الدين والزميل إسماعيل فقيه
قصائد صافية وهادئة جداً، كمياه تخفي في أعماقها عالماً شاسعاً ، كتبها الشاعر اللبناني جودت فخر الدين. وبلغت أعماله الشعرية عشرة كتب، قال فيها الكثير مما يجيش في ذاته ومكانه وحياته. تجربة شعرية غنية بأسئلة القلق والحب والمكان والزمان والعمر والإنسان والرؤيا، يعيشها الشاعر، ويرى من خلال كلماتها ومعانيها ودلالاتها، ما يريد أن يرى ويسمع، وكذلك ما يريد أن لا يرى ولا يسمع. هكذا هي قصيدة جودت، لغة موزونة يمكن من خلالها تحديد الشكل والمعنى والإطار والثقل، الخفيف والأثقل في تفسير الوعي الذي يتوالد مع مكنونات الوعي الباطني للإنسان. وآخر إصداراته كتاب شعر «حديقة الستين»، يمكن تلمس المعنى والقصد الذي أوحى بهما، في هذا الكتاب، من خلال هذا العنوان الذي يحاكي الزمن، أو بمعنى آخر، هو سؤال في قلق الحياة والعمر... ولمناسبة كتابه وإيحاءات العقد السادس من العمر، التقيت بالشاعر، ودار بيننا الحوار التالي:
- نبدأ من كتابك الصادر حديثاً «حديقة السّتين»، كأنك تشير بقصائده إلى الزمن، زمنك الذي عشته وعبرته، كيف عشت وعبرت زمنك هذا. هل تعيش قلق الزمن؟
«حديقة الستين» هي مجموعتي الشعرية العاشرة. صدرت هذا العام عن «دار رياض الريس للكتب والنشر». وفيها اثنتا عشرة قصيدة كتبتُها في السنوات الأربع الماضية، أي منذ دخولي مرحلة الستينات من العمر، إذْ إنني اليوم في الرابعة والستين. وهي السنُّ القانونية للتقاعد في الجامعة اللبنانية التي عملتُ أستاذاً فيها. أرأيتَ كيف أنتبه الى الزمن؟ ولعلك قد رأيت في قراءتك الديوان كيف لا أغفل عنه، وكيف أحذره، وكيف أحسُّ به في كثير من الأحيان إحساساً فاجعاً. علاقتي بالزمن هي أكثر من قلق. هي أبعد من ذلك وأعمق. إنها نوعٌ من الهاجس الوجودي الذي لا يهدأ ولا ينكفئ. لكن ديواني الجديد لا ينحصر في موضوع العلاقة بالزمن، وإنما يشتمل على صُوَر ولوحات من مختلف التجارب العاطفية والثقافية التي كانت لي في تلك العقود التي أوصلتْني إلى الستين. لكنّ المواقف التي عبّرت عنها قصائد الديوان ليست مواقف للتذكّر أو المراجعة، وإنما هي مواقف للتبصّر والكشْف والتطلّع. «حديقة الستين» هي منصّة للنظر في مختلف الاتجاهات.
- وللمكان حضور أبلغ، كأنه ضلع من ضلوع الزمان ، كيف تصف مكانك الذي عشت فيه زمانك إلى مرحلة الستين؟
ليس مكاناً واحداً، بل أمكنة كثيرة. والواحد منها ليس ثابتاً، بل هو متحولٌ أو متطوّر، وإنْ كان بين هذه الأمكنة الكثيرة واحدٌ أثيرٌ لديّ، هو ضيعتي الصغيرة في الجنوب اللبناني، التي دأبت على تأليفها منذ بداياتي، ودأبتْ كائنات الطبيعة فيها على الحضور في قصائدي، متغيّرةً بتغّيري. إذاً، تناولي هذه الكائنات ليس مجرَّد وصف، بل هو تأليفٌ جديدٌ لها. هو ابتكارٌ مستمرٌّ لهذه الكائنات من قصيدة إلى أخرى. ومثل هذا التناول ينطبق على علاقتي بالأمكنة القريبة أو البعيدة التي كتبتُ فيها، لأنها أثّرتْ فيَّ.
- غالبية الكتاب والشعراء والأدباء كتبوا عن ذلك القلق الذي أوصلهم إلى الخوف، الخوف من الموت. هل في «حديقة الستين» ملامح أشجار هرمت، أو ثمار نضجت وجب قطفها؟
في قصائدي الجديدة، كما في قصائدي التي سبقتْها، مناوشاتٌ مع الموت. محاوراتٌ تستميلهُ حيناً، وتستخفُّ به حيناً آخَر. كأني أبذلُ في قصائدي محاولاتٍ لتخفيف المواجهة مع الموت. ربما كان ذلك نوعاً من التحايل على الخوف. توجّهي حيال الموت ليس مجرَّدَ خوف. إنه أكثر من ذلك، وأشدُّ تعقيداً وغموضاً. وفيه ما يومضُ أو يوحي أو يكشف. فيه ما يُضيء الحياة ويجعلها تتجلّى فنّاً. إنه الموت، يعلّمُنا فنَّ الحياة.
- هل تغيّرت رياح الكتابة والقصيدة لديك بعد دخول العمر في مرحلة العقد السادس أو السابع؟
من يقرأ ديواني الجديد، ولديه فكرةٌ عن كتاباتي السابقة، من شأنه أن يلاحظ مظاهرَ التطوّر والتجديد. وأنا اليومَ، أشعر بأن رياح الشعر مواتية لي، على رغم أنّ الظروف التي نعيشها سيئة جدّاً... كأننا في عالم ينهار.
- الأرجح أن الكتابة الشعرية قد تطورت لديك، أو انتقلت إلى منحى أو منعطف جديد، إلى وعي جديد. كيف يتبلور هذا الوعي في قصائد الحب عند الشاعر جودت فخر الدين؟
التطور في الكتابة الشعرية لا ينحصر في عنصر من عناصر الكتابة، ولا في موضوع من موضوعاتها. التطوّر يكون في العملية الفنية بمجمل عناصرها. والموضوع الواحد لدى الشاعر من شأنه أن يمرَّ بأطوارٍ مختلفة تبعاً لأطوار الوعي التي يخوضُها الشاعر. وفي الحب، ليس من تجربة تشبهُ الأخرى. فالحب، حتى لدى الشاعر نفسه، تجربة تزداد غنىً ورحابة وعمقاً على نحو مستمرّ. وأظنّ أنّ الحبّ في قصائدي الجديدة قد نحا نحو المزيد من الرحابة والانفتاح إزاء العالم وأشيائه، إزاء الأقربين والأبعدين، إزاء الذين مضَوْا والذين سيأتون... وذلك عملاً وتيمّناً بقول ابن عربي «لقد صار قلبي قابلاً كلَّ صورةٍ ...».
- المرأة، كيف تحضر في «حديقة الستين». هل استمرت كما هي، إذا ما قارناها بحضورها في حدائق العشرين والثلاثين والأربعين والخمسين...؟
كان للمرأة دائماً حضورُها العميق في شعري. ليس لها حضورٌ فاقعٌ أو سطحيّ. حتى أن البعض واجهني سابقاً بالسؤال : لماذا قصائد الحب قليلة في شعرك؟ وذلك لأنهم لم يتبينوا ذلك الحضور العميق الذي أشرتُ إليه. المرأة التي أحبها ليست موضوعاً لي. إنها أكثر من ذلك بكثير. إنها بالنسبة إليّ كما أنا بالنسبة إليها. وكلامي على المرأة التي أحبُّها لا يختلف في شيءٍ عن كلامي على نفسي. وهذا الكلام في الحب اتخذ في ديواني الجديد منحىً استثنائياً، لأنه امتزج بكلام على المرض والخوف والفرح واكتمال التجربة... وغير ذلك. والمرأة التي كان لها الحضور الأقوى في «حديقة الستين» هي زوجتي، خصوصاً في قصيدتيْن إحداهما نثرية. أقول ذلك لأنني، كما تعرف، أكتب الشعر الموزون، أو ما يسمى في الشعر الحديث قصيدة التفعيلة. لكن الديوان الجديد احتوى قصيدتيْن نثريتيْن هما الوحيدتان اللتان كتبتهما من دون وزن. حصل ذلك بالمصادفة، أي ليس تحوّلاً في خياراتي الفنية. فأنا لا أزال أفضّل الوزن في الشعر، من دون أن أكون متعصّباً له أو ضدّه. أعود إلى قضية الحب لأقول إن المرأة في ديواني الجديد ليست مجرّد موضوع. إنها أفقٌ زاخرٌ بالوعود. شأنها في ذلك شأن اللغة التي هي بالنسبة إلى الشاعر منبع الشغف الذي لا يجفّ.
- بعد العيش والتجربة والكتابة و«الحدائق الزمنية» وصولاً إلى «حديقة الستين»، هل وصلت إلى قناعة ثابتة وراسخة لا تتبدل بتبدل الزمن. ربما عشت ندماً، وربما توغلت في الأمل، إلى أين وصلت؟
هل هنالك من شيءٍ لا يتبدّل؟ وهل هنالك من قناعاتٍ ثابتة؟ ألا ترى ما نعيشه هذه الأيام من صراعات يتداخل بعضها ببعضها الآخَر، وتتكشّفُ عن بنىً اجتماعية رثّة، قوامُها قناعاتٌ ثابتة من هنا أو هناك؟ وماذا عن التعصّب؟ الذي هو أساس العنف، والذي ينشر في بلادنا كلَّ هذا الخراب. أليس هو الادعاء بامتلاك الحقائق، أي القناعات النهائية الثابتة؟ هذا في المستوى العام أو الجماعي، فكيف هو الشأن في المستوى الخاص أو الفردي؟ خصوصاً في أيّ حقلٍ من الحقول الفنية. الحياة هي فنُّ البحث عن الحقائق، التي تراوغنا دائماً. تلوّح لنا من بعيد، فلا نتبيّنها جيداً. وذلك أنّ المعرفة البشرية ناقصةٌ ونسبية. حتى المعارف العلمية هي كذلك. ونحن البشر لا نجني في حياتنا سوى متعة البحث عن المعرفة أو الحقيقة. أنا في حالة بحثٍ دائم، وأستهدي بالكتابة، والشعر يأخذ بيدي. لقد جعلتني الكتابة الشعرية أتعرّف بنفسي وأستكشف مجاهلها. وكلما خضتُ مجدّداً في هذه الكتابة تكشّفَ لي المزيد من هذه المجاهل. الكتابة الشعرية سفرٌ بين عوالم لا حدود لها. منها ما هو داخليٌّ أو ذاتيّ، ومنها ما هو في خارج الذات، ذات الشاعر. هكذا يمكنني القول إنني أتجدّد دائماً بالشعر وكتابته. أراجع نفسي وأتغيّر، وأكوّن القناعات التي أتركها عرضةً للتغيّر. حكمتي التي أنتجتْها تجاربي أكسبتْني المرونة والانفتاح والتطلّع. وفي هذا ما يمدُّني بشجاعةٍ إضافية. ولا أندم إلا على مواقف أحجمتُ عن اتخاذها في أوقاتها المناسبة، إما لخوفٍ أو تحفّظٍ أو خجل.
- وماذا عن الشعر اليوم، أنت والشعر، كيف صارت القصيدة بشكلها ومضمونها، لونها وأجيالها، إلى أين وصلت القصيدة المحدثة، وكيف تصف قصيدتك في هذا المسار العام، وسط هذا «الحشد الشعري»؟
كم أضرّتْ بنا التصنيفات، وكم شوّهتْ من مفاهيم. وأنا أقصد هنا التصنيفات التي تجعل الشعراء في أجيال أو فئات، أو تجعلهم روّاداً أو لاحقين بالروّاد. حتى التصنيفات التي توحي بمعيار فني فتجعل الشعر عمودياً أو حديثاً، وتجعل الشعراء شعراء عمود أو شعراء تفعيلة أو شعراء نثر، ليست سوى تصنيفات اعتباطية، تطمس الفوارق بين شاعر وشاعر أو بين قصيدة وقصيدة. بدلاً من هذه التصنيفات التي لا تجدي، نحن في حاجةٍ إلى تقويم جديّ يستطيع الكشف عما هو جيّد في ركام الكميات الهائلة من الكتابات. لقد كُتب الكثير الكثير باسم الحداثة أو الشعر الحديث، لكنّ الجيّد قليل قليل بل نادر. ربما كان الأمر كذلك في كل مرحلة من مراحل الشعر. إلا أنّنا في المرحلة الحديثة لم نحْظَ بحركة نقدية فعالة. وظلّ شعرنا الحديث منذ انطلاقته حتى الآن بلا تقويمٍ يُذكر.
بالنسبة إليّ، أتقدّم في تجربتي الشعرية، وأعمل على التجريب أكثر فأكثر، لغوياً وبلاغياً وبنائياً، أو لنقُلْ إيقاعياً بعامة. لأن الإيقاع يشتمل على عناصر الوزن والبلاغة والنحْو ... وغير ذلك. ويمكنني هنا أن أتوقف عند جانب لتقنية الكتابة الشعرية عندي أشار إليه العديد ممن تناولوا بعض دواويني، ويتمثّل بطريقتي في استخدام الوزن استخداماً يجعله خفياً في القصيدة، التي تظهر للقارئ كأنها غير موزونة، وهي موزونة على نحو دقيق. هكذا تكون طريقتي هذه تقريباً بين الشعر والنثر لا يفرِّط بشعرية النصّ ولا يتوسّل التفخيم أو التهويل. كذلك بالنسبة إلى القوافي التي لا تردُ في قصائدي إلا على نحْو تلقائي، أي من دون تدبّر أو تعمّد أو افتعال. أشرْتُ إلى جانبٍ من جوانب لغتي الشعرية، التي أعمل على تطويرها في استمرار، وإنْ كانت مقوماتها الأساسية أو الجوهرية قد ظهرتْ منذ البدايات.
- أما زلت تكتب بالزّخم والدّافع نفسيهما، هل تبدّل ذاك المحرّض الذي حرّضك على كتابة الشعر؟
تتغيّر الدوافع الآنية إلى كتابة الشعر بتغيّر الظروف. وإنْ كان الدافع الأساسي دافعاً كيانياً وجودياً، يرتبط باستعداد الكاتب وشغفه وتطلعاته ورؤيته إلى العيش بأبعاده ووجوهه المختلفة. أنا الآن أشعر بأنني على أبواب مرحلةٍ جديدةٍ من حياتي في مجالاتٍ عدّة. لديّ الآن مشاريع وأفكار جديدة. حتى في مجال العمل، ستكون لي بداية جديدة. إذاً، ستكون المرحلة المقبلة مفتوحةً على الوعود المتنوّعة. وهذا كله من شأنه أن يهيئني لوعود الكتابة.
- هل قال الشاعر جودت فخر الدين كل ما يجيش في ذاته وكيانه، وإذا لم يكتمل كل القول بعد، هل تستعد للقول، كيف؟
بناءً على الإجابة السابقة، أستطيع القول إنني أعدُ نفسي بمشاريع شعرية مقبلة. والشاعر يسعى دائماً إلى أنْ يبدأ من جديد. فالكتابة الشعرية لا تحفل بالنهايات، أو بالأحرى لا تُفْضي إلى نوع من الاكتمال. الكتابة الشعرية هي التكوّن الذي لا يكتمل. هي بهجة التكوّن. وأنا كنتُ أقول دائماً إن المتعة في كتابة القصيدة تتحصّلُ لي أثناء الكتابة لا بعدَها. لكنْ، قبل كتابة القصيدة، على الشاعر أن يستعدَّ لها، عليه أنْ يُحْسِنَ استدراجها. آملُ اليومَ بأن تظلَّ وعودُ الكتابة حافزاً لي في مواجهة الحياة بمصاعبها ومباهجها.
الأكثر قراءة

مشاهير العرب
عمرو أديب يعلق على الضجة الحاصلة بشأن حياته...

إطلالات النجوم
نانسي عجرم تنسق إطلالتها قي الرياض بحقيبة صغيرة...

إطلالات النجوم
مريم أوزيرلي أنيقة بإطلالة من توقيع خالد ومروان

إطلالات النجوم
ليندسي لوهان تختار الفستان الأسود القصير في...

إطلالات المشاهير
الملكة رانيا العبدالله… عندما تلتقي العصرية...
المجلة الالكترونية
العدد 1092 | كانون الثاني 2026

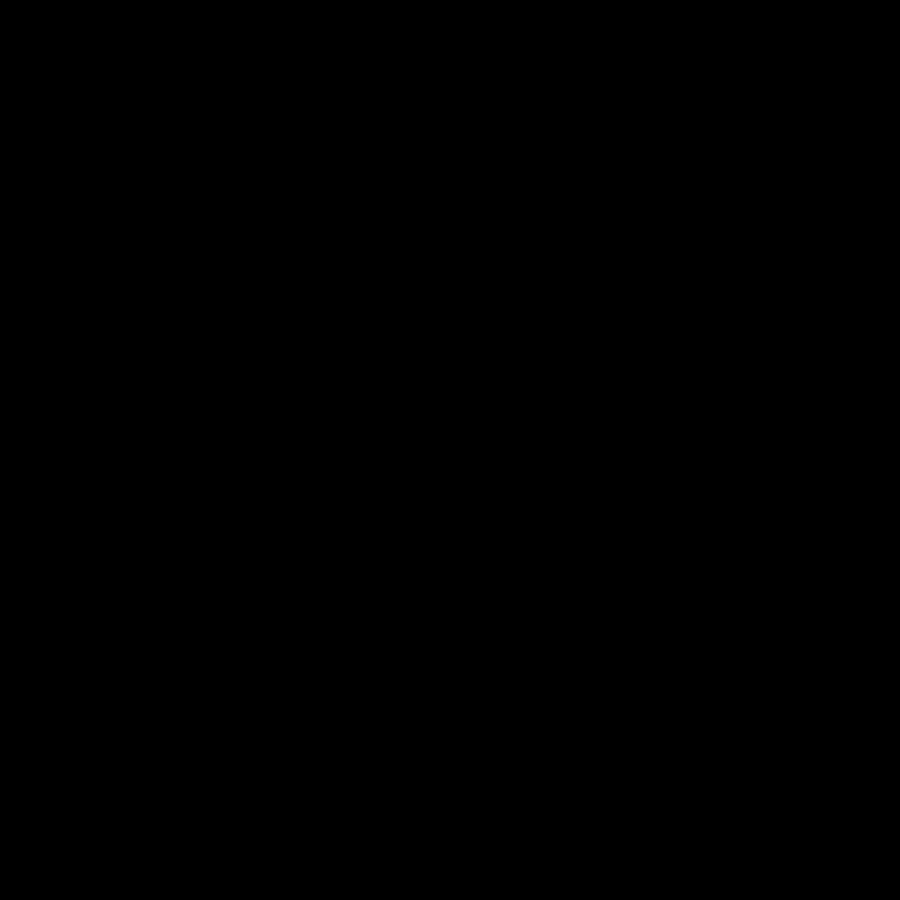
 إشترك
إشترك












