الدكتورة ميسون دخيل: أنا سعودية الإنتماء والهوية، شامية الهوى ولبنانية الفكر والثقافة



شهادة محكمة للجودة والاعتماد الأكاديمي لمؤسسات التعليم العالي في البحرين

في النادي الأدبي للسيدات تسلتلم الدكتورة ميسون دخيل جائزتها
توزع نورها لترسّخ المبادئ التربوية والتعليمية في أدمغة طالباتها، وتسعى لتكون نواة المجتمع الصلبة من خلال أبحاثها المتواصلة عن الطفولة وأهميتها في بناء المجتمعات الحديثة والسليمة في ظل وسائل التواصل الاجتماعي التي أصبحت في متناول كل شرائح المجتمع.
الدكتورة ميسون دخيل هي باحثة وعضو هيئة التدريس في جامعة جدّة، وحاصلة على دكتوراه في التربية، وكاتبة في جريدة «الوطن» السعودية، التقتها «لها» في دارتها لمناقشة أهم القضايا التربوية التي يتعرض لها الأطفال في المدارس، والتعرف الى بعض الأساليب التي تتبعها المعلمات في تعنيف الأطفال، ولتطّلع من خلالها على أشكال النت وكيف ترخي بظلالها على الأطفال والمراهقين.
- ما هي أهداف التربية الصحيحة في المدارس وتأثيرها في السلوك الإنساني؟
إعداد المواطن الصالح والقوي ليتمكن من الانخراط في المجتمع والقيام بدوره على أكمل وجه في مختلف التخصصات العلمية والمهنية والأكاديمية والاجتماعية. فبعد امتلاكه المعلومات والمهارات والقدرات، يصبح جاهزاً وجدانياً وأخلاقياً ليُكوِّن ركائز ينطلق منها الى المستقبل، سواء كان ذكراً أو أنثى. وإذا اقتصرت تلك المعلومات على الحفظ والتلقين، تُنتج شخصية مهزوزة تنطق بالشعارات فقط.
- هل المدرسة هي أحد مسببات الشخصية المهزوزة عند الأطفال؟
حين يدخل الأطفال المدرسة فإنهم يمتلكون دافعاً قوياً للتعلّم، لكن غالبية المدارس في العالم العربي تعتقل هذا الدافع، وتُخمد كل المهارات بغياب النشاطات التحفيزية والعمل على دمجها مع المواد العلمية التي تؤهلهم لربطها بالحياة وتعلّمهم الاستقلالية والاعتماد على النفس. لذا نرى الناتج العام كارهاً للمدرسة والعلم، ولا يتقن التواصل مع أقرانه، ولا حتى مع الكبار.
- ماذا ينقص المدارس لإنتاج مواطن صالح بسلوك إنساني؟
ينقصها التعليم الممزوج مع الترفيه لربط العلم بالحياة، كل حسب قدرته وسرعته، ويكون مسؤولاً عن تعلّمه، فالطفل قبل دخوله المدرسة يتعلم من اللعب كل شيء، وحين يدخل المدرسة يخنقه الدوام المدرسي إذ يجد نفسه محصوراً بين القلم والدفتر يتعلم ما يُملى عليه، فيخرج ليواجه الحياة بعيداً من التطبيق.
- من خلال زيارتك لمدارس الأطفال في اليابان، كيف وجدتِها؟
تتبع مدارس اليابان طريقة مميزة في تعليم الأطفال تعجُّ بالحياة العملية، وعلى سبيل المثال: المعلمون يقصّون صوراً من الجرائد والمجلات ويعرضونها في الساحة مع تعليقاتهم لكي يجعلوا الأطفال مرتبطين بمجتمعهم وينمّوا حس المسؤولية لديهم، مما يخلق عندهم حالة إنسانية ووجدانية رائعة، تدفعهم لتنفيذ مشاريع إبداعية من إنتاجهم الطفولي.
- من خلال طرق التدريس، هل يؤخذ في الاعتبار تدريب المعلمة على إحداث التوازن بين الشدة واللين في تعاملها مع الأطفال؟
لدينا تدريب لا تتجاوز مدته الشهر الواحد، لذا فهو غير كافٍ لتأهيل المعلمة لإحداث هذا التوازن، بينما التدريب في الدول المتقدمة يستغرق مدة أطول بحيث تأخذ المعلمة فصلاً دراسياً كاملاً بعد الماجستير، أما بعد البكالوريوس فيحتاج التدريب إلى سنة كاملة، ومن ثمَّ تعمل كمساعدة لمدة ثلاث سنوات تحصل بعدها على ترخيص لمزاولة المهنة. وقد علمت أخيراً أن وزارة التعليم ستغير قريباً برنامج التربية لتأهيل الكوادر التعليمية بما يتماشى مع المعايير العالمية.
- ما الفارق بين القطاع العام والقطاع الخاص في التطبيق المسلكي؟
المدارس الحكومية محصورة بعوامل عدة لا يمكنها تخطيها، بينما بعض المدارس الخاصة تعطي الطالبات مجالاً أوسع للتعبير عن النفس من خلال الفنون المسرحية والتشكيلية والتربية الرياضية. واليوم بعد صدور قرار إدراج التربية البدنية في مناهج التعليم العام للبنات، نأمل أن يتحقق ذلك التغيير وتتواصل مسيرة الإصلاح لتشمل باقي المتطلبات.
- صدر قرار باعتماد التربية الرياضية في المدارس الحكومية، كيف تقرئين هذا الخبر؟
أجدها خطوة متأخرة جداً، فالتربية البدنية دخلت المدارس العالمية منذ زمن بعيد. فبعض الدول المجاورة، إضافة الى الحصص الرياضية، خصصت فترة الغداء والراحة للنشاطات الرياضية مثل كرة السلة وكرة الطائرة وكرة المضرب والركض السريع...، وأنشأت فرقاً للتنافس مع المدارس الأخرى في المنطقة، ورغم ذلك تبقى خطوة عظيمة في رحلة الألف ميل، وأثمِّنها لعلّها تنقذ غالبية الطالبات من السُمنة.
- من سيتولّى وضع البرامج الرياضية؟
أتمنى أن تهتم بها خريجات كلية التربية البدنية، وأن تكون مختلفة عن البرامج المخصصة للفتيان والتي تُعتبر فاشلة لأنها تركز في مجملها على كرة القدم. نريد فتيات بأجسام صحية ورشيقة، ونهدف الى إعداد فرق رياضية تشارك في المباريات الرياضية للبنات على الصعيدين المحلي والعالمي.
- أليس من مهمّات المعلمة اكتشاف العنف الأسري الذي يتعرض له الطفل؟
أجل، ومن مهماتها الأساسية امتلاك الحس بالمسؤولية، ومبادئ أخلاقية تسعى لتحقيقها، وحين اكتشافها تلك الحالات، يتوجب عليها ومن خلال الخط الساخن تبليغ مراكز حماية الأطفال من العنف الأسري، والتي تضم عدداً من المختصين النفسيين والاجتماعيين والأطباء. وتلك المراكز سعت إليها الدكتورة مها المنيف المستشارة الإقليمية في الشرق الأوسط لمنظمة الصحة العالمية في الوقاية من العنف والإصابات، وحصدت جائزة أشجع امرأة في العالم.
- ما هي المشاكل التي تتعرض لها الطفلة في المدرسة، وكيف يتم علاجها؟
«التنَمُّر» من جانب الأقران، فحين تكون الطفلة مغرورة بجمالها تبدأ بـ «التَّنمر» على إحدى زميلاتها من خلال التعصب للقبيلة والعائلة، والإساءة اللفظية إلى شكلها ومظهرها، واستبعادها عن شلّتها. وحين تمتلك المعلمة سرعة البديهة، تقوم بتغيير أماكن الطالبات كل شهر مرة، أو تضع كل طالبتيْن في مواجهة بعضهما البعض على أن تصف كل واحدة زميلتها بالأوصاف الإيجابية الجميلة وهكذا دواليك...
- من المسؤول عن عملية «التنمُّر» لدى الجنسين؟
الأسرة التي سَهَتْ عن تربية أبنائها على المبادئ والأخلاق، والمدرسة التي أخفقت في المتابعة الحثيثة لاكتشاف تلك الحالات كي تساعد «المُتَنَمّر» أولاً لكونه مريضاً نفسياً، والضحية ثانياً لأنه مورس عليه «التنمُّر»، وإن لم تُحلّ القضية، يخرج الطلاب مدمَّرين نفسياً من المرحلة الابتدائية ليواجهوا قدرهم الأعنف من التنمُّر في المرحلتين الإعدادية والثانوية، لذا يجب أن تتدارك المدرسة خطورة الأمر.
وعلى سبيل المثال لا الحصر، في إحدى الدول الغربية، استهزأ أحد الطلاب في المرحلة الابتدائية بطالب أصلع نظراً لإصابته بمرض السرطان، وحين علمت أم المتنمّر بذلك، عاقبت ابنها بحلق شعره.
- وسائل التواصل الاجتماعي أصبحت في متناول الأطفال، لكن ماذا عن تأثيرها السلبي فيهم؟
كأعضاء هيئة تدريس وإداريين في المؤسسات التعليمية، نتحمل مسؤولية كبيرة إلى جانب المهمات الأكاديمية، فنحن مسؤولون عن الصحة النفسية للطلبة والطالبات، ومن واجبنا أن نلاحظ أي تغيير في سلوكهم، كالتراجع في المستوى التعليمي، أو الانطواء، أو الغياب المستمر، أو مظاهر الاكتئاب التي تتحكم بهم... كما نتابع نظراتهم، بل نقرأها بكل شفافية لعلنا نخترق هذا الجدار الذي ظهر فجأة في حياتهم، ونؤكد لهم أن حياتهم تهمّنا، وأننا حاضرون في أي وقت لمساعدتهم، وأن لا شيء «يصدمنا».
- كلمة «يصدمنا» هل تعني لهم شيئاً؟
كلمة «يصدمنا» هنا حيوية، تصل إليهم، وتعني أننا لن نحاسبهم، بل سنسعى معاً لحل أي مشكلة وجدوا أنفسهم سجناء لها. مهمتنا لا محدودة، وهي لا تنتهي داخل قاعة المحاضرات أو في الصفوف الدراسية.
- هل تتفاعلين مع الطالبات وتمدّين لهن يد العون؟
هاتفي مفتوح لكل طالبة من طالباتي، ودائماً مستعدة لحل أي مشكلة يتعرضن لها، وبمجرد النظر في عيون طالباتي أشعر بمعاناتهن وأقوم بواجبي على أكمل وجه. وعلى سبيل المثال لا الحصر، تحركتُ حين لمحت نظرة الحزن في عيني إحدى طالباتي، وعلامات الانكسار على ملامحها، فوضعت يدي على كتفها وردّدت فقط عبارة «أنا موجودة إن احتجتني»، وأكملت المحاضرة. بعدها لجأتْ الطالبة إليَّ وعلمت أنها تعرضت لابتزاز ذكوري من طريق إحدى وسائل التواصل الاجتماعي، فما كان مني إلا التواصل مع الجهات المختصة للوصول إليه ومعاقبته وإيقافه عند حدوده.
- كتبتِ مقالاً تحت عنوان «قضية اختراق»، وأبرز ما جاء فيه: «خانني التعبير وعاندتني الأبجدية! بعد رحلة بحث كرهت كل خطوة فيها! كنت كمن دخل غابة من الأشواك». ما نوع تلك الغابة وما نهاية طريقها؟
بما أن الأطفال لا يعرفون «الأمن المعلوماتي» ولا يدركون أهميته، فهم يتبارون دائماً بوضع صورهم على وسائل التواصل الاجتماعي ويتحدثون عن حياتهم الخاصة وتحركاتهم اليومية، مما يؤدي إلى صيدهم على النت من جانب الذين يعانون مرض الـ «بيدوفيليا»، والذين يتحرشون بالأطفال بعد أن يعرفوا كل شيء عنهم، فيبدأ المريض بنشر الصور الإباحية والألعاب للطفل ويتحسس نبضه، فإن استجاب وقع في الفخ، فيستدرجه، وإذا كانا يقيمان في المدينة نفسها يغريه بالهدايا، حتى يخرج الطفل بلمح البصر من بيته، ويدخل في غياهب تلك الغابة القاتلة.
فهناك حالات اغتصاب وتحرش جنسي لأطفال ليس عندنا فقط، بل حول العالم. في بعض الحالات يتم القبض على الجاني، وأحياناً يتلاشى الخبر في خضم الأخبار المروّعة التي تتواتر على شكل «عاجل» وتحمل في طياتها مزيداً من الموت والدمار لأطفال هم بُناة المستقبل!
- هذا ما دفعك للبحث في هذه القضية المخيفة والكتابة عنها؟
هناك موت ودمار يتسللان إلى بيوتنا، مدارسنا، مساجدنا، ملاعبنا، أسواقنا وملاهينا! حين نتجاهل العالم الافتراضي الذي يعجُّ بالشياطين الذين ينهشون في براءة الأطفال ويغتالون مستقبلهم، نكون كمن يدفن رأسه في الرمال لئلا يُرى. إنهم مروّجو المواد الإباحية عن الأطفال، وكل من ينسخها وينقلها وينشرها ويتابعها، مثل «غوغل»، حيث تختفي تحت جنح الظلام في عالم يغلب عليه طابع الإجرام والهمجية!
- ما هي النتّ العميقة؟
هي التي تظهر من خلال برامج معينة مفتوحة. وإذا وصلت تلك البرامج إلى أيدي المراهقين، وقعوا في المحظور واسْتُدرجوا من جانب هؤلاء الشاذّين من خلال هذه المواقع لنشر همجيتهم حول العالم، فيبتزونهم من خلال المقاطع التي يشاركون فيها لكي يدخلوا في دائرتهم السادية، أو يجبرونهم على نشرها في المواقع، إما لقاء مبالغ مالية أو من أجل جذب الزبائن لبيع منتجات سوداء للساديين ومثليي الجنس! وقد أثبتت الدراسات أن من يتابع هذه المقاطع عادة ما يتجه إلى الاعتداء الجنسي على الأطفال!
- ألهذا السبب أُقيم الملتقى الوطني للوقاية من الاستغلال الجنسي للأطفال عبر الانترنت في الرياض؟
الأمر خطير ويجب أن نتعرف على طرق المساعدة لكي نحمي أطفالنا. فإن وجدنا من يحمّل مثل تلك المقاطع، علينا أن نبلّغ الجهات المختصة فوراً، حتى تصل إلى باقي الشبكة ومن ثمَّ إلى المصدر. من لا يرحم الطفولة يجب ألاّ يُرحم!
- هل ساهمتِ في توعية المجتمع؟
أطلقت حملة توعية في جامعتي وبعض المدارس والنوادي الأدبية والنسائية الثقافية في جدّة، وقد دعتني الدكتورة سعاد جابر الى عقد جلسات نسائية في منزلها حيث جمعت حوالى 30 أمّاً لتوعيتهن بخطورة النتّ، كما ألقيت محاضرة في مدارس اليسر للمرحلة المتوسطة مع المعلّمات.
- هل وصلت الى أكبر شريحة في المجتمع؟
أتمنى ذلك، لكنني لا أستطيع تغطية شرائح المجتمع لوحدي.
- ما أهم شيء نزرعه في نفوس الأطفال؟
البناء الأخلاقي، والتنبيه إلى كل خطر قد يعترض حياتهم، ويشعرون به، من دون خوف أو وجل أو تعنيف، ولا أسرار في هذا الموضوع، مع ضرورة التلقي منهم بهدوء حتى لا يكتموا الأسرار خوفاً، سواء في المدرسة أو البيت، فربما يكون المتحرش واحداً من أفراد الأسرة!
- من بيروت إلى السعودية إلى أميركا، كيف تصفين تلك التجربة؟
بيروت منحتني علماً جميلاً وراقياً، وعلّمتني تقبّل الآخر وكيفية التعامل معه، وكانت مرحلة السعودية صعبة حين تركت جزءاً من عمري وبدأت مرحلة جديدة لا تتعدى الشهور، لكنها أضافت إليّ الكثير من الخبرات، ومن ثمَّ إلى أميركا حيث كانت المرحلة الأصعب إذ تابعت المرحلة الثانوية واستطعت أن أجتاز سنتين بسنة، وتحديّتُ نفسي حيث كنت حينها زوجة وأصغر خريجة.
- كيف تصفين هذا التحدي؟
انخرطت في المجتمع الأميركي بقوة لأنني متسلحة بعلم أساسي قوي، وقدرة على التكيف مع أي جديد. كسبت صداقتهم كما كسبت احترامهم، وقدمت تقارير صحافية مصوّرة عن المجتمع الأميركي كنشاط مدرسي نال إعجاب الجميع، وفي كل مرة كان يطلب مني أن أكون عضواً في فريق المناظرة خلال الأنشطة التعليمية، كنت أقدم عرضاً مبهراً.
- لماذا هذا التنوع في اللهجة؟
لأنني سعودية الأصل والانتماء والهوية، شامية الهوى (نسبة الى والدتي)، لبنانية الفكر والثقافة... هذا التنوع الحياتي الجميل هو الذي أعدّني لمواجهة تحديات المستقبل.
- ما الرسالة التي توجهينها الى الأمهات؟
الأمومة ليست مهنة، بل فطرة وقدرات ومهارات يجب تطويرها بالعلم والمعرفة لحماية أطفالكن من الخطر في عصر الثورة المعلوماتية.
- من يقف وراء هذا النجاح؟
أم عظيمة حققت حلم والدي رحمه الله بتحصيل العلم في لبنان، وزوج متفهم ورائع وقف إلى جانبي لإتمام تعليمي حتى نلت الدكتوراه.
- وماذا تقولين لكل معلّمة من المعلّمات؟
التعليم مسؤولية، الناتج مردود عليك، تواصلي مع إنسانيتك.
- ماذا منحك التعلّم في لبنان؟
التعلّم في لبنان صقل شخصيتي وقدمّني الى مجتمع مختلف لغةً وإرثاً ثقافياً. حين أقمت مناظرة مع الآخر دفاعاً عن قضية يعارضها هو، ربحت المناظرة حيث وجدوا سلاحي العلمي قوياً وغنياً بمعلومات مزروعة في ذاكرتي، فأكدت لهم أننا شعب حضاري ولسنا همجاً، بل نجيد رسم أهدافنا المستقبلية.
الأكثر قراءة

إطلالات النجوم
كريستينا أغيليرا تتألق بمجوهرات شوبارد الماسية...

إطلالات النجوم
ديمة قندلفت تتألق في أسبوع باريس للأزياء...

إطلالات النجوم
نانسي عجرم تحيّر الجمهور بإطلالتها.. عصرية أم...

إطلالات النجوم
سيرين عبد النور تتألق في العراق بفستان مجسم...

أخبار النجوم
مطالبات بطرد محمود السراج من مصر بعد تصريحات...
المجلة الالكترونية
العدد 1092 | كانون الثاني 2026


شؤون المرأة
مراسلة حربية وطبيبة وممرضة.. أمهات يتحدّين ظروف أعمالهن الصعبة من أجل أطفالهن

شؤون المرأة
مؤثّرات جمال عربيات تساهمن في ابتكار اتجاهات جديدة للموضة والمكياج

شؤون المرأة
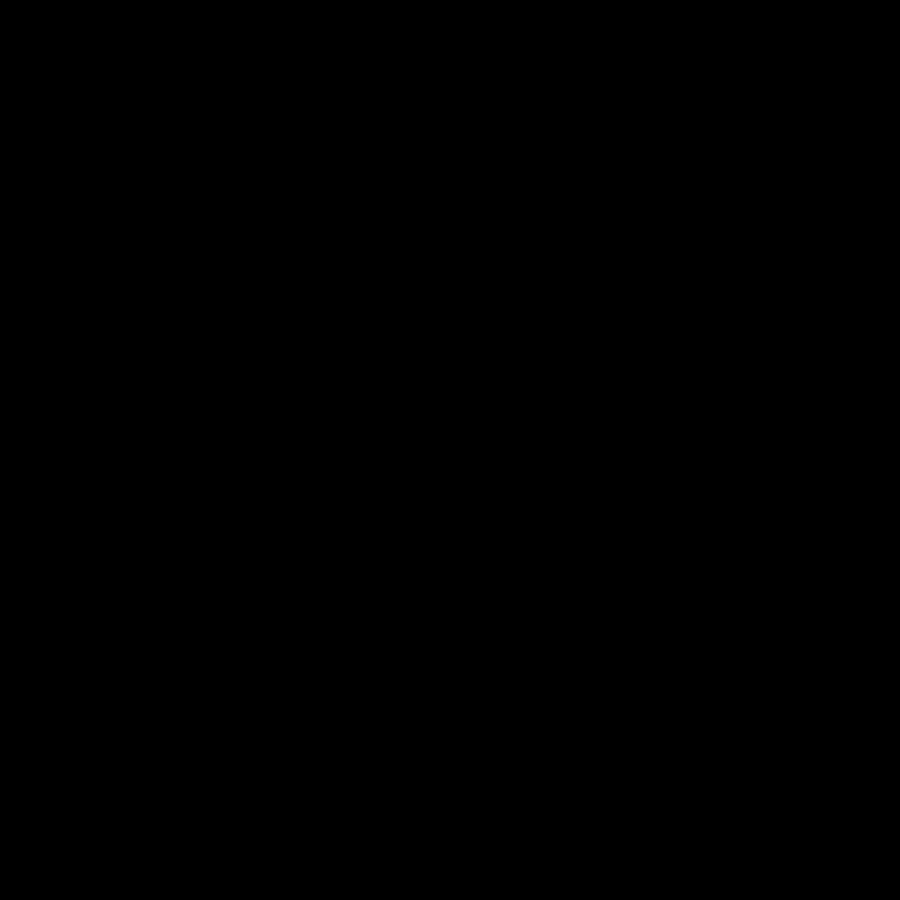
 إشترك
إشترك









