ماساي مارا استوديو طبيعي...




















ماساي مارا. ماذا يمكن أن ينتظرني هناك؟ هل ستكون رائعة أخرى من روائع كينيا؟ عند الصباح تركنا فيرمونت سفاري كلوب متوجهين نحو مطار نانيوكي الداخلي للتحليق نحو جنوب- غرب كينيا حيث تنبسط ماساي مارا. فاجأني مبنى المطار إذ كان عبارة عن مقهى مشيّد من الخشب وسقفه من القصب يقابله مدرج صغير حطت فيه طائرة صغيرة تتسع لحوالى عشرة ركاّب. شعرت بأنني فعلاً بدأت أدخل عالم كينيا البسيط وبأن مغامرة مختلفة تنتظرني.
صعدنا إلى الطائرة وترك لنا ربانها حرية اختيار المقعد، فاخترت المقعد الموجود مباشرة خلف مقعده. بدا الطيار ومساعده واثقين من خبرتهما ومعتادين على التحليق في الأجواء الكينية، وكأن الطيران صار غريزة أو فعلاً فطريًا يقومان به تلقائيًا. حلّقنا فوق الريف الكيني، وكانت السحب البيضاء تتلاعب بالطائرة فتدخلنا أحيانًا في جوفها الأبيض لتعود وتكشف لنا عن مشاهد عز نظيرها في العالم. كل شيء كان رائعًا وكانت عيناي ترصدان حركة الرادار من خلال لوحة المعلومات الموجودة أمام ربان الطائرة، وفجأة دخلت الطائرة نفقًا من الغيم ولم أعد أرى سوى الأبيض رصدت لوحة الرادار ووجهي الطيارين، فإذ بي أقرأ Message Failed.
. لخمس دقائق حبست أنفاسي خصوصًا أن الطيارين نظرا إلى بعضهما بابتسامة ساخرة، رحت أحللها: هل ضلا طريقهما! هل سيحدث لنا كما حدث في مسلسلLost ! خمس دقائق شعرت بأنها دهر ولم أجرؤ على إعلام أحد من زملاء الرحلة، بل اكتفيت بالتحديق إلى لوحة الرادار إلى أن انفرجت أنفاسي عندما بعث الطيار رسالة ثانية وظهر على الشاشة Message sent. هبطت الطائرة في أحد المطارات الداخلية وصعد زوجان برفقة طفليهما. جلس الولد على المقعد المحاذي لمقعدي وبدا عليه الخوف، تبادلت وإياه أطراف الحديث وأخبرني كل تفاصيل رحلته إلى كينيا وبأنه من أوستراليا وتحديدًا من ملبورن، ولكي أبدد خوفه من المطبات الهوائية علّمته أن ينشد أغنية My dream is to fly بصوت عالٍ كلما تلاعب الهواء بالطائرة، فسألني إذا ما كنت متوجّهة إلى نيروبي وبدا عليه الحزن عندما قلت له إنني سأنزل في ماساي مارا، ربما أراد من يسليه في رحلته فالأطفال يعرفون مصلحتهم!
عندما حطت الطائرة في مدرج ماساي مارا لم أخف دهشتي، فهو أرض بعل. أما صالة الانتظار فهي كوخ صغير من القش موجود وسط الأدغال... قلت في نفسي المغامرة الحقيقية بدأت. فأنا لست وسط استوديو صنيعة متخيل هوليوودي، بل وسط عالم حقيقي لم تهندسه عبقرية إنسان ربما لأنها تعجز عن محاكاته. كان في انتظارنا سائق من منتجع مارا إنتربيدز Mara Intrepids الذي يبعد عن المطار خمس دقائق.
اخترقنا بوابة كبيرة يقف عندها حارس، وكان المنتجع مسوّرًا بالأسلاك، أما بهو الاستقبال فكان عبارة عن كوخ كبير مقسم إلى أجنحة عدة من الخشب.
هنا كل شيء يحاكي الطبيعة والغابة التي رمينا في وسطها، أما غرف المنتجع فهي خيام ولكنها الأكثر ترفًا وفخامة، رغم أن لا أبواب لها توصد بل قماش يسد بسحّاب يفصل بينك وبين الخارج . لم أخف سعادتي عن زملاء الرحلة بأني استعدت سنوات طفولتي ومراهقتي حين كنت في الكشافة وأذهب في مخيم كشفي فعلّق محمد:"المخيم الكشفي في ربوع جبال لبنان يا ابنتي مختلف، فهناك لا حيوانات مفترسة" فقلت:" الأمر سيان، فضلا عن أن الحيوانات المفترسة هنا لن تلتهمك فلديها ما يكفي من الطعام".
بعد استطلاع الخيام التي سنبيت فيها تناولنا الغداء. ورغم أن المطعم في الهواء الطلق فالتدخين ممنوع وهناك مناطق محددة لذلك.
بعد الظهر كنا على موعد مع السفاري. ركبنا سيارة رباعية الدفع انطلقت بنا في رحاب الغابة وبدأت قطعان الحمار الوحشي والغزلان والزرافات تظهر أمامنا، وبدا لي أنها غير مكترثة لوجودنا فربما اعتادت أصوات المحرّكات إذ لم نكن وحدنا من يرصدها بل هناك الكثير من هواة السفاري من كل أنحاء العالم.
واللافت أن سائقي السيارات يخبرون بعضهم عبر اللاسلكي عن مكان وجود قطعان الحيوان فتجد السائق يذهب إلى المنطقة التي أشار إليها زميله. فقد توقفنا عند شجرة محددة حيث كان يوجد ثلاثة من نمور التشيتا تستريح غير آبهة بوجودنا. التقطنا الصور غير آبهين نحن أيضًا، ثم أكملنا سيرنا. وفجأة توقف السائق وترجّل من السيارة. وتبيّن أنه أراد التقاط كيس من النايلون مرمي وسط الغابة، فقلت له هل يستحق أن تعرض حياتك للخطر؟ فرد لا خطر هنا عليّ بل على الحيوانات، ماذا لو ابتعله حمار وحشي؟ سوف يختنق ويموت. بالفعل قلت في نفسي إن السكان هنا مدركين لضرورة حماية بيئتهم الطبيعية، فيفيد لم يكن مضطرًا للقيام بذلك، إذ ليس هناك من يراقبه.
بعد ذلك توقفنا تحت شجرة حيث كان غزال معلقًا على غصن، وفي مقابل الشجرة يستريح شيتا مستلقيًا على ظهره قرب جدول صغير، فأخبرنا ديفيد أنه يستريح بعد الصيد ويبدو أنه ليس جائعًا، فعلّق فريسته على الشجرة كي لا يأخذها منه أحد. انتظرنا التشيتا ليقوم ويتبختر أمامنا، لكن عبثًا فقد كان يأخذ قيلولته بسلام. أكملنا الرحلة وإذ بقطيع الزرافات يظهر أمامنا وها هي تتبختر واثقة الخطى تمشي ملكة، غير آبهة لأحد. وفجأة لاحظنا قطيعًا من الغزلان يركض فعرفنا عندها أن هناك لبوة تستعد للصيد.
أخيرًا ظهرت أمامنا زوجة ملك الغابة تتبختر أمامي من دون أن تكترث لوجودي رغم أنه لا يفصلني عنها شيء، ولكن كان في رأسها هدف محدد للصيد، فالغزال الذي كان يراقبها من بعيد أرشدنا إلى طريقها وبالطبع هي أيضًا إلى أن وصلت إلى حرج واختبأت فيه حيث كان قطيع من الآيائل يرعى العشب. انتظرت اللبوة ونحن انتظرنا معها حوالى الساعة لحظة الصيد المناسبة لنخلدها بعدسات كاميراتنا، عرفت خلالها كم صبر أصحاب البرامج والقنوات التلفزيونية المتخصصة بعالم الحيوان طويلاً. بدأت اللبوة تتحرك عندما اقترب منها قطيع الآيائل ولكن محاولتها باءت بالفشل، وعادت تجر ذيول الخيبة، والمفارقة إنها لم تبالِ لتعليقاتنا الساخرة، بل أكملت سيرها بهدوء. والطريف أننا نحن من نلحق بها وليست هي من تلاحقنا، تتبعناها، لأنها وبحسب خبرة المرشد سوف تذهب إلى أشبالها الصغار مما يعني أن الأسد أيضًا قريب من المكان. بالفعل توجهت إلى حرج وضعت فيه أشبالها. وما هي لحظات حتى ظهر ملك الغابة يعرض عضلاته المفتولة، وهي لم تقترب منه لأنها كانت ربما خائفة من لومه لها لفشلها في الصيد. المشهد كان مسرحيًا بامتياز وكل يؤدي دوره بإتقان. تركنا الأسد واللبوة يتدبران أمر خيبتهما، وعدنا أدراجنا إلى المخيم فيما بدا ضوء الشمس منكسرًا حين اخترق السحب المتراكمة مضيفًا إلى المساحات الرحبة مشهدًا مهيبًا.
أسدل الليل ستارته المرصّعة بالنجوم ، واللافت أن معظم من التقيتهم إما اسمهم ديفيد أو فرانسيس! مفارقة غريبة، فأثناء تناولنا العشاء دعانا ديفيد للتجسس على كوكب المريخ عبر التليسكوب فلم أجد فارقًا كبيرًا بين ما رأيته عبر التليسكوب وعيني المجرّدتين، فقد كان واضحًا إلى درجة أنني شعرت للحظة بأن في استطاعتي لمسه، فالبصر يخدع أحيانًا.
غططت في نوم عميق، ورغم أنني أنام في خيمة تنقطع فيها الكهرباء عند الثانية عشرة لأنها تُغذى من المولّد الخاص، لم أشعر بالخوف بل كنت متشوقة لقدوم الصباح للذهاب إلى قرية ماساي الموجودة في المحمية.
استيقظت صباحًا بكامل نشاطي متأهبة للتعرّف إلى الحياة الأصيلة لقبلية الماساي التي تعيش ضمن المحمية. ركبنا السيارة متوجهين نحو قرية الماساي برفقة مرشد سياحي من أهل القرية نفسها ويتقن الإنكليزية. وصلنا إلى مشارف القرية، لم أخف دهشتي لأنني كنت أتوقع قرية فيها كثافة سكانية فيما كانت مؤلفة من حوالي 40 منزلاً أقرب إلى الأكواخ وعدد سكانها لا يتعدى المئة ينتمون إلى سبع عائلات. الدخول إليها يكون من البوابة الرئيسة غير الموجودة أصلاً وإنما يغلق هذا المدخل ليلاً بأغصان الأشجار اليابسة بعد أن توضع الأبقار في الوسط، وتتحلق البيوت بشكل دائري. يرتكز سكان هذه القرية في معيشتهم على الزراعة وتربية الأبقار، أي لا يزالون في الطور الأوّل من مراحل التكوّن الحضاري كما وصفه ابن خلدون.
أما أسلوب عيشهم الاجتماعي فيعتمد على تعدد الزوجات الذي قد يصل إلى سبع زوجات، بحسب عدد الأبقار التي يملكها الزوج العريس. واللافت أن الزوجة العروس هي التي تبني المنزل ويكون من الطين وأغصان الشجر اليابسة، وهي من ترعي الأبقار وتتولّى الاهتمام بأطفالها، تمامًا كما تعيش بقية الكائنات في المحمية، فهذا أثر الطبيعة في سلوكهم الإنساني. واللافت جدًا هو وجود مدرسة حجم مبانيها أكبر من القرية نفسها، وأطفال القرية يذهبون إليها يوميًا ويتقنون اللغتين الإنكليزية والسواحلية، فالتعليم الابتدائي إلزامي في كينيا... أعجبني التزام أهل القرية بالقانون رغم أنه ليس هناك شرطي يجبرهم على تطبيقه. فهذه القبيلة تحترم قوانين الطبيعة وقوانين الإنسان بشكل فطري، معادلة فريدة من نوعها. اصطف مجموعة من شبان الماساي بلباس الشوكاس الأحمر تزين أعناقهم وآذانهم وأيديهم الحلي الأفريقية رحبوا بنا برقصة التحدي المرتكزة على قفز الرجال في الهواء شرط أن تبقى الرجلان متلاصقتين ويفوز من قام بالقفز الأعلى. بعد انتهاء رقصة الترحاب التي قدّمتها نسوة القرية، دخلت بيتًا لا تتعدى مساحته 20 مترًا مربعًا رغم المساحة الشاسعة للأرض. قلت في نفسي ربما رحابة المكان تشعرهم بضرورة المبيت في مكان ضيق يحميهم، أو ربما الزوجة لا تتحمل أعباء بناء منزل كبير يأخذ وقتًا طويلاً قد يستمر لسنوات، وبالتالي يغير العريس رأيه.
لفتني في هذا الكوخ الصغير وجود غرفة خاصة للقيام بالواجبات المدرسية، مما يشير إلى أن فطرة هذه العائلة أهدتهم إلى الطريق التربوي السليم من دون استشارة اختصاصي.
بعد زيارة البيت توجهنا إلى سوق القرية وهو عبارة عن كوخ دائري كبير يقع عند الطرف المقابل للمدخل، مسقوف بالقش وتتوزع على المنصات الموجودة فيه ما ابتدعته أيدي نسوة القرية من حلي أفريقية مشغولة يدويًا من الخرز بأشكال رائعة.
بعد ظهر اليوم التالي عدنا إلى مغامرة سفاري ثانية، ولكن هذه المرّة لم نضطر لانتظار ظهور قطعان الفيلة والغزلان ووحيد القرن والأسود، بل كنا نلتقيها طوال مسارنا والسبب أن الأمطار التي هطلت ليلاً جعلت المناخ لطيفًا وبالتالي ربما خرجت تحتفل بالمطر. دارت السيارة بسرعة للحاق بقطيع الثيران الوحشية الذي سيعبر نهر مارا إلى الضفة المقابلة نحو تنزانيا، لكن استوقفتنا عائلة من الفيلة نصحنا المرشد بعدم التحدّث بصوت عال لأن صدى صوتنا يتلقاه الفيل كما لو أنه دوي انفجار، وبالتالي تثور ثائرته ويطيح كل ما يراه أمامه. تقيدنا بهذه النصيحة واكتفينا بالنظر إلى هذه العائلة التي بدت متكافلة لا أحد يخرج عن سربه والأم تنتظر كل أبنائها وتطمئن إلى أنهم لم يضلّوا طريقهم. تابعنا المسير إلى أن وصلنا إلى نهر مارا وكان للأسف قطيع الثيران الوحشية قد عبر النهر تاركًا خلفه سحبًا من التراب المتطاير في الفراغ. ترجلنا من السيارة ورحنا نتأملها وهي تعدو على الضفة المقابلة كأنها في سباق مع الزمن.
غير أن التماسيح كانت مستلقية بكل دهاء تنتظر من يقع فريسة فكيها. التقطنا الصور للنهر الهادئ وعدنا أدراجنا إلى المنتجع.
في يومي الأخير في ماساي مارا، استيقظت عند الخامسة صباحاً فقد كان في انتظاري نوع مختلف من السفاري وهو سفاري المنطاد. بالفعل الطبيعة هنا تغير وجوهها مع تواتر الليل والنهار. فشروق الشمس يبدأ خجولاً يغنّج سكان المحمية ليوقظهم بهدوء فهنا لا حياة عصرية يلهثون وراء تلبية متطلباتها، وكل شيء يسير بحسب نمط الأرض، وحدها الطيور أول من يستيقظ، ويليها ربما حيوان نام جائعًا يبحث عن فريسة تسد جوعه. توقفت السيارة عند فندق Mada Hotel وكانت هندسته تعكس النمط الإفريقي بكل تفاصيله بشكل مترف. دوّنت اسمي وكلي حماسة لركوب المنطاد. صحيح أنني اعتدت التحليق في الفضاء الرحب وإنما ركوب الطائرة لا يشعرك بمتعة التحليق الحقيقية التي يحوزها الطير. صعدت في السلة التي تتسع لتسعة ركاب وبدأ المنطاد يعلو رويدًا، شعور يعجز اللسان عن وصفه أنا أحلّق من دون ربط حزام وحواجز معدنية ونوافذ أحدّق من خلالها، بل أطير حرة معلّقة بين الأرض والسماء، أراقب انبلاج ضوء النهار الذي يتدرج في تغيّر ألوان السماء من الأسود مرورًا بالرمادي والأرجواني وصولاً إلى الأزرق المشع، ووجدتني أردد بهمس أغنية I believe I can fly.
ولكن لم أستطعْ أن ألمس السماء كما تقول باقي كلمات الأغنية فهي حلم, كان المنطاد يرتفع وينخفض بهدوء فوق المحمية والقطعان على أنواعها بدت نشيطة تستعد ليوم طويل فيه الكثير. حلّق المنطاد فوق نهر مارا الذي بدا لي ينساب بين أروقة الطبيعة الرحبة بسخاء. هبط المنطاد عند ضفته وعدنا وركبنا سيارة رباعية الدفع لنصل إلى موقع تناول الفطور. ذكرني هذا المشهد بعشائي في الغابة في ماونت كينيا إنما هنا كل شيء كان مكشوفًا وواضحًا واستغنيت عن معظم حواسي المنبهة لاستمتع بلحظة فريدة قد لا تتكرر.
خصوصًا أن رسم ركوب المنطاد كلفته عالية جدًا، ولكن هذه التجربة جعلتني أفكر جديًا بتعلم هبوط المظلّة. عدت أدراجي إلى المخيم وكنت قد حزمت حقيبتي الليلة الماضية. حاولت أن أخزن كل ما تبصره عيناي في ذاكرتي لأتمكن من استحضار هذه الصور ساعة أشاء.
تركت ماساي مارا محلّقة في الطائرة الصغيرة نحو جزيرة لامو، حاملة هذه المرّة معي صورًا تسكنها طبيعة رحبة تتخطى كل الأبعاد البصرية. صحيح أن السفر إلى مدن تضج بالتاريخ والبذخ الإنسانيين يجعلني مترفة الفكر، لكن التجوال في جغرافيا الطبيعة العذراء منحني بذخًا روحيًا جعلني أحلّق في فضاء العالم الكيني المليء بالألغاز التي لا تنتهي.
الأكثر قراءة

أخبار النجوم
الجمهور يطالب سيلينا غوميز بالانفصال عن زوجها...

إطلالات النجوم
كيت موس بإطلالة تكسر القواعد في باريس

أخبار النجوم
سلافة معمار وابنتها في "سعادة المجنون"... شبه مذهل

عائلات ملكية
كيت ميدلتون تمنح الأمير ويليام إطراءً عفوياً...

إطلالات النجوم
جينيفر لوبيز تتألق بإطلالة مستوحاة من موضة...
المجلة الالكترونية
العدد 1093 | شباط 2026

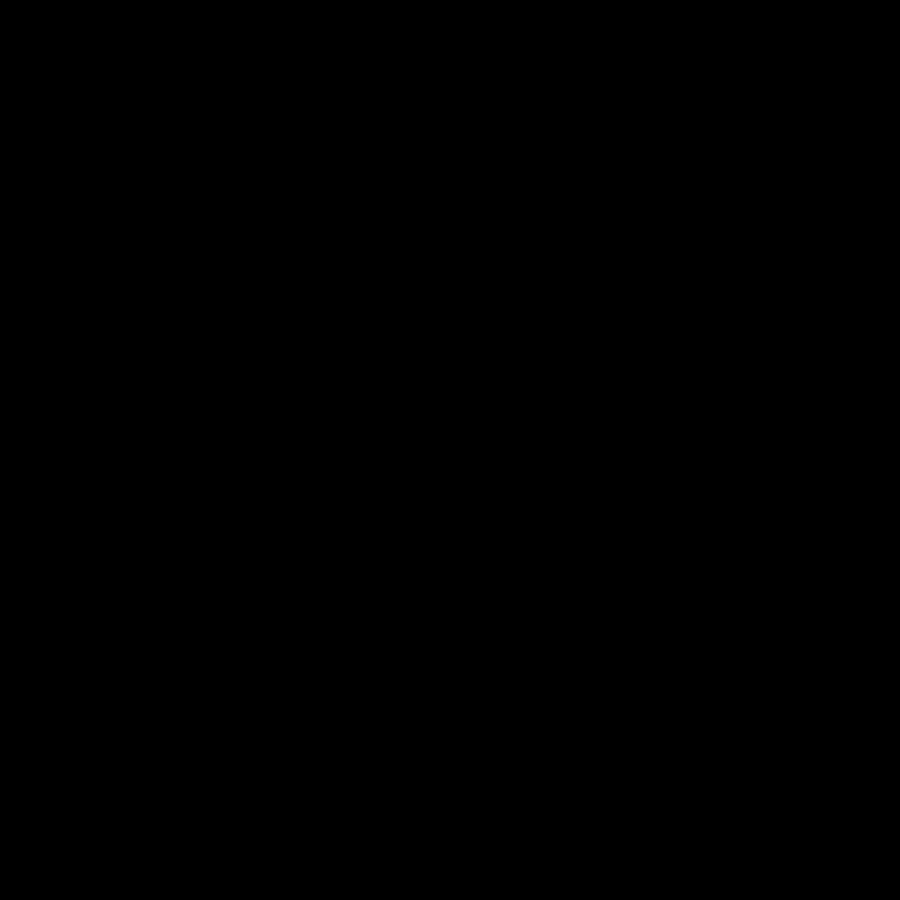
 إشترك
إشترك












