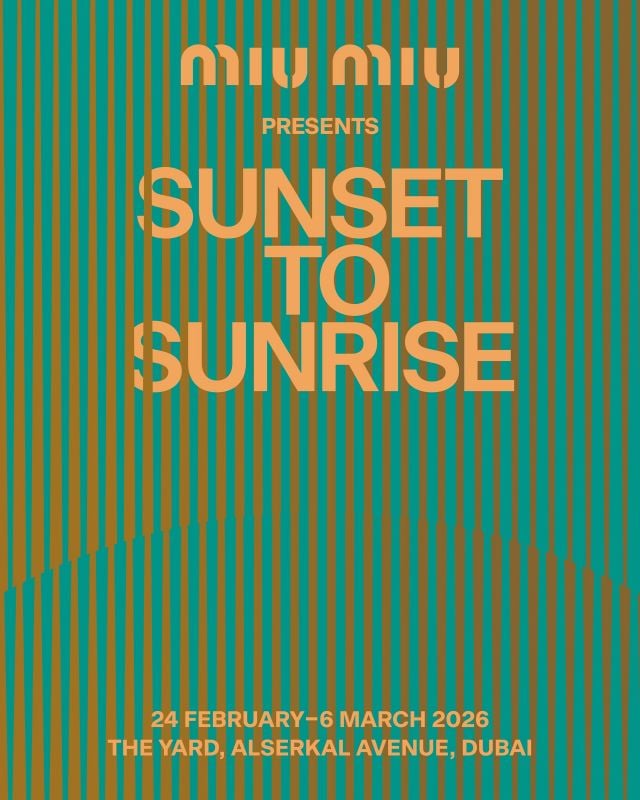الشاعر محمد ناصر الدين: «الشعر يبقى... وكذلك الحب»

ينتمي الشاعر اللبناني محمد ناصر الدين، الى الجيل الشعري الأخير، والذي يُعرف بالجيل الذي يكتب القصيدة الحديثة. ويحمل في قصيدته وأفكاره مفاهيم (حديثة) في الشعر واللغة. للتعرف على المسلك الشعري والثقافي لأحد أبناء هذا الجيل الجديد، كان لا بد من متابعة مباشرة مع الشاعر، فماذا يقول؟
- أنت شاعر تسعى الى الحداثة الشعرية!
بداية، علينا أن نعرِّف هذه الحداثة بدقة كي يصبح في مقدورنا أن نسعى إليها. إن كانت الحداثة تشير الي مرحلة زمنية أخذ فيها الشكل الشعري يبتعد عن أوزان الخليل مع رواد مجلة «شعر» وغيرها في خمسينات القرن المنصرم، فلا بد من أن إشكالية ما ستطل برأسها لو انحصر تصنيف النص بتاريخ ميلاده. هناك أبيات للمتنبي (على قلق كأن الريح تحتي مثلاً)، ونصوص نثرية تفكيكية للجاحظ تبدو كأنها أكثر حداثوية ومعاصرة من كثير مما يكتب اليوم. ما أسعى إليه تحديداً، هو ما سعى إليه الشعراء في مختلف العصور، من كهوف آلتميرا مروراً بسافو وهوميروس في اليونان الى صعاليك العرب والتروبادور في أوروبا الى شعراء مجلة «شعر» وما بعدها، هو شحن اللغة بهذه الطاقة المتفجرة التي يوفرها الشعر، وأن أنقل تجربتي الداخلية بلغة مختلفة عن السطحي والمبتذل والقواميس الجاهزة بمفرداتها التي استعملناها باسم الحداثة. باختصار، أنا أسعى إلى الشعر وأقوله بلغة يومي هذا فحسب.
- ما هو الشعر لك ولجيلك؟
للمناسبة، أنا في الأربعين من عمري وأنتمي إلى جيل يقع بين الجيل الأكبر الذي كان الشعر لديه يحمل مهمة خلاصية لبست ثوب الأيديولوجيا في مختلف وجوهها القومية والماركسية والدينية وغيرها، والجيل الأصغر الذي يطلق عليه اليوم اسم «شعراء الفايسبوك». لا أشعر بأنني أنتمي الي هذا الجيل من الشعراء ولا إلى ذاك. أستطيع أن أقول لك ما هو ليس من الشعر في تعريفي، كالتداعي اللغوي عند جيل الفايسبوك، والمعاضلة اللغوية والفصاحة المتذاكية المعكوسة لمن يُصطلح على تسميتهم بجيل الرواد. الشعر بالنسبة إلي أشبه بتلك العصافير التي تقترب من طاولات المقهى فنرمي إليها بقطع صغيرة من الخبز لتقترب، وحين نخيفها بنوع معقد من الحيل قد تهرب إلى الأبد. الأرجح، أن تهماً بالخفة والطيش تنتقل من جيل شعري الى آخر من دون دراسة واستبيان لما يكتبه كل جيل من هذه الأجيال. لا شك في أن في شعري مؤثرات غربية وشرقية أحاول أن أخفي مرجعياتها تحت طبقات النص، لكني أصدقك القول إن قلت أني لا أدين لشاعر معين بروح هذا النص. حداثتي أحاول أن أصنعها كما يقول بروست، بشيء من اللغة التي تنسلخ عن نفسها، وكأني أكتب بلغة أجنبية.
- ماذا تكتب؟ وما هو هاجسك الشعري؟ وما الذي يحرّضك للكتابة؟
أكتب فرحي وقلقي من الموت وصحتي ومرضي وطفولتي وكل ما يتعلق بوجودي وتجاربي منذ الطفولة في قرية جنوبية مفتوحة على الريح من كل اتجاهاتها وعلى نار الحرب والاحتلال، مروراً بمكوثي في فرنسا لفترة ليست بالقليلة للدراسة والعمل، والتي قرأت فيها الكثير من الشعر الفرنسي بلغته الأم. هاجسي مشترك مع كثر من الرسامين والنحاتين والفنانين والشعراء، هو أن أقول كلمة بوجه الموت، الذي هو مبعث كل إبداع فني وشعري. تحرضني للكتابة أشياء كثيرة، فأنا دكتور في الفيزياء وأجد أن أسئلة الشعر والفيزياء واحدة: نحاول في الاثنين أن نفسر هذا الكون، إذ تهتم الفيزياء بقوانينه الداخلية والقوى التي تحركه، ويهتم الشعر بما يبث فيه المعنى والحب والحساسية. وأحياناً، تحضني تفاصيل صغيرة على الكتابة، كحركة الأرنب في إعلان بطاريات الإنارة، أو وصفة للطبخ، وأحياناً أخرى أكتب نصاً شعرياً فوق نص لشاعر آخر، أو تلهمني معادلة رياضية أو فيزيائية. إنها اللعبة التي ينتقل فيها الشعر بين النسبي والمطلق.
- الى من تتوجه بنصك الشعري؟
لكل من يبحث عن جمال ما في هذا الكون. في أحد المهرجانات الشعرية التي شاركت فيها مؤخراً، اصطحبني أحدهم في مركب صغير في عرض البحر لنقرأ الشعر للأسماك، بحجة أن للسمك أيضاً حقاً في الاستمتاع بالشعر. أعجبتني الفكرة، بخاصة أني أعتقد أن الأنفاس التي نتنفسها والأصوات التي نسمعها هي مزيج من أنفاس الكون بأسره وأصواته. يمكنني أن أكتب لقارئ واحد، ويكفيني هذا الأمر لو كانت قصيدتي ستحفر في نفسه أثراً ما. في فيلم «el postino»، يغير بابلو نيرودا حياة ساعي البريد الذي ينقل له الرسائل في منفاه الإيطالي، ويعلمه أن يصف الورود لحبيبته في القرية. أظن أن صورة الشاعر الذي يخطب بالجماهير قد ولت إلى غير رجعة. أحياناً، يقول لي بعض الأصدقاء أن قصيدتي مشفرة وتتطلب استعداداً ثقافياً مسبقاً لفك شيفرتها، وأنها قصيدة نخبة. لا أتقصد هذا الأمر بتاتاً، وأرفض في المقابل أن أقدم للقارئ نصاً واضح المسار من بدايته حتى نهايته كما هي حال روايات الـbestseller التي تباع في المطارات وتحضّ القارئ على الكسل والدعة. تجنبت في ما أكتب الشعر السياسي لأني من أصحاب اليقين الصعب في الثقافة والأيديولوجيا، وأظن أن الشعر أكبر من السياسة والأحزاب برمتها.
- كيف ومتى عرفت أنك شاعر؟ النشأة والبدايات؟
عرفت ذلك مبكراً في المدرسة الابتدائية حين كنت أكتب مواضيع الإنشاء لرفاقي العشرين في الصف بعشرين طريقة مختلفة. مكتبة المدرسة المتواضعة في حينها مسحتها بالكامل، وكنت متعطشاً لأصغر ديوان شعري أستعيره وأخط ما يعجبني منه فوق دفتر صغير. نشأت في بيت فيه مكتبة كبيرة، كما أن انسلاخاً أولياً مؤلماً عن مكان الطفولة في الجنوب بفعل الحرب، غذّى في نفسي أكثر من منبع للألم والذكرى، وهي روافد اجتمعت كلها لتساعدني على الخوض في بحر الشعر في ما بعد. كتبت مرثية لجدي باللغة الفرنسية عندما كنت في العاشرة من العمر، وواظبت على نشر الشعر الوطني في ملحق «نهار الشباب» في جريدة «النهار» في منتصف التسعينات، وكذلك صرت أكتب القصائد الغرامية لأصدقائي في الجامعة الى حبيباتهم. عام ٢٠١٢، وبينما كنت أكتب على دفتر صغير في أحد المقاهي، أصرّ شخص يجلس على طاولة مجاورة على قراءة ما كتبته. كان هذا الشخص هو الشاعر السوري هاني نديم الذي أشركني في الليلة ذاتها في أمسية يقيمها منتدى شعري في بيروت، وطلب من صديقة تدير داراً للنشر أن تنشر مجموعتي الأولى. ولو لم يحصل هذا اللقاء بالصدفة، فربما كنت الى الآن أحتفظ بدفاتري في مكتبة بيتي، ومن يدري لعل النسيان أو القوارض تأكلها يوماً ما؟!
- هموم جيلك تكاد تنحصر في هم مشترك ربما هو الخيبة. هل توافق على ذلك؟
لا أوافق على هذا الهم بشكل مطلق ولا أعارضه بشكل مطلق كذلك. الشعر أولاً وأخيراً، تجربة داخلية تتصارع فيه اللغة مع نفسها. قد يكون نوعاً من التغرب وليس الخيبة، حرب اللغة مع اللغة ومع السائد الذي تروجه العولمة اليوم من لغة زائفة ومسطحة تعبّر عن الناس بلغة الأرقام في البورصة والتفجيرات واستطلاعات الرأي. إن كان من خيبة، فهي تجاه الطريقة التي تعامل بها السلطة الشاعر في كل زمان ومكان، بخاصة في الجغرافيا العربية. حين مات أراغون الذي كان يخاصم ميتران في السياسة، خرج الأخير ليعلن الحداد عبر التلفزيون الرسمي الفرنسي ويقول: «اليوم، أفلت شمس فرنسا، اليوم مات أراغون». أتخيل شاعراً كمحمد العبدالله مثلاً، توفي منذ فترة قصيرة من دون اهتمام يذكر أو تكريم في حياته. لدي خيبة من أفول القراءة، وقراءة الشعر تحديداً، إذ إن جناح الشعر حتى في المكتبات الكبرى لا يتعدى رفاً أو اثنين، كذلك حركة ترجمته البطيئة، من العربية وإليها.
- هل كتبت للحب وترجمته في الشعر؟
بالطبع كتبت عن الحب، وأظن أن الحب هو ما يعيننا على مواجهة الهجوم البغيض للموت على وجودنا. في الديوان الأخير «شمعتان للمنتظر»، يبدو الحب وكأنه اليوتوبيا التي تبحث عنها البشرية بعدما أرهقتها الصراعات العرقية والدينية ولم يجد لها العلم الذي أوصل إلى هيروشيما والقنابل الذكية، إجابات شافية حول قلقها ومرضها وشيخوختها وعجزها. أقول في إحدي القصائد: «الحجارة قصيرة الملامح/ لكنها رقيقة القلب/ حين تضع في كفك حجراً صغيراً/ يغفو الحجر/ مثل عصفور مهيض الجناح/ الوردة رقيقة الملامح/ لكنها قاسية القلب/ بالكف ذاتها/ حين تضع فوق القبر/ زنبقة صغيرة/ تأبى الوردة/ أن تتخذ سبيلاً في الرخام/ نصف الحجر/ ونصف الوردة/ هذا القلب.
- من هي المرأة هل كتبت لها؟ ومن هي المرأة الحاضرة في نصك؟
بالتأكيد كتبت للمرأة، ابن عربي يقول «كل شيء لا يؤنث لا يعول عليه». أهديت ديواني ما قبل الأخير لزوجتي زينب التي هي القارئ الأول لما أكتب بحساسية عالية، وعادة ما أختبر إيقاع القصائد الداخلي على بارومتر سماعها وتلقّيها. لطالما أحببت أن أعرف لمن كتب السياب قصيدته الخالدة التي يقول في مطلعها: «عيناك غابتا نخيل ساعة السحر»، أظن أنها صاحبة حظ عظيم. غاب السياب وقد تكون المرأة ذاتها دفنت في التراب، لكن الشعر يبقى وكذلك الحب.
شارك
الأكثر قراءة

إطلالات المشاهير
كيت ميدلتون تخالف القواعد الملكية بأحدث إطلالاتها

إطلالات المشاهير
قفاطين الملكة رانيا العبدالله… أناقة شرقية...

إطلالات المشاهير
إميلي راتاجكوسكي بكارديجان مربوط بذكاء حول...

إطلالات النجوم
بيلا حديد تقود أول دار أزياء من Revolve

إطلالات النجوم
جينيفر لوبيز تكرر إطلالتها في مطارين مختلفين
المجلة الالكترونية
العدد 1093 | شباط 2026

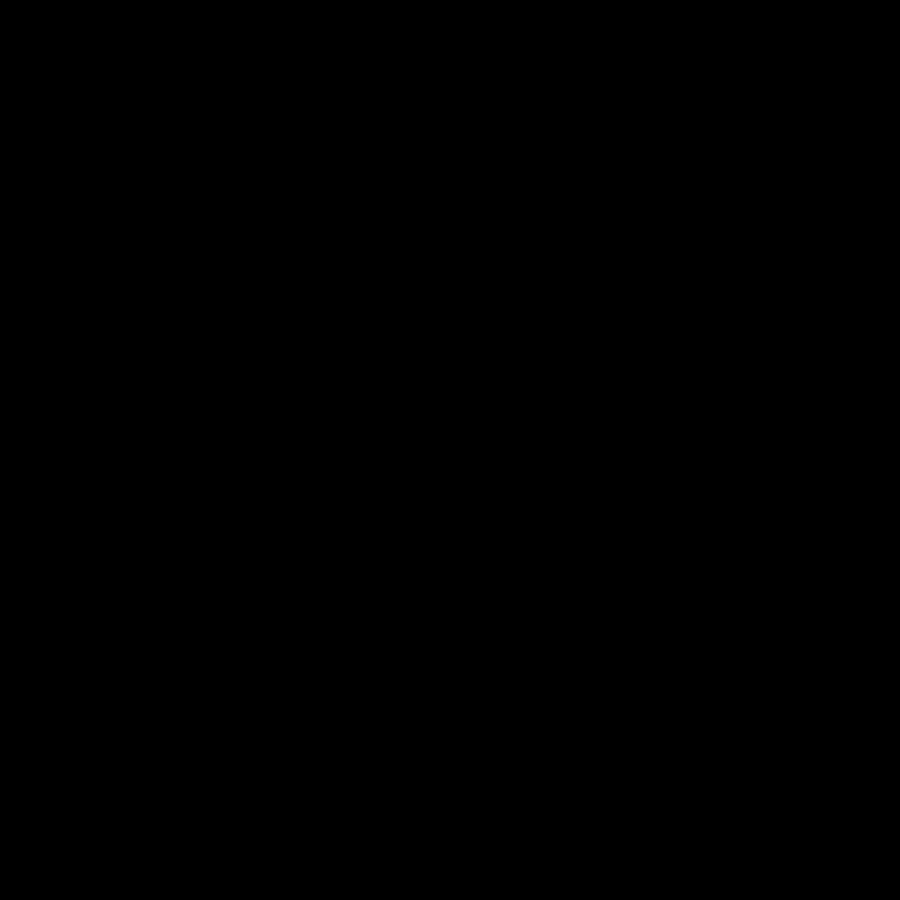
 إشترك
إشترك