في ذكرى ميلاده: كتاب جديد عن لقاءات صاحب نوبل محمود الشنواني: “ثلاثون عامًا في صحبة نجيب محفوظ”

LAHA
في الصفحات الأولى من الكتاب يتذكّر الشنواني قصة اللقاءين الأول والأخير: “ما بين اللقاء الأول في مقهى ريش يوم الجمعة 13 شباط/فبراير 1976 وأنا ابن التاسعة عشرة عامًا، حتى صعودي من جوف المقبرة على طريق الفيوم، بعد أن قبّلت الأستاذ والأب الحبيب للمرة الأخيرة يوم الخميس 31 آب/أغسطس 2006، وأنا ابن التاسعة والأربعين عامًا. في ذلك اليوم الشتوي البعيد، وأنا أجلس منتشيًا بالقرب من الأديب العظيم أرى وأستمع لأول مرة، لم أكن أدري أنني أبدأ أكبر تجربة فكرية ووجدانية تشكّلني وتتغلغل في أعماق عقلي وروحي”.
الشنواني لم يكن ينوي إصدار هذا الكتاب، الذي جاء بعد أربعين عامًا من لقائه بمحفوظ، لكنه أدرك أن الأحداث وتفاصيلها لم تكن غائبة عنه حتى هذه اللحظة، فأراد أن يخرجها في كتاب: “لم أكن أيضًا أدري أنني سأجلس بعد أكثر من أربعين عامًا، أتذكر وأتأمل وأسجِّل بعضًا مما رأيت وسمعت، بعدما أصبح اللقاء مئات اللقاءات، وبعدما أصبح نجيب محفوظ بالنسبة إليّ، ليس الأديب العظيم فقط، بل الأب والقدوة والإنسان، الذي أكتشف مع الوقت أن وجوده في حياتي، أصبح رغم غيابه الجسدي، أكثر حضورًا وتأثيرًا. على مدار أعوام اللقاء الممتدة، خطر لي بين الحين والآخر أن أسجل ما يدور أمامي وأشارك فيه، لكنني لم أفعل... انتابني شعور أن الأَولى أن أتشبّع بروح وفكر الأستاذ بشكل شامل ولا أنشغل بالتفاصيل. انتابني الشعور نفسه الذي يمكن أن يجده الإنسان عندما يريد تسجيل مشهد مهم بكاميرته، فيجد أن هذا قد أفقده جزءًا مهمًّا من الإحساس المباشر بالمشهد، بل إنني أيضًا لم أسعَ للاحتفاظ بصور فوتوغرافية تسجّل تلك العلاقة الطويلة ومحطاتها، ولا أجد في حوزتي إلا صورًا قليلة أسعدني بعض الأصدقاء بالتقاطها وإهدائي إياها. أجد نفسي الآن مُتمنيًا لو أن في يدي دفاتر فيها ما كتبته طازجًا وقتها، فتنير لي زوايا الذاكرة التي تخفت إضاءتها مع الوقت، وتتيح لي التأمّل في الفرق بين ما خطر لي وقتها وما أراه الآن، وتضبط بدقة التواريخ والتفاصيل التي يصعب ضبطها الآن. لكن يعوّض ذلك، أن هناك أحداثًا راسخة في الذاكرة، وأنني سأسعى لتسجيل المناخ العام، وفقط التفاصيل التي ما زلت أحتفظ بها واضحة لأهميتها ولتأثيرها، وأن حديثي لن يكون مجرد سرد لمواقف خبرتها، بل فيه جزء أساسي من تأمل ما وراء تلك المواقف”.
مؤلف الكتاب لم يركز فقط على الأحداث، إنما تابع الأماكن والشخصيات المختلفة التي تنقلت فيها لقاءات صاحب نوبل: “مع انتقال الندوة إلى قصر النيل، توقف عن الحضور بعض روّادها من مقهى ريش، بعضهم لم يحضر إلى قصر النيل أساسًا، وبعضهم بدأ حضوره في التباعد، لكن الأستاذ مصطفى أبو النصر واصل حضوره بنفس الانتظام ونفس درجة المشاركة، والأستاذ هارفي أسعد استمر كذلك بانتظام لعدة سنوات ثم بعدم انتظام بعد ذلك حتى وفاته، كذلك الأستاذ علي سالم كان يحضر بغير انتظام، لكن كالعادة له حضور متميز، واستمر الأستاذ إبراهيم منصور في التردّد على الندوة إلى أن غادرها غاضبًا عند حضور السفير الإسرائيلي، وأيضًا الشاعر عادل عزت استمر في حضوره بين الحين والآخر”.
وعن أوجه الاختلاف بين رواد ندوتَي ريش وقصر النيل، يقول صاحب الذكريات: “قد تكون من أوجه الاختلاف بين رواد ندوتَي ريش وقصر النيل، أن رواد ريش كانت غالبيتهم من الأدباء وممن يعتبرون الآداب اهتمامًا أساسيًّا وكينونة بالنسبة إليهم. أما رواد قصر النيل فمنهم بالقطع بعض الأدباء والمهتمين بالآداب وكانت مكانة الأستاذ نجيب الأدبية المرموقة سببًا أساسيًّا في انجذابهم لحضورها، لكن درجة انتمائهم بشكل عام الى عالم الأدب كانت أقل من رواد ريش، وكان منهم أيضًا من يعتبرون حديث الأدب هامشيًّا بالنسبة إليهم، فاهتماماتهم الأساسية لها مجالات أخرى. ووجه آخر للاختلاف بين رواد المكانين، أن رواد ريش كان يغلب عليهم الانتماء الى التيار السياسي اليساري، وكان هذا الانتماء أيديولوجيًّا قويًّا عند الكثير منهم، أما رواد قصر النيل فقد كانت أطياف انتماءاتهم السياسية أكثر اتساعًا، ودرجة انتمائهم الأيديولوجي أضعف.
شارك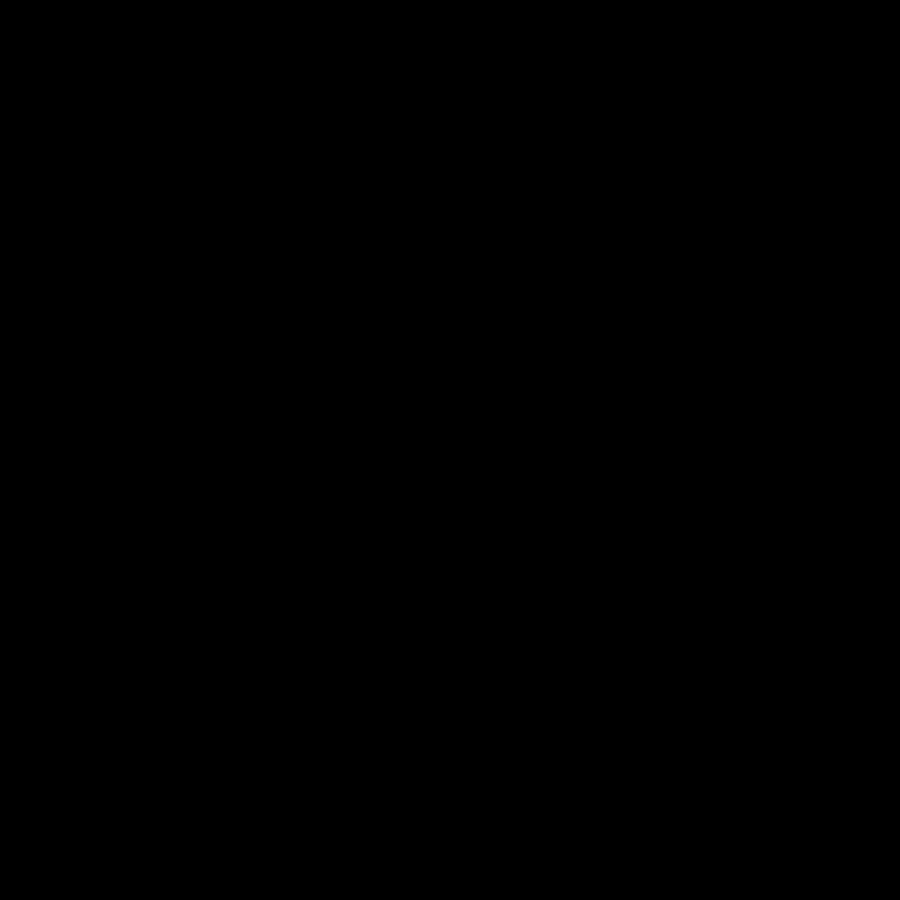

 إشترك
إشترك

















