الشاعر باسم المرعبي “في الهجرة والهجير” الحب هو نسيج الكتابة وعروقها

الشاعر العراقي باسم المرعبي

باسم المرعبي ـ الأعمال الشعرية. غلاف
- أين تعيش اليوم؟ هل أنت في المهجر أم في العزلة أم في المنفى؟
أنا في هذا كله، في المهجر والمنفى والعزلة، رغم شعوري بأنني خنتُ عزلتي من خلال تفاعلي على بعض وسائل التواصل الاجتماعي. ولولا متطلبات الكتابة، لكانت عزلتي أكثر إحكاماً، وهذا ليس استعلاء، لأنني بطبعي أميل الى الانطواء. وما يعزّز طبيعة هذه العزلة لديّ أنني أعيش منذ أكثر من عشرين عاماً في بلد يميل شعبه الى الانغلاق، فالمجتمع السويدي معروف عنه، بشكل عام، التحفّظ والميل الى العزلة. ومن هنا، أشعر بأنني أعيش في كل الأزمنة والأمكنة. وقد دفعني هذا الهاجس الى كتابة نص عنوانه “كنتُ قبل مائة عام”، أصف فيه بدقّة هذا الاختلاط.
- إلى أين أوصلك غيابك عن أرضك ووطنك؟
عندما تكون خارج الوطن، تُواجَه في الغالب بسؤال: من أين أنت؟ وهو ما تودّ التخلص منه وترغب أن تكون في مكان لا يباغتك أحد بمثل هذا السؤال. ومشاعر كهذه لا تتعلق بالفشل أو النجاح في أمكنتنا الجديدة بمقدار ما تتعلق بتاريخ نفسي كامل لصيق بنا، بتاريخ من الرؤى والذكريات والتفاصيل يكون مصدرها الوطن. وبعد مضي أكثر من ربع قرن على مغادرتي العراق، ما زلت أحلم بالأماكن التي أحبّ في العراق، وبغداد بشكل خاص، حتى أن الأمنيات تحوّلت الى أحلام. في الواقع، أفكّر كثيراً في شارع الرشيد في بغداد، وكم تُحزنني صور الخراب والدمار والإهمال المنتشرة فيه. في الحلم، أجد نفسي أتنقل في هذا الشارع بمشاعر من الغبطة لا يمكن وصفها، حيث الإضاءة وحركة الناس وسعة الأرصفة، لا بل أجد تطويرات وإضافات الى المكان، هي من صنع الخيال، فأصحو سعيداً وممتناً لهذه الهبة العظيمة.
- والشعر، أين أنت منه اليوم؟
تسألني عن الشعر... وما أنا من دون الشعر؟ دعني، وهماً أو حقيقة، أعيش هذا الشعور. لقد تورّطت وقُضي الأمر. لكن الورطة، لا بل الطامة الكبرى أن تتعامل مع العالم من منطلق الشعر، في وقت يحتاج فيه التعاطي مع هذا العالم الى قفّازات من حديد. والشعر، كما تعرف، لا يُحصر في تعريف، لكن يمكن أن يتجلّى في بعض المظاهر، كما في قطرات مطر على زجاج نافذة، في ريح تتخلل أوراق الشجر، وفي الجمال بكلّ أنواعه، بل قد يتجسّد في امرأة، جمالها في أقصى درجات العنف والقسوة. وعلى أية حال، أفضّل أن أعيش الشعر على أن أكتبه. لكن أين وكيف؟ فالشعر بهذا المعنى وعد فردوسيّ، وعد بالجمال المطلق. الشعر كُنه محجوب، وما القصائد التي نقرأ إلا بعض إشارات منه أو عنه. الغياب الذي تسأل عنه أحياه شعراً، وكذلك الحضور.
- ماذا تكتب، وماذا تودّ أن تقول بعد؟
لا يمكن شاعراً أن يكتفي أو يرتوي بقصيدة أو ديوان، بخاصة عندما تتحول الكتابة عموماً وكتابة الشعر خصوصاً الى ممارسة وجود. وهذا ما أنا عليه اليوم. فبعد عشر مجموعات شعرية وما يقاربها عدداً من كتب النثر، لا يمكنني أن أجد نفسي بعيداً من الكتابة. لقد كيّفت حياتي وكرّستها للكتابة. مع كل قصيدة، أشعر ببداية جديدة، وألحظ الفروق والتطورات في كتابتي. ومع كل جلسة للكتابة، أشعر بأن لدي مادة جديدة وطريقة جديدة للقول. هذا الغوص في عالم الكتابة هو الوجه الآخر لما أفدت به سابقاً حول النظر الى العالم والتعاطي معه من خلال الشعر، مهما كانت الخسارات نتيجة هذا الخيار، خصوصاً لمن لا يُجاري التيارات ولا يبيع ويشتري بكتابته التي هي موقفه من العالم والأشياء في الوقت نفسه.
- كيف ترى وطنك من خلف قضبان غيابك؟
كتبتُ ذات مرة: “في ثيابي العراق وتحت جلدي. في التماعة الدم وفي قوامه”. هكذا هو العراق بالنسبة إليّ. وقولك من خلف القضبان، هو تشبيه جيد. أجل، نحن بشكل أو آخر أسرى غربتنا هذه، وثمة ما يحول بيننا وبين الوطن، سواء تجسّد ذلك بشكل مادي أو معنويّ. رغم أن هاجسي الدائم هو العراق، لكن في أحيان كثيرة أفكّر بعدم العودة إليه احتجاجاً على مظاهر الفساد والأنانية واللامسؤولية التي تفشّت فيه. والعراق اليوم شقيّ بأبنائه، بالدرجة الأولى.
- باسم الشاعر البعيد، هل هو حزين أم سعيد اليوم؟
لحظات الأسى هي اللحظات الأكثر رسوخاً لدي، وتفوق بكثير لحظات الفرح، سواء على الصعيد الشخصي أو العام. وإن كان يصعب الفصل بين الاثنين، غالباً، فكلاهما يؤثر في الآخر. لو نظرنا إلى ما يحدث في العالم وفي منطقتنا العربية بشكل خاص، فأي مكان للفرح أو التفاؤل سيبقى. بلداننا التي نُحب هُشّمت وأُناسنا قُتلوا أو هجّروا، والكثير من القيم الجميلة اختفت، وأخشى أن يكون الآتي أسوأ. لكن بما أن الإنسان يميل بطبعه الى نسيان الحزن وتجاوزه وانتزاع لحظات الفرح من عمق المأساة، أجد في الاستمرار بالكتابة المعادل الموضوعي لتداعي العالم. والفرح الأعمق بالنسبة الى الكاتب يكمن في ما ينجزه من كتابة وفي هذه الممارسة في حد ذاتها.
- كيف تعيش الحب، وهل حقاً دهمك الحب في أرض الغربة؟
أنا في حالة حب دائم، كيف لا والقلب مستفّزَ بالجمال ومُخاطَب به على الدوام! كل مشهد سيكون ناقصاً ومروعاً من دون أن تظلّله المرأة بالحب والجمال. وعمّا إذا كان الحب قد دهمني في أرض الغربة، أؤكد أن ثمة قصائد نشرتها في الآونة الأخيرة كانت بأكملها مكرّسة للحب. لكنها ليست المرّة الأولى التي يحدث فيها ذلك، فإذا اطّلعت على كامل أعمالي الشعرية ستجد أن الحب يشغل حيزاً كبيراً فيها، منذ البدايات وعلى امتداد المراحل. الحب هو في نسيج هذه الكتابة ومتغلغل في عروقها.
- وهل تفشل القصيدة بلا حب؟
استكمالاً لإجابتي السابقة، أقول إنّ الحب موضوع خالد، لا يمكن أن يُستنفَد. وطالما أننا نتحدث عن القصيدة، أي عن الفن، فالمسألة لا تتعلق بالموضوع فقط، وإنما تتخطّاه لتشمل كيفية معالجته والطريقة المتبعة في ذلك. في إمكان أي شخص أن يكتب عن الحب، لكن ما الذي يُبقيه الزمن؟ هذا هو السؤال. ولماذا يتبادر إلى أذهاننا اسم هذا الشاعر أو ذاك دون سواهما مقترناً بهذه التيمة. أن تفي هذا الموضوع، أو أي موضوع آخر حقه، هو أن تقدّمه بطريقة أو لغة فذّة. والقصيدة تحيا بالحب، بمفهومه الأوسع، وتموت بالكراهية. شعراء الكراهية انتحروا بالضغينة وانتحرت قصائدهم معهم. فالسموم التي في قلوبهم وأجسادهم تتسرّب الى كتاباتهم. لا يمكن روحاً ملأى بالشر والخبث أن تنتج شعراً جميلاً، فهذا محال، والشعر الخالد هو الشعر المنفتح على الإنسان في أرفع صورِه وأطواره.
- المرأة في حياة الشاعر هي الأمل والجنون. ماذا قالت القصيدة للمرأة، ومن هي المرأة التي تسكن قصيدتك؟
جذر كتابتي مدين أساساً إلى المرأة، فعبرها التمست الطريق الى الشعر. والمرأة عموماً، هي مصدر كتابتي ومتنها، حتى أنها تتخلّل الموضوعات التي تبدو بعيدة عنها. لذا لا يمكن عزلها عن نسيج القصيدة. فالمرأة بالنسبة إليّ، ليست موضوعاً أو غرضاً يُكتب بدافع التقليد أو الواجب، بل هي في صلب الوجود الشعري. والمرأة عالم شعري في ذاته. وأزعم أن كل دهشة تزول في هذا العالم، إلا الدهشة إزاء شيئين: خلق الكون بهذا النسق العظيم المُتقن، والدهشة في حضور المرأة، التي هي مجموع تناقضات... فهي مزيج من طفولة ونضج، براءة ومكر، جنون وحكمة، ورقّة وشراسة. أما عن المرأة التي تسكن قصيدتي، فهناك أكثر من امرأة. فثمة ما هو عابر من النساء، وثمة ما هو مقيم وثابت. وكذلك القصائد، فمنها ما هو مرايا لما هو خارجي وعابر، وأُخرى لما هو داخلي وحميمي.
- متى تكتب ولماذا؟ وهل الكتابة بديلٌ لكل عذاب وتعب؟
لا وقت محدداً لديّ للكتابة، وليس من تنظيم بالمعنى الدقيق، لكن في المجمل تأخذ القراءة والكتابة من يومي الكثير، حتى على حساب راحتي. وحين لا أكون منهمكاً بالكتابة، أشعر بنوع من الفراغ وتأنيب الضمير. نعم الكتابة هي بديل لكل عذاب وتعب. الكتابة هي ردّ الشاعر- الكاتب على كل ما يحيط به من مشاهد تستدعي السخط والغضب. لماذا تكتب؟ هو سؤال خالد، ولطالما طُرح وبأشكال مختلفة مع أجوبة كثيرة متنوعة. ليس بالضرورة أنّ كل ما يُكتب سيبقى صامداً في وجه الزمن. وحتى مع يقين الشاعر وإيمانه بأهمية ما يكتبه، ينتابه الشعور بالعبث في أحيان كثيرة.
شاركالأكثر قراءة

إطلالات النجوم
كريستينا أغيليرا تتألق بمجوهرات شوبارد الماسية...

إطلالات النجوم
نانسي عجرم تحيّر الجمهور بإطلالتها.. عصرية أم...

أخبار النجوم
مطالبات بطرد محمود السراج من مصر بعد تصريحات...

إطلالات النجوم
ديمة قندلفت تتألق في أسبوع باريس للأزياء...

أخبار النجوم
محامي زينة يكشف حقيقة دفع أحمد عز 2.5 مليون...
المجلة الالكترونية
العدد 1092 | كانون الثاني 2026

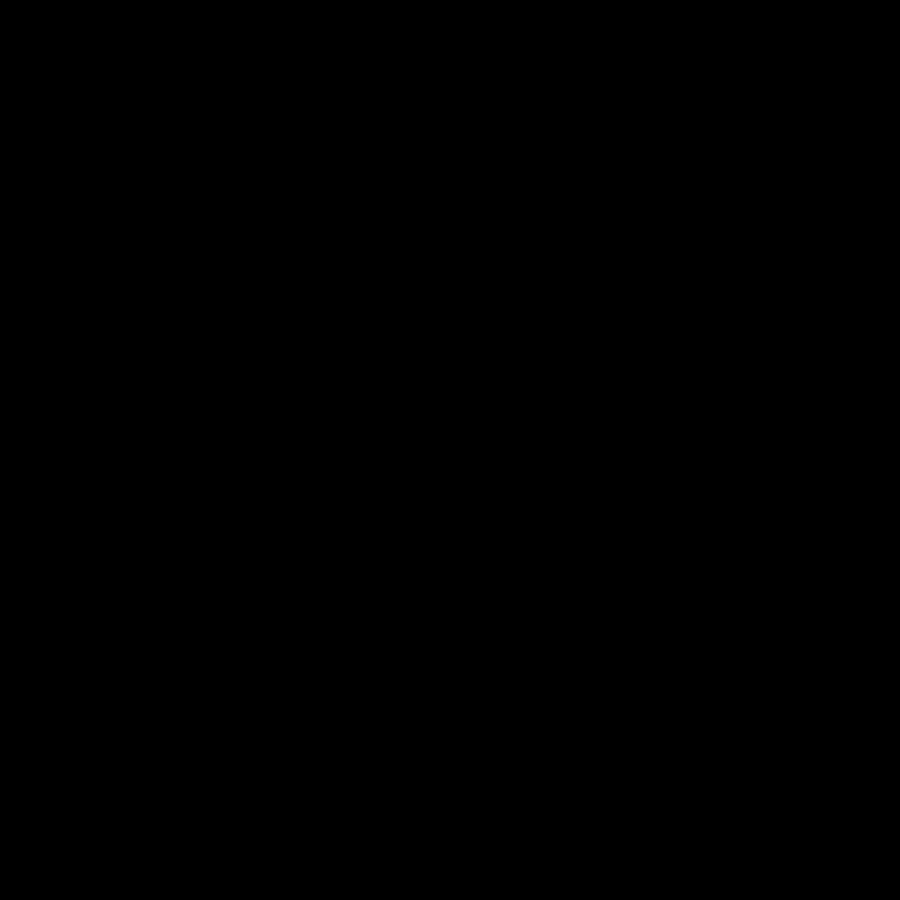
 إشترك
إشترك












