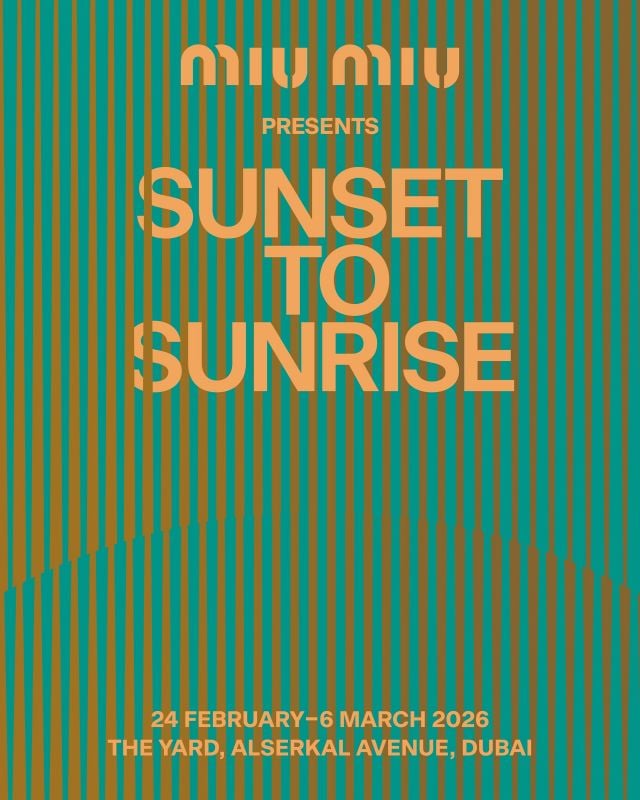الفائز بجائزة الفرنكوفونية الكبرى من الأكاديمية الفرنسية - ألكسندر نجّار: الكتابة لي متنفّس وجسر عبور إلى عالم آخر

ألكسندر نجّار

مع جبور الدويهي وسمير فرنجية ورشيد الضعيف.
الكتابة قَدَر. حياة أخرى تخطّها كلماتنا فوق الورق. وهي أيضاً مسيرة نضال وإيمان بغدٍ أجمل. أما الكاتب فهو صانع الحلم في كلّ مكان وزمان. وما الجوائز التي يفوز بها سوى اعتراف بروعة هذا الحلم وجمال تفاصيله. ألكسندر نجّار، المحامي والكاتب اللبناني، ضمّن أحلامه أكثر من ثلاثين كتاباً، ما عدا القصائد الشعرية، فشكّل فوزه الأخير بجائزة الفرنكوفونية الكبرى التي تمنحها الأكاديمية الفرنسية سنوياً لكاتب مميّز أغنت مؤلّفاتها الأدب الفرنسي، بارقة أمل تعيد للبنان أمجاده الأدبيّة والإبداعية، في وقت يعيش فيه هذا الوطن أقسى أزمة مالية واقتصادية عصفت به، تُضاف إليها الأزمة الصحّية المستجدّة بفضل جائحة كورونا. في هذا الحوار، ندخل الى حديقة ألكسندر نجّار الخاصّة، لنكتشف كاتباً مميّزاً ومثابراً وشجاعاً ومدافعاً عن الحريات، يحترم المرأة وحقوقها، ويؤمن بأنّ الإبداع والابتكار إثباتٌ للوجود. "أبدعوا، فالحياة، ليست صالة انتظار"، يقول نجّار.
- من هو ألكسندر نجار الروائي والمحامي والإنسان؟
وُلدتُ عام 1967 في بيروت. أصل عائلتي من دير القمر في الشوف اللبناني. لكن جدّي غادرها للعمل كمحامٍ في مدينة صور قبل أن ينتقل مع عائلته إلى العاصمة بيروت. أنهيت تعليمي الثانوي في مدرسة "الجمهور" حيث نلتُ المرتبة الأولى في البكالوريا الفرنسية، ثم انتقلت إلى باريس حيث درست الحقوق. أمارس مهنة المحاماة منذ أكثر من 30 سنة، إلى جانب الكتابة، وهي هوايتي منذ أن كنت في سنّ التاسعة إذ كتبت حينها أوّل قصصي، فطبعتها أمي على الآلة الكاتبة، وتولّى شقيقي الرسوم التي زيّنت الكتاب. كانت تجربة جميلة شجعتني على الاستمرار في الكتابة. وأثناء دراستي في فرنسا، شاركت في مسابقتين، الأولى تتعلّق بالرواية والثانية بالشعر، ففزت بكليهما، مما شجّعني أكثر فأكثر على الكتابة!

- ماذا أضافت جائزة الأكاديمية الفرنسية Le Grand Prix de la Francophonie إلى تاريخ ألكسندر نجار، في وقت يمرّ فيه لبنان بأزمة هوية وانتماء؟ ماذا يعني هذا التكريم؟
تُعد جائزة الفرنكوفونية الكبرى التي تمنحها الأكاديمية الفرنسية من أهم جوائزها السنوية، وقد نالها قبلي الشاعر والكاتب المسرحي الكبير جورج شحادة عام 1986 والكاتب والسفير صلاح ستيتيه عام 1995. وقد جاءت هذه الجائزة لتذكّر بوجه لبنان الحضاري وبدوره الثقافي في العالم، لا سيما في مجال الفرنكوفونية. كما فوجئت بموجة كبيرة من ردود الفعل الإيجابية من جانب المواطنين والقرّاء، إذ رأوا في هذه الجائزة بصيص أمل في النفق المظلم الذي يتواجد فيه لبنان الذي يعاني أزمة اقتصادية ومالية خانقة، إضافة إلى تداعيات جائحة كورونا التي لم تَرحم شعبه. والجائزة ألقت على عاتقي مسؤولية كبيرة إذ إن نيلها في سنّ "مبكرة" سيضعني أمام تحدّيات كبيرة ويجعلني أثابر للاستمرار بجدّية ورصانة في مسيرتي الأدبية.
- هل كنتَ لتعرف هذه الشهرة وهذا التكريم لو بقيتَ في لبنان، علماً أنك نلتَ العديد من الجوائز القيّمة في وطنك الأمّ؟
لا شكّ في أن فرنسا تساعد الشباب على اكتشاف مواهبهم وصقلها. وأكبر دليل على ذلك نيلي جائزتين في باريس "مدينة النور" حين كنت طالباً في كلية الحقوق هناك. إلاّ أن لبنان لم يبخل عليّ في التكريم، إذ نلتُ وسام الأرز برتبة ضابط، وجائزة حنّا واكيم للرواية، وجائزة المونسنيور أغناطيوس مارون، وجائزة جبران خليل جبران، وجائزة سعيد عقل... في الحقيقة، إن غالبية الكتّاب اللبنانيين الناطقين باللغة الفرنسية عاشوا أو يعيشون في فرنسا. أما شريف مجدلاني وأنا فقد فضّلنا البقاء في وطننا. في "رواية بيروت"، كتبت "إن المرء لا يولد في بلد معيّن صدفةً، بل لتحقيق مصيره"، وهذا تحديداً ما أقوم به، أي ألعب دوري ككاتب ومحامٍ في البلد الذي شاء الله أن أبصرُ النور فيه!
- من هم الكتّاب الذين تقرأ لهم، وتعشقهم؟
في الأدب العربي، جبران خليل جبران وميخائيل نعيمة وفؤاد سليمان ومارون عبود وتوفيق يوسف عوّاد وسعيد عقل ونجيب محفوظ. وفي اللغة الفرنسية ألبير كامو Albert Camus وبول أيلور Paul Eluard وفيكتور هوغو Victor Hugo وبودلير Baudelaire ولوكليزيو Le Clézio. أما في اللغة الإنكليزية فهمنغواي Hemingway وستاينبك Steinbeck وفولكنر Faulkner ووليام بويد William Boyd.

- كيف أثّر فيك الكاتب اللبناني الثائر جبران خليل جبران؟ وأيّ كتبه تحبّ أكثر؟
جبران أثّر فيّ كثيراً، وقد خصّصتُ له خمسة كتب، بالإضافة إلى مسلسل من إخراج سمير حبشي عُرض على الشاشات اللبنانية. ما يلفتُ في جبران أنه كان رسّاماً وكاتباً، ثائراً (في كتاباته العربية) وروحانياً (فـي كتاباته الإنكليزية)، ولكن من دون أي تناقض بحيث نلاحظ تكاملاً فعلياً للوجهين. وجبران كان رؤيوياً (visionnaire) إذ "وضع يده على جروح "لبنان فثار على الإقطاعية والطائفية والاستغلال والاستبداد، كما دعا العرب إلى الثورة والتحرّر من العبودية بمختلف أشكالها. كتابي المفضّل هو "النبي" طبعاً، وقد تُرجم إلى أكثر من مئة لغة في العالم، إلاّ أنني أدعو القرّاء الذين يجهلون سائر كتاباته إلى مطالعتها، لأن جبران مدرسة حياة.
- في كتاباتك ورواياتك تحمل شعلة الحرّية؟ ما هو مفهومك الشخصي للحرّية؟
الحريّة هي جزء لا يتجزّأ من الهوية اللبنانية، ولا وجود للبنان من دون حريّات. وقد دفع الكثير من الصحافيين ثمن حريّة التعبير من دون أن يتمكّن المجرمون من إسكات صوت الحرية وكسر أقلام الأحرار. الحريّة موجودة على الدوام في كتاباتي، خصوصاً في رواياتي: "حصار صور" و"برلين 1936" و"رواية بيروت"... حتى أن اختياري لبعض الشخصيات التي كتبتُ سِير حياتها، كان دافعه إظهار تمسّك تلك الشخصيات بالحرية. فعندما كتبتُ سيرة ميشال زكور، مؤسّس مجلّة "المعرض"، مثلاً، أردتُ إظهار نضال هذا الصحافي من أجل الحريّات في ظلّ الانتداب الفرنسي الذي كان يقمع حريّة التعبير باستمرار بواسطة أجهزة الرقابة... مفهومي للحريّة هو أن الإنسان حرّ منذ ولادته، ولا يمكنه أن يكون رهينة في يد السلطات أو الأيديولوجيات أو الأجهزة أو الفقر. ومصير الإنسان أن يتحرّر من القيود التي تحول دون تحقيق ذاته وأحلامه. السبيل إلى ذلك ليس سهلاً، لكن الحريّة مثل مياه المطر: يمكنها أن تفتّت الصخر... إنها مسألة وقت فقط، لكن لا بدّ لها من أن تنجلي في النهاية!
- ما علاقة دراستك المحاماة وممارستك إياها في حملكَ شعلة حقوق الإنسان والحريات؟
رسالة المحامي هي في الأساس الدفاع عن الحريّات وعن الحق ضدّ الظلم. فكان من الطبيعي للكاتب - المحامي أن يكون مدافعاً عن هذه الحريّات! والحقيقة أن الكتابة والمحاماة توأمان، لأن المحامي والكاتب يستخدمان الكلمة من أجل الدفاع عن الحريّات!

- قلتَ في إحدى المقابلات إن الكاتب أهمّ من الوزير. كيف ذلك؟
نعم الكاتب أهم من الوزير، لأن الأدب والفكر يدومان، في حين أن المناصب السياسية والإدارية والعسكرية تزول ويعود بعدها الوزير أو المدير أو العماد إلى منزله حيث يصبح مواطناً عادياً. رسالة الكاتب، وهي أن يشهد على تقلّبات مجتمعه وشؤونه وشجونه ويدافع عن الحريّات ويُبدع، أسمى بكثير من ممارسة مهام وزارية!
- كيف نزرع حبّ القراءة في الجيل الجديد، وهي الطريق الى المعرفة؟
القراءة لا تزال حيّة، حتى ولو لاحظنا تراجعاً في ذلك لدى الجيل الجديد. في الحقيقة، هذا الجيل يقرأ ولكن بصورة مختلفة، مستعيناً بالحاسوب، وبسرعة فائقة، لأنه يفتقر إلى الصبر والتركيز في عصر الرقمية والتقدّم التكنولوجي. دورنا أن ننمّي حبّ القراءة في المدارس وبالتعاون مع الأهل والمعلمين، لأن القراءة هي المصدر الأسلم لإغناء ثقافة الطالب وتغذية فكره ومساعدته على إتقان اللغات. واللافت أن الأولاد يحبّون القراءة، لكنهم يبتعدون عنها فجأةً عند بلوغهم سنّ المراهقة حيث تتحوّل اهتماماتهم في هذه المرحلة إلى مواضيع أخرى، مما يستدعي البحث عن السُّبل الآيلة إلى تفادي هذا "الطلاق"، من طريق التوعية والتحفيز والتوفيق بين القراءة والمعلوماتية، لأن هناك تكاملاً بينهما ولا يجوز اعتبارهما "عدوّين".
- كيف تزرع حبّ القراءة في أولادك؟
أختار لهم دائماً كتباً مشوّقة مستعيناً بخبرتي في هذا المجال، ليقيني بأن ثمّة مؤلّفات كلاسيكية لم تعُد تحاكي العصر ولا يمكن فرضها على جيلنا الجديد إلاّ من باب إطلاعهم على تاريخ الأدب القديم. نجد اليوم في المكتبات كتباً جيّدة في مختلف الميادين، بحيث يمكن القارئ أن يختار بسهولة أي كتاب يتناول موضوعاً يهمّه من دون أن نُرغمه على قراءة كتاب آخر مملّ أو بعيد من اهتماماته.
- روايتك "ميموزا" تتحدّث عن والدتك التي لعبت دوراً أساسياً في حياتك. أخبرنا عن علاقتك المميّزة بوالدتك؟
والدتي تشبه أيّ أمّ عربية تتحلّى بروح التضحية والشجاعة والصبر. فقد عايشتْ الحرب اللبنانية ووجدتْ نفسها أمام تحدّيات جمّة، خصوصاً أنها أمّ لعائلة كبيرة مؤلّفة من 6 أولاد. لكنها نجحتْ في تربيتنا متخطيةً كل الصعوبات. لعبت أمي دوراً رئيساً في تثقيفي إذ كانت تمدّني باستمرار بالكتب التي كانت تحتفظ بها من أيام الطفولة والمراهقة، كما شجعتني حين تأكدت من أنني أملك موهبة الكتابة، وشجّعتْ شقيقي عندما اكتشفت لديه موهبة الرسم. وهي، بالإضافة إلى ذلك، كانت امرأة تتمتّع بعزم كبير إذ درَّست العلوم واللغة الفرنسية في مدرسة في منطقة فرن الشباك، فيما كانت تدرُس الحقوق في الجامعة، على الرغم من تحفّظات جدّي الذي كان، على غرار غالبية الأهل آنذاك، يفضّل أن تلازم المنزل!
- كيف أثّرت والدتك في نظرتك الى المرأة ودورها في صلب العائلة والمجتمع اللبناني؟
أثّرت والدتي فيّ لهذه الناحية، إذ علّمتني مبادئ الاحترام، وخصوصاً احترام المرأة. كما علّمتني الكَرَم إذ كانت تساعد المحتاجين على الدوام...

- ماذا عن حقوق المرأة المهضومة في مجتمعاتنا الذكورية؟
المرأة اللبنانية ربحتْ حتى الآن معارك مهمّة، وقد أصدر البرلمان اللبناني أخيراً قانونين يحميانها من العنف الأسري والتحرّش. كما نرى المرأة اللبنانية حاضرة في مختلف الإدارات والوزارات، حتى أن عدد الإناث أصبح يفوق عدد الذكور في القضاء اللبناني، وهذا دليل انفتاح وعافية! أما الموضوع الذي لا يزال شائكاً في لبنان فهو مسألة تمكين المرأة اللبنانية من إعطاء الجنسية إلى أولادها عندما تكون متزوّجة من أجنبي. هذا حق من حقوقها لا يمكننا حرمانها منه، كما لا يجوز التمييز بينها وبين المواطن الذكر الذي يمنح الجنسية إلى أولاده بصورة تلقائية، إلاّ أن هذا الموضوع يثير اعتراضات سياسية وديموغرافية يقتضي بحثها برويّة ومسؤولية من أجل إيجاد الحلّ المناسب الذي يُنصِف المرأة.
- بيروت هي لكَ أمّ ثانية، مدينة تسكنك، إلى أيّ بيروت تنتمي؟
كنت في الثامنة من عمري عندما اندلعت الحرب اللبنانية بحيث لا يمكنني القول إنني أشعر بالحنين إلى "العصر الذهبي" الذي تميّزت به بيروت قبل العام 1975. إلاّ أنني تعرّفت على ذاك العصر من خلال القصص التي كان يرويها والداي والأصدقاء المسنّون، ومن خلال الأبحاث التي قمت بها من أجل كتابة "رواية بيروت"... من المؤسف أن تكون بيروت في الخمسينيات أو حتى العشرينيات عند إعلان دولة لبنان الكبير، أكثر ازدهاراً مما هي عليه اليوم! أي بلد في العالم غير لبنان كان أكثر ازدهاراً قبل 75 أو 100 سنة؟! مما يؤكّد إفلاس الطبقة الحاكمة، التي بدل أن تُبقي لبنان على المستوى المطلوب، منارةً للشرق، حوّلته إلى دولة فاشلة يتآكلها الفساد!!
- تقول إنك تعشق بيروت وباريس، ما الجامع بينهما؟
بالنسبة إليّ، بيروت تعني العائلة والجذور ومهنتي كمحامٍ والعلاقات الاجتماعية، فيما تقدّم لي باريس الانفتاح والنشاط الثقافي الدائم!
- الانفجار الذي هزّ مرفأ بيروت في الرابع من آب/ أغسطس، هل أوحى لك رواية جديدة عن بيروت؟
انفجار المرفأ في الرابع من آب/أغسطس كارثة لا يمكن نسيانها، ويشكّل محطة سوداء في تاريخ لبنان، ومن الطبيعي أن تترك هذه الفاجعة أثراً فيّ ككاتب وستكون حتماً موجودة في مؤلّفاتي اللاحقة، علماً أنني شاركت مع نخبة من الأدباء والفنانين، من بينهم Le Clézio، الحائز جائزة نوبل للآداب، في إعداد كتاب عنوانه Pour l’amour de Beyrouth (من "أجل حبّ بيروت") وقد نشرتُ فيه نصاً عنوانه: "العدالة لبيروت!".

- أين كنت يوم وقوع الانفجار؟
كنت في مكتبي في بيروت، وكدتُ أن أفقد الحياة لو لم أخرج من الغرفة حيث كنت جالساً عند حصول الانفجار الأول. ولعلّ تجربة الحرب هي التي أنقذتني إذ تعلّمتُ خلال تلك المرحلة أن أبتعد فوراً عن النوافذ في حال سماع قصف أو انفجار...
- أيّ لبنان تتوقّعه بعد الرابع من آب/ أغسطس؟
كنت أتوقّع ردود فعل حازمة من المسؤولين اللبنانيين الذين راحوا يتراشقون التّهم وينكرون معرفتهم بوجود المواد الخطِرة في مرفأ بيروت، في حين أن المطلوب كان مساعدة الشعب في إعادة بناء الأحياء المنكوبة ودعم الضحايا والتعويض عن الأضرار البشرية والمادية. كما أن العدالة واجب في هذه القضية، لأن من حقّ كل مواطن معرفة الحقيقة!
- ما أهمية الفرنكوفونية بالنسبة إلى لبنان خصوصاً، والعالم العربي عموماً؟
الفرنكوفونية ليست من رواسب الانتداب الفرنسي على لبنان، لأن اللغة الفرنسية كانت تُدرّس في مدارسنا قبل الانتداب وبقيت موجودة ضمن ثقافتنا بعد جلاء القوات الفرنسية وحتى يومنا هذا. الفرنكوفونية هي فرصة للبنان وحاجة لثقافتنا إذ تشكّل جسر عبور بين الشرق والغرب وأداة لحوار الثقافات والتفاعل، ومصدر غنى لثقافتنا التي ستستقي منها ما ينفعها من دون أي إنكار لجذورنا وهويتنا وانتمائنا العربي... وهي المحكيّة في أكثر من 80 بلداً من جانب ثلاثماية مليون شخص في العالم (وهذا الرقم سيتضاعف بفضل الديموغرافية في أفريقيا الفرنكوفونية خلال الثلاثين سنة المقبلة)، وستكون "سلاحاً" إضافياً بيد طلاّبنا إلى جانب اللغتين العربية والإنكليزية، كما أن تعدّد اللغات هذا أظهر فعاليته إذ نجد اللبنانيين يتفوّقون في شتّى المجالات في الخارج بفضل انفتاحهم وتنوّعهم اللغوي والثقافي، علماً أن الانتشار اللبناني كثيف في البلدان الفرنكوفونية حيث يتأقلم اللبناني بسهولة بفضل معرفته للغة البلد المضيف.
أما بالنسبة الى العالم العربي، فالفرنكوفونية موجودة في الجزائر (التي لم تنضم بعدُ إلى المنظّمة الفرنكوفونية لأسباب سياسية) وتونس والمغرب وموريتانيا ومصر، حيث توجد مكتبة سنغور في الإسكندرية، بالإضافة إلى دولتَي قطر والإمارات العربية المتّحدة، حيث توجد جامعة السوربون ومتحف اللوفر، والمنضمتين أخيراً إلى المنظّمة الفرنكوفونية.
- عُرفتَ بغزارة إنتاجك الأدبي، (ثلاثون كتاباً ما عدا القصائد الشعرية) وكأنك لا تفعل في يومك غير الكتابة. ما سرّ هذه الغزارة؟ هل أنتَ حقاً متفرّغ تماماً للكتابة؟ وماذا عن اهتماماتك الأخرى: العائلة، الأصدقاء، الهوايات... هل تجد الوقت لها؟
لقد علّمتني الحرب ألاّ أضيّع الوقت، لأن الحياة قصيرة وهشّة، ومن هنا، أكتب يومياً بعد عودتي من العمل من دون أن أشعر بالإرهاق وكأن الكتابة نوع من "متنفّس" أو جسر عبور إلى عالم آخر... لكنني لا أخلط أبداً بين المهنتين (إذا صحّ اعتبار الكتابة "مهنة") فأخصّص الصباح وبعد الظهر للمحاماة، والمساء للكتابة حيث لا أحد يزعجني إذ يمكنني السهر إذا كنتُ منكبّاً على إنهاء فصل من فصول كتاب. أما سرّ الغزارة فيعود إلى "مهنيّة " أو Savoir-faire يكتسبها الكاتب مع الوقت بفضل خبرته تماماً كما العزف على البيانو. يقول غبريال غارسيا ماركيز، الحائز جائزة نوبل للآداب، إنه يبدأ بتأليف كتاب جديد فور انتهائه من كتابه السابق لئلاّ يفقد المهنية التي اكتسبها! إلاّ أن انكبابي على الكتابة لا يمنعني من الاهتمام بعائلتي، والسفر، ولقاء الأصدقاء، ولعب كرة القدم (وهي هواية أعشقها) والذهاب إلى السينما أو المسرح والاستماع إلى الموسيقى (هذا قبل الكورونا طبعاً!)...

- جسّدت زمن وباء كورونا في رواية أخيرة اسمها La Couronne de Diable, Corona Stories كيف عشت وتعيش هذه الأزمة؟ وكيف سيخرج العالم منها برأيك؟
إنه زمن رهيب، لم يكن متوقّعاً على الإطلاق. نخوض اليوم حرباً حقيقية ضدّ وباء لا نراه ولا نعرف عنه الكثير، رغم انقضاء أكثر من سنة على اكتشافه. أنا قلق من التداعيات الاقتصادية والتربوية والاجتماعية التي سيولّدها هذا الوباء، وبالتأكيد سيخرج عالمنا مختلفاً تماماً عمّا كان عليه في السابق. ولكن "الشاعر أستاذ تفاؤل" كما يقول الكاتب جان جيونو Jean Giono. علينا إذاً أن ندعو إلى التفاؤل والتضامن في وجه هذا العدو، وأن ننتفض أيضاً ضدّ دولتنا التي فشلت فشلاً ذريعاً في إدارة الموجة الثانية من هذه الجائحة!
ومن جهة ثانية، لست من القائلين بأن الجائحة جعلتنا نتقرّب من بعضنا البعض ومن الله أو بأنها "جزاء" أرسله ربّنا لأننا ابتعدنا عنه. فالله محبّة ولا يستعين بوباء فتّاك كي يلقّننا دروساً! غير أنني أعتبر أن هذا الوباء علّمنا التواضع إذ كانت القوى العظمى تتحكّم بالعالم بفوقية إلى أن وجدت نفسها عاجزة كأصغر الدول. كما ستحثّ هذه التجربة المُرّة كل الدول على تغيير سلّم أولويّاتها بحيث تعطي الصحّة العامة والبيئة الأولويّة بعدما كانت تخصّص المليارات للتسلّح والابتكارات الرقمية والتَرَف...
- كتاب ألّفته وندمت عليه؟
لا أندم على أيّ كتاب كتبته لأنني أفكّر مليّاً قبل نشره وأستعين بآراء الأصدقاء وبرأي شقيقتي لمعرفة مدى «نجاحه»، علماً أنني ألّفت كتباً عدّة لم أبادر إلى نشرها وأتلفتها لأنني لم أقتنع بها.
- هل من إصدارات جديدة تُعدّ لها؟
لدي مشاريع عدّة، منها رواية قيد الإعداد ومسرحيّة، إلاّ أنني أراقب الوضع "الكوروني" في العالم آملاً أن ينزاح هذا الكابوس عن الناس، وأن تعود الحياة إلى طبيعتها في كل القطاعات، وخصوصاً منها قطاعات الطبع والنشر والمكتبات...
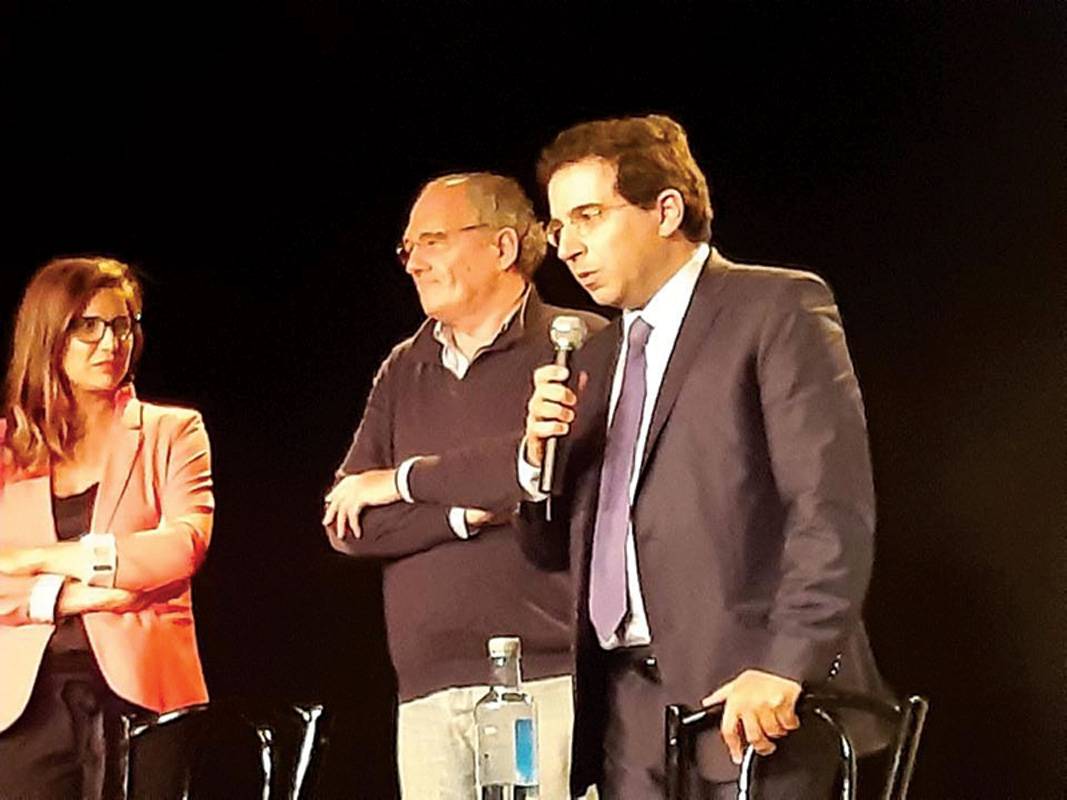
- ما الحكمة التي خرجت بها بعد سنوات من القراءة والكتابة؟
يقول ميشال بوتور: "كل كلمة نكتبها تشكّل انتصاراً على الموت". هذه هي حكمتي في الكتابة! فالحياة ليست صالة انتظار، بل تستدعي الابتكار والخلق لإثبات وجودنا على هذه الأرض!
- كلمة أخيرة...
أدعو جميع القرّاء إلى التسلّح بالصبر والإيمان، لأن الغيوم ستتبدّد حتماً ونعود إلى حياتنا الطبيعية. "كورونا" هي تجربة كتجربة الحرب، علينا المقاومة حتى حلول الهدنة!
شاركالأكثر قراءة

أخبار النجوم
الجمهور يطالب سيلينا غوميز بالانفصال عن زوجها...

أخبار النجوم
سلافة معمار وابنتها في "سعادة المجنون"... شبه مذهل

إطلالات النجوم
كيت موس بإطلالة تكسر القواعد في باريس

عائلات ملكية
كيت ميدلتون تمنح الأمير ويليام إطراءً عفوياً...

إطلالات النجوم
جينيفر لوبيز تتألق بإطلالة مستوحاة من موضة...
المجلة الالكترونية
العدد 1093 | شباط 2026

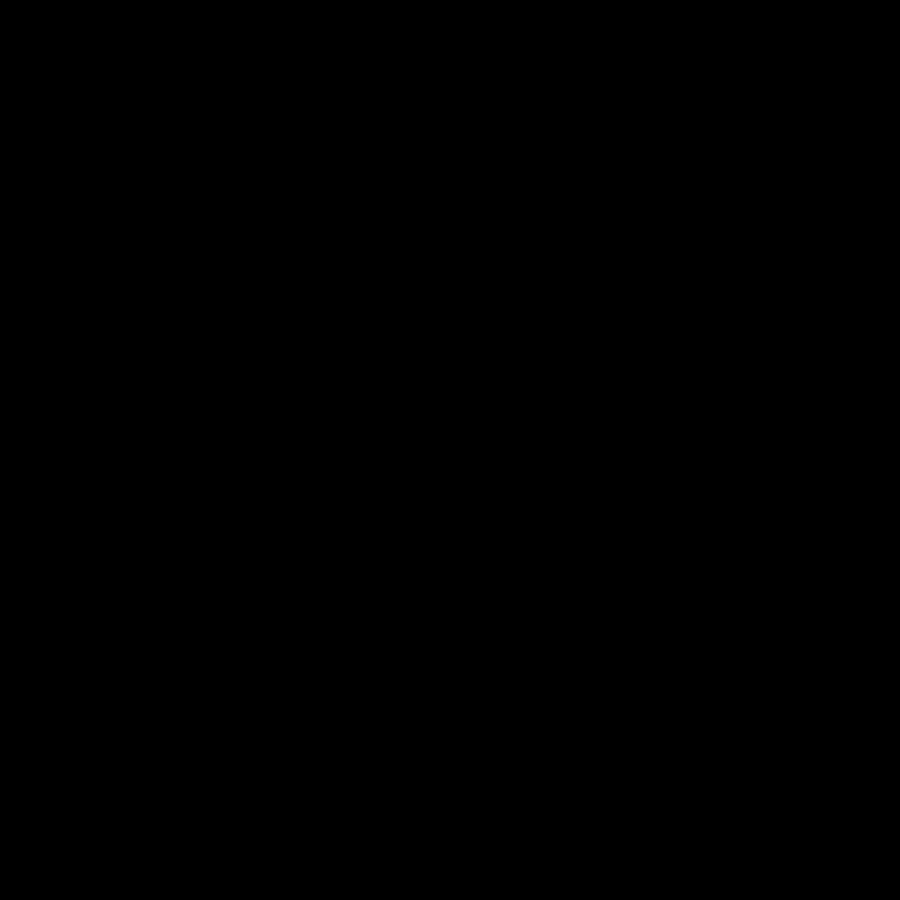
 إشترك
إشترك