نجم في إجازة













إسطنبول هذه المدينة التركية الجميلة التي تجمع سحر الشرق والغرب، زارها الإعلامي في قناة العربية محمد أبو عبيد فأخذته إلى عالم تلاعب ببصره ليدهشه بألوان الحياة فيه، فصال وجال في أحياء المدينة العتيقة وأسواقها وجوامعها وأبحر في مياه مرمرة نحو جزيرة الأميرات واسترخى في مدينة بودروم إلى أقصى الحدود.
في هذه الصفحات يدعونا أبوعبيد إلى التجوال في هذه المدينة كما رأتها عيناه وصوّرتها ذاكرته قبل كاميرته فكتب عنها وقال: إسطنبول مدينة لها سحرها الخاص الذي يجعلها تختلف عن نظيراتها من المدن، وتنفرد بكونها المدينة الوحيدة في العالم التي اقتطفت حصتها من قارتين :آسيا وأوروبا، وإنْ فصَل بين شطريها مضيق البوسفور الجميل بمائه، والخلاب بمنظره، فإن الجسر المعلق يبقي اللحمة بين شطري المدينة البديعة.
في هذه المساحة الورقية التي منحتني إياها مجلة «لها» للتحدّث عن إحدى رحلاتي، لن ألج في تاريخ المدينة الحافل بالأحداث والمشوق. سأترك الأمر إلى مِعْول (غوغل) حيث يمكن للباحث عن تاريخ المدينة أن (يغوغله)، لكني في هذا المقام سأتقدم إلى القارئ بانطباعات السائح العادي، لا الرحالة المؤرخ.
كنت أسابق الزمن وأنا أتجول في أرجاء المدينة الشاسعة المرامي، فما بين طرفة عين وانتباهاتها، يجذبك منظر خلاب، ومبنى جديد أو آخر قد شاب.
فتلك المدينة تعبق بتفاصيل الماضي، وتتعطر بتقاسيم الحاضر، وكله ينبئك بشكل المستقبل. عن اليمين قصة وعن اليسار قصة.
تارة أنا في آسيا بنمط حياتها وملامح أحيائها (اقصد البشر لا الحارات)، وتارة أخرى أنا في أوروبا بشكلها ومضمونها وانفتاحها، فاسطنبول هي المدينة التي اختصرت قارتين في شطرين.
وفيها ترى الناس من كل الأجناس، هذا ما تختزله ساحة تقسيم في المدينة، وخصوصاً شارع الاستقلال الذي لا يعرف سُباتا، حيث السياح تتلامس أكتافهم لكثرتهم منذ أنِ الليلُ عسعس حتى إذا النهار تنفس.
تنطلق الحافلة السياحية في رحلتها اليومية. هنا، لا بد من التأكد من جهوزية الكاميرا التي ستحتفظ بالذكريات في مكان مثل إسطنبول...
وحيث الحافلة تسير، والمرشدة السياحية تشرح ما نراه على الجنبات، ترى من أفق، ليس ببعيد، ذلك الصرح الذي طالما رأيته في الصور.
إنه قصر الباب العالي (توبكابي) الذي كان مركز الحكم في الدولة العثمانية، وظل قصراً للسلاطين وحاشياتهم وزوجاتهم وأهليهم، وأيضاً مقراً رسميا لاستقبال الضيوف والزوار، وما إنْ ظننتُ أن عينيّ قد رويتا من جماليات هذا القصر، حتى رأيتهما متعطشتين للارتواء من قصر دولمه بهجه أحد أفخم القصور العثمانية المتربع على الضفة الأوروبية من البوسفور، والذي بني بين عامي ١٨٤٢ و١٨٥٣. ثم قلت يا عينُ مهلا ً لا تشبعي... في إسطنبول لا تشبع العين وفيها ما يستحق النظر..
وكيف تكتفي والمسجد الأزرق له ما يقصه على زائريه، إنه المسجد الذي بناه السلطان أحمد، قرب الكنيسة الشهيرة (آيا صوفيا) المبنية على الطراز «البازيليكي» والتي تحولت مسجداً ثم متحفاً جمع الصرحيْن معا بالعمارة البيزنطية والزخرفة العثمانية.
اللافت أن الامبراطور جوستنيان، الذي بنى الكنيسة على أنقاض كنيسة أقدم بناها الإمبراطور قسطنطين والتهمتها نيران الشغب، من شدة إعجابه بروعة المعمار، لم يشأ أن يطلق عليها أيا من أسماء القديسين، بل سماها «الحكمة الإلهية أو المقدسة» ( آيا صوفيا).
للبحر حكاياته ولو بمضيقه، لكن المضيق فسيح يسيح المرء بطوله. فهو الرحب بقصصه الغني بمناظره.
كنت أتلفت ذات اليمن وذات اليسار متبوئا مكاني على المركب الذي يتلذذ بسادية الماء الذي يلطمه، وأرى الخضرة كست ضفتي البوسفور، تتغلغل فيها تلك البيوت الجميلة، حتى تمنيت لو امتلكت أحدها، لعله ينسيني هموم العيش ومشقته لولا قلة المال. وقبل المغيب، بعد أن انتهت الرحلة البوسفورية، رحت ارتشف قهوتي المفضلة في مكان تتجلى فيه جمالية مغيب الشمس، المتمازجة بروعة البوسفور حيث الجسر المعلق يغنيك عن التعليق. فالشمس حينها لا تقول وداعاً، بل إلى لقاء يتجدد.
في مطاعم المدينة التي لا تُحصى، استطيبت المذاق التركي الأصيل الذي ترك أثراً في مأكولاتنا العربية بل وأورثنا بعض أسمائه. وأيضا استعذبت الطبق الغربي، ولا عجب في ذلك ما دمت قي قارتين. وإذا ما أرخى الليل سدوله، كان عليّ أن أستلّ النصائح من الدارِين بحياة الليل الاسطنبولي، فما أكثر الأماكن وما أكثر الفاعليات، فيجب أن اختار حيث الليالي معدودات.
في أحد المطاعم الذي لا يكتفي بوجباته اللذيذة، إنما يقدم فاعليات تصور الفولكلور الشعبي إضافة إلى الفن العصري، كان لافتاً وضع العلم التركي على الطاولة، إلى جانب علم الدولة التي ينتمي إليها السائح، لفتة تركت أثرا طيباً في نفسي.
جزيرة «الأميرات»، كيف لي أن أسمع عنها ولا أشق عباب البحر صوبها! الجزيرة التي يسميها الأتراك بيوك آضه، وكانت منفى الأميرات خلال الحكم البيزنطي، اختطفت مني نهارا كاملا ً.
انطلق المركب متحدياً أمواج مرمرة، وعلى متنه أكثر من ألف سائح، هو مركب من عشرات المراكب التي تنطلق إلى الجزيرة يومياً. على مدى قرابة خمسين دقيقة ليس للعين إلا أن تتمتع بما ترى. في الجزيرة حيث لا سيارة، تمتطي العربة التي وقعت مهمة جرها على حصان أو اثنين، وتصول في أرجاء الجزيرة التي تلفها الأشجار الشاهقة، وتفتنك مناظر البيوت الجذابة.
ثم نقت ضفادع بطني، حينها لا أطيب من وجبة سمك بالطريقة التركية على شاطئ البحر. شحنت نفسي من جديد واستأجرت الدراجة الهوائية لأسيح في شوارع الجزيرة الضيقة وأزقتها قبل أن ينادي مناد ٍ أن استعدوا للإياب إلى أسطنبول. ولأني من عشاق البحر والتسمر(البرونزاج) أيقنت أن إسطنبول ليس المكان الأمثل لذلك رغم كل ما تتمتع به (عمر الزين ما اكتمل) وذلك ليس عيباً منها، إنما من بحرها مرمره، فكان أمامي أن أختار بين المتوسط أو بحر إيجه، ولأن المتوسط لنا منه نصيب، آثرتُ بحر إيجه متجها صوب مدينة بودروم الهادئة الوديعة التي تبرأتْ من صخب المدن وضجيجها. هناك كان لا شغل لي سوى مصاحبة الشمس بعد شروقها بسويعات وحتى ما قبل غروبها متلذذا بمياه البحر، وخيالي شارد في عظمة الخالق وما أبدعه من بحر ويابسة، وكنت لا أبالي بأشعة الشمس وهي تلسعني ما دام كان ذلك مقصدي.
شاركالأكثر قراءة

إطلالات النجوم
أكثر الإطلالات جرأة على السجادة الحمراء في حفل...

إطلالات النجوم
سيرين عبد النور تتألق في العراق بفستان مجسم...

إطلالات النجوم
نانسي عجرم تحيّر الجمهور بإطلالتها.. عصرية أم...

أخبار النجوم
سعاد عبدالله تزور حياة الفهد رغم الخلافات...

إطلالات النجوم
كيم كارداشيان تختار الأسود في إطلالتين: بودي...
المجلة الالكترونية
العدد 1092 | كانون الثاني 2026

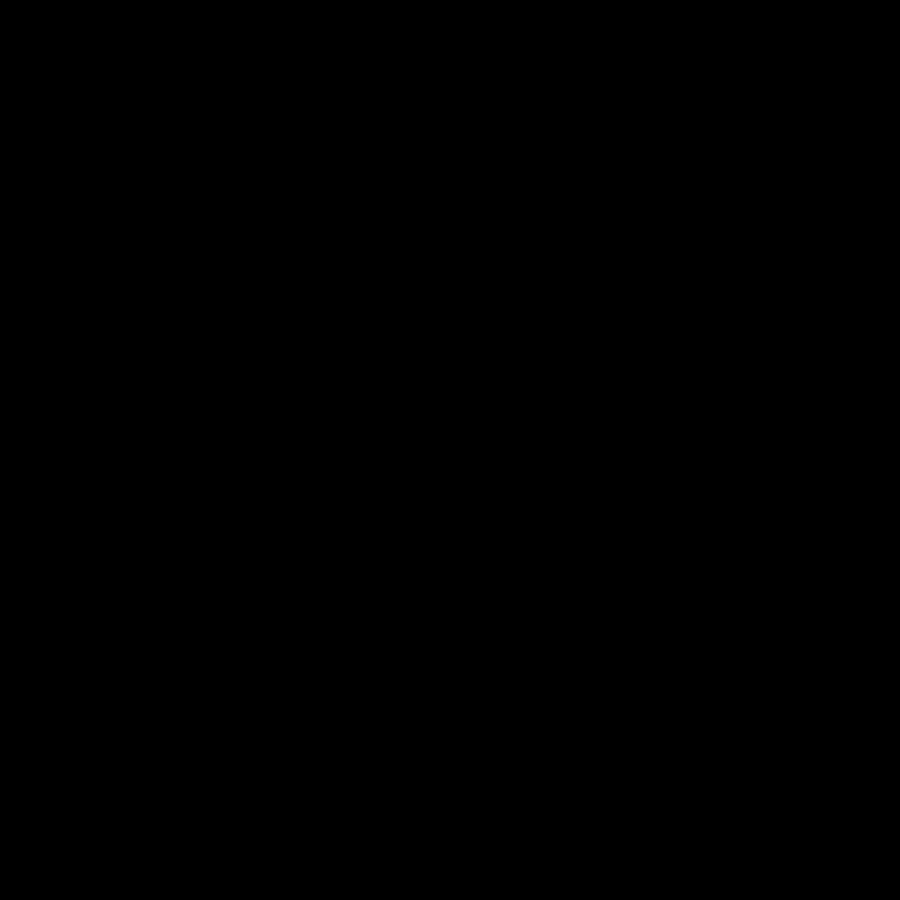
 إشترك
إشترك












