خاتون سلمى

«كتبت، لمعت، ابتعدت...» هذه هي باختصار خاتون سلمى التي سرقت الأضواء منذ كانت في السادسة عشرة من عمرها عندما فازت في برنامج «استوديو الفن» عن فئة الشعر، ومن ثمّ عملت وكتبت في أكثر من صحيفة وظلّ اسمها يدلّ على شاعرة استوقفت بموهبتها القرّاء والنقّاد قبل أن تنشر أيّ ديوان. وبعدما غابت فترة طويلة عن الأوساط الثقافية عادت خاتون سلمى في ديوان هو الأول لها بعنوان «عانقت امرأة تنتظر»... عن هذا الديوان وسبب ابتعادها رغم الموهبة التي تمتلكها والنجاح الذي حصدته في سنّ مبكرة، وعن هاجس الوقت الذي يسكن قصائدها وأسلوبها الشعري كان هذا الحوار.
- «عانقت إمرأة تنتظر»... عنوان يُغري بالإبحار خصوصاً أنّك المرأة التي كتبت باكراً وانتظرت كثيراً قبل أن تصدر باكورة أعمالها الشعرية. فهل المرأة المنتظرة المقصودة في العنوان هي أنت؟
فعل الإنتظار هو بحدّ ذاته فعل شمولي ينطلق من الخاص إلى العام ليجمع كلّ الناس الذين يعيشون هذه الحالة منذ الولادة حتى لحظة الموت، وقد يكون الانتظار وعد الغد الدائم. لقد اخترت هذا العنوان من جملة عناوين وضعتها لأنني وجدت فيه قدرة على إيصال معنى يُشبهني وقد يُشبه كلّ قارئ لهذا الديوان. «عانقت إمرأة تنتظر» ليس مجرّد عنوان يُحاكي الشاعرة خاتون سلمى لأنني ذهبت من خلاله من الذات إلى العام وأردت أن يكون هذا العنوان مرآة لي ولكلّ من يقرأه. أمّا تخصيص المرأة في العنوان فله أكثر من هدف يأتي في طليعتها التأكيد أنّ المرأة هي الكائن الأكثر «انتظاراً» في هذا العالم، فهي في طبيعتها عاطفية وقلقة وتهتم بالتفاصيل، لذلك نجدها في حالة ترقّب وانتظار لكلّ الأمور سواء كانت مهمّة أو روتينية. وأنا عرفت معنى الإنتظار منذ الطفولة حين اضطرتني الظروف لكي أركب الطائرة برعاية إمرأة لا أعرفها بانتظار عودة الأم بعد شهور. إن هذا الشعور بالخوف والقلق كان مفتاحاً لهذه الحياة التي لا يمكن أن أعيشها إلاّ وأنا أنتظر.
- «لخوفي ممّا كتبته/ لخوفي ممّا لم أكتبه بعد»... هل هذه الجملة التي ذكرتها في ديوانك هي لتبرير التأخير والتأكيد على أنّ انتظارك طويلاً قبل مرحلة النشر كان سببه الخوف والقلق؟
في الواقع، نشر الشعر ليس الفصل في العملية لأنني عشت وأعيش حياتي قصيدة لم تنشر. لقد عرفت ازدواجية صعبة جعلتني أسيرة إحساسي بالضياع بين أن أكون شاعرة وألاّ أنشر. أمّا الخوف فهو شعور انتابني واستمرّ معي بعد دخولي المعترك الثقافي في سنّ مبكرة إثر فوزي ببرنامج «استوديو الفن» عن فئة الشعر. عندها عرفت الشهرة وأخذ اسمي ينتشر رغم عدم اكتمال التجربة، وأدركت بالحدس الفطري خطورة هذا الأمر، فابتعدت. ومن ثمّ دخلت الجامعة ودرست الأدب العربي وفي هذه المرحلة ازداد خوفي، وبت ناقدة لما أكتب، وخائفة ممّا سأنشره وما إذا كان سيرتقي إلى المستوى المُنتظر منّي. ورغم الشهادات وعبارات الدعم التي كنت أسمعها من أساتذتي وكبار الصحافيين والنقّاد أمثال الشاعر خليل حاوي والناقد الأدبي محيي الدين صبحي، فإنّ الخوف الذي عبّرت عنه في ديواني الأخير من خلال «لخوفي ممّا كتبته/ لخوفي ممّا لم أكتبه بعد» كان السبب الرئيسي وراء التأخّر في عملية النشر، هذا إلى جانب مسؤولية الزواج والأمومة ووقوع الحرب التي توالدت عنها حروب ألهتنا عن إدراك أحلامنا، وما إلى هنالك من ظروف ساهمت في التريث والتأخّر في نشر القصائد التي كتبتها في فترات متفاوتة، وربما كنت أنا المسؤولة أولاً وآخرًا!
- هل تُسمّين هذا الشعور خوفاً كبديل عن عدم الثقة في ما تكتبين؟
لا إنّه شعور أكيد بالخوف نتيجة ما أسمّيه «لاقط الجديّة» الذي يطبع شخصيتي ويجعلني دائماً أمام نقد ذاتي عنيف لا يرضى إلاّ بالأفضل، وهذا الشعور لم تمحه الأيام ولا الخبرة والنضج أو اكتمال التجربة ولا كلّ الشهادات الداعمة.
- ولماذا اخترت اللحظة الراهنة لنشر قصائد كتبت معظمها في زمان آخر؟
أنا لم أختر اللحظة بل هي التي اختارت توقيت النشر، فالقصائد كُتبت في تواريخ مختلفة. إلاّ أنني آثرت عدم تحديد تاريخ كلّ قصيدة حتى لا تكون محصورة في وقت معيّن لأنّني أؤمن بأنّ الكلمة التي أكتبها - وإن كانت وليدة لحظة معينة- يجب أن تتخطّى حدود أي زمان ومكان لتدخل عالم الشعر وجغرافيته وتاريخه فقط لا غير. وربما كان تشجيع أولادي لي هو ما قد أثر بي بالدرجة الأولى، إذ أنهم طالما استغربوا موقفي من عدم النشر خصوصاً أنهم تربّوا وهم يرون في منزلي كبار النقّاد والشعراء ويقرأون إهداءات كبار الأدباء لي والتي قد تؤكد أنني أملك بعض دهشة الشعر. كذلك ساهمت مجموعة من صديقاتي في زرع القوّة في نفسي للإقدام على نشر قصائدي، وهكذا نشرت دون أن أفكر في النتيجة وما إذا كان سيلاقي صدىً إيجابياً أم لا.
- هل الإزدواجية التي اختبرتها بين عالمي «الشعر» و«اللاشعر» جعلتك تعيشين معنى الضياع مما دفعك نحو عالم من العزلة أو ما يُشبه التنسّك الشعري؟
لا لم أعش العزلة لأنني كما قلت لك حياتي كلّها زاولتها كشعر وما زلت أعيش حياتي كقصيدة، كما أنّ الإزدواجية لم أعرفها بمعناها السلبي لأنني لم أفصل بين حياتي كشاعرة وإنسانة. فنحن من نحن، بمن جئنا منهم نحمل جيناتهم ومن نعود إليهم مع إضافة ما خبرناه. إنه توازن متقن بين ما جئنا عليه وما قد نغادر به.
- هل تعتقدين أنّ عدم الفصل بين حياتك كشاعرة وإنسانة كان السبب في الثنائية التي تحملها عباراتك الشعرية التي تغوص أحياناً في التفاصيل وتنطلق في أحيان أخرى صوب المواضيع الكبرى كالحياة والموت والعشق والحرب والإنسان؟
لا أعتقد وإنما أجزم بصحّة ما تقولينه، ففي بعض القصائد أظهر كشاعرة من لحم ودم تتفاعل مع كلّ ما يحيط بها من أشياء على مستوى الحالة العضوية والتجربة الحسيّة المعاشة، وهذا ما قد أسميه الإحساس بفضائي الذي يتكاثف حولي، وفي الوقت نفسه رصد الحياة بكل ما فيها على مستوى الحسّ والقكر. أمّا هذه الثنائية التي لفتت معظم الذين قرأوا الديوان قراءةً، من المفترض أنها نقدية، دفعت البعض إلى حدّ الإحساس بأنّ هناك مزاجين متناقضين عملا على إنجاز القصيدة الواحدة، ولكني أنتهز الفرصة هنا لأقول إنّ في هذين المزاجين تكاملاً لا تناقضاً. وهما حقيقة تحاكي أحوال التجربة المعاشة. فمثلاً، لماذا لم أقل « طرحت السحاب عن وجهي» بدلاً من « على وجهي»، ببساطة لأن استبدال حرف جرٍ بآخر يعني استبدال امرأةٍ بأخرى. وأنا حريصة على أن أكون أنا.
- البعض يرى في «التفاصيل» التي تُشكّل ثيمة بالنسبة إلى شعراء قصيدة النثر مجرّد كلمات يتخفّى وراءها كتّابها ليخفوا ضعف موهبتهم الشعرية. فما رأيك؟
ليس بالضرورة أن يُفسّر الأمر على هذا النحو، لأنّه إذا كان البعض يستخدم التفاصيل والكلمات البسيطة ليصفّها جنباً إلى جنب ويقوم بالتالي ببناء قصيدة تافهة فهذا الأمر سيظهر بوضوح لأنّ قارئ الشعر ليس قارئاً عادياً أو ساذجاً، وهو قادر على التمييز بين التعبير الجيّد والرديء سواء كان الشاعر يتحدّث عن المواضيع الكونية الكبرى أو التفاصيل اليومية الصغيرة. وأنا شخصياً عندما اعتمدت في بعض القصائد تفاصيل معينة لم تكن موجودة في الأصل سوى لخدمة الموضوعات الكبرى، هذا لأنني على ثقة بأنّ التفاصيل تُضفي الكثير من المعاني القويّة والعميقة إذا استُخدمت في سياق ذكي يقودنا نحو مواطن أجمل وأهم، تقودنا إلى ذواتنا حيث الفضاء الأرحب العامر بحقيقتنا الإنسانية بكل ما تختزنه من قدرة على إبراز المؤلم وإخفاء المفرح!
- يبحث الشاعر عادة عن الحكمة في معانيه، إلاّ أنّ قصائدك تمحو إلى حدّ ما كل شكل من أشكال الحكمة لتُبشّر بالخيال والجنون أحياناً عبر استخدام صور تتجاوز حدود العقل والنُظم المعروفة. فهل تمضين من خلال ذلك في اتجاه صنع اسطورة ما؟
لا أرى أنّ دور الشاعر يكمن في أن يكون حكيماً وإنما في أن يكون قادراً على إيصال فكرته بأسلوب يتمازج فيه الذكاء والرقيّ. وأنا من الأشخاص الذين يستهويهم المناخ الروحاني والأسطوري وهذا ينعكس حتماً على كتاباتي، لذلك أجدني في حالة بحث، دون قصد، عن الخارق الذي الذي قد يحتمل أكبر قدرًا ممكنًا من العبير. لذا كانت تحضرني صور وشخصيات أسطورية تعيش في موروثنا الفكري والثقافي وتحمل في باطنها الكثير من القيم والأفكار وتستطيع أن توصل التعبير عبر أقصر الطرق، مثل «سندريللا» و«الشاطر حسن»... أمّا جوّ الجنون والخيال الذي تقصدينه والذي استشعرته ربما من خلال صور كثيرة مثل «أعلو على مكانس الساحرات» أو «أسترجع من أفواه السمك قبلات» وغيرها، فهو ليس مجرّد حالات تبّث الجنون والتهويل، وإنما صور اخترقت النص بإلحاح ورسمت لى المشهد كاملاً، وهذا عنصر إغراء لكل شاعر.
- يُشكّل الوقت ثيمة أساسية في ديوانك إذ لا نجده داخل القصيدة فحسب بل إنّه يحتلّ حيّزاً مهماً في عناوين القصائد مثل: «هي والعالم هذا المساء»، «نجمة لم تولد بعد»، «أهداب الزمن»، «عن بنفسج الغسق»... فهل تعيشين فعلاً هاجس الوقت؟
الوقت هاجس بالنسبة إليّ وإلى كلّ إنسان طبيعي، لكن الشاعر قادر من خلال جملته الشعرية أن يُعبّر عن هذا الهاجس ليجعله قهره الحقيقي ومطية حزنه الدفين.
- تكرّرين في قصيدتك «هي والعالم هذا المساء» عبارة «الزمن اللئيم». فما تاريخ هذه القصيدة؟ وأيّ زمن تقصدين؟
قد تكون هذه القصيدة هي الأقدم بين قصائد الديوان إذ كتبتها عام ١٩٨٣ عندما كنت موجودة في منطقة صور الجنوبية، وشاءت الظروف أن أبقى لفترة معينة في هذه المنطقة التي كانت تخضع للإحتلال الإسرائيلي. ونتيجة هذا الإعتقال النفسي والروحي والجسدي أيضاً الذي كان يعيشه أهالي الجنوب اللبناني جرّاء الإحتلال الغاصب كتبت القصيدة وعبّرت عن شعوري حيال هذا الواقع الأليم بعبارة «معتقل الزمن اللئيم» التي تكرّرت كما اللازمة في قصيدة «هي والعالم هذا المساء».
- هل انتهى عهد ذاك الزمن اللئيم؟
لا، وربما يكون الغد أكثر لؤماً وشراسة، ليس في مكان معين وإنما في العالم كلّه، ألا تشعرين به؟
- المساحات البيضاء تطغى على الديوان وكأنّك ترتأين التعبير بالقليل عمّا هو كثير... صحيح؟
أعتقد أنّ هناك تواطؤاً ما بين الشاعر والقارئ، وفي قراءة الشعر ثمّة ما يُشبه لعبة «الشدّ والرخي»، بمعنى أنّ الشاعر يحب أن يُخرج كلّ ما في داخله إلى القارئ، و في الوقت نفسه، يحب القارئ أن يدخل في تلك اللعبة ليكتشف وحده ما الذي يُريد الشاعر قوله. وفي أغلب الأحيان قد يخرج القارئ بفهمٍ محملاً بما في ذاته هو. وهذا أجمل وأخطر ما في هذه العلاقة بينهما. إن طول النص أو قصره لا يقلل من شأن تلك العلاقة في حال نشأت، بل عدم القدرة على العلاقة هي المشكلة. لذلك أراني أؤثر المساحات البيضاء في القصيدة لأنها تترك للمتلقّي هامشاً من الحرية للتفكير في الطريقة التي يُريد أن يبني علاقته بالنص بعيداً عن إملاءات الشاعر.
- من هو الشاعر الذي تجدين في قصيدته انعكاساً لعالمك الشعري؟
لن أسمّي وأردّد أسماء شعراء كبار حفظنا قصائدهم وأبياتهم عن ظهر قلب. فلدى كلّ شاعر قد أجد شيئاً يجذبني أو يشبهني، ولكن، وعلى سبيل المثال، في كلّ مرّة أقرأ فيها شعر حسن عبدالله أرى نفسي أدخل في عالم خاص لا يشبه أيّ عالم آخر. وكذلك أحبّ من الجيل الجديد شعر سوزان عليوان وخصوصاً ديوانها الأخير «كلّ الطرق تؤدّي إلى صلاح سالم». أذكرهما لأنهما في خاطر رغبتي لقراءة الشعر هذه الأيام. فلنجتمع بعد فترة وأخبرك عن آخرين قد يكونوا رفاق زمن قراءة أخرى!
شارك
الأكثر قراءة

أخبار النجوم
الجمهور يطالب سيلينا غوميز بالانفصال عن زوجها...

أخبار النجوم
سلافة معمار وابنتها في "سعادة المجنون"... شبه مذهل

إطلالات النجوم
كيت موس بإطلالة تكسر القواعد في باريس

عائلات ملكية
كيت ميدلتون تمنح الأمير ويليام إطراءً عفوياً...

إطلالات النجوم
جينيفر لوبيز تتألق بإطلالة مستوحاة من موضة...
المجلة الالكترونية
العدد 1093 | شباط 2026

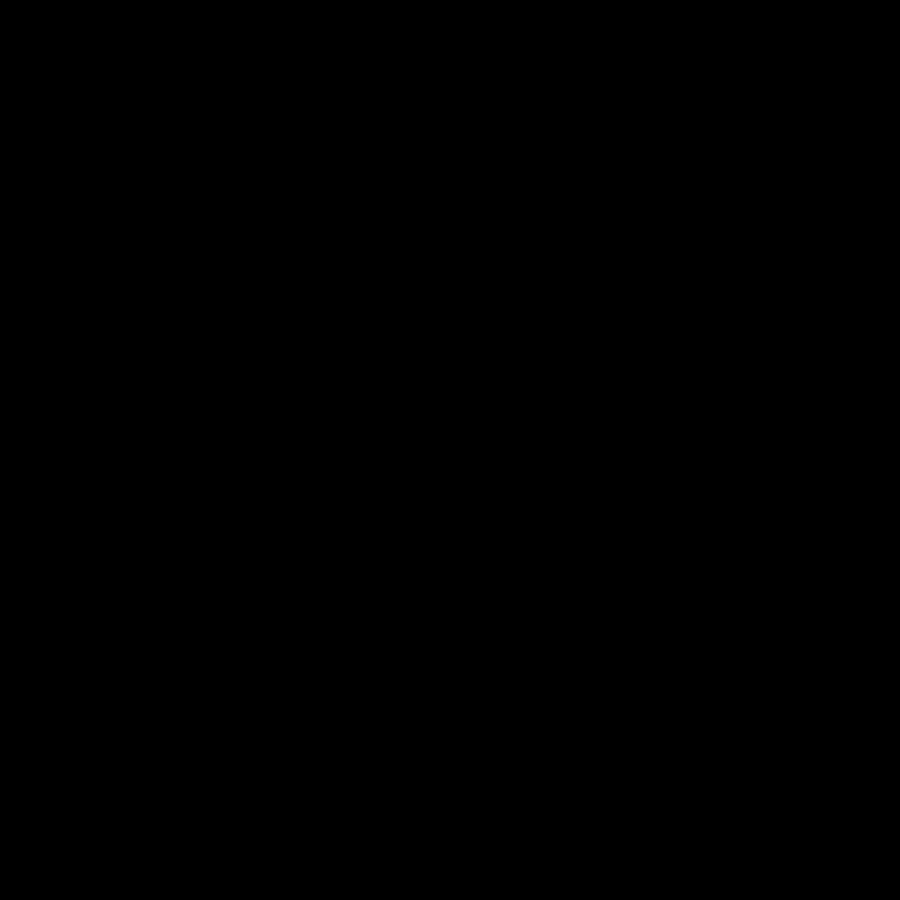
 إشترك
إشترك












