“السترات الصفراء” من فرنسا وصولاً إلى بلادنا... “المرأة نصف التحركات”






بشعر مرفوع ووجوه غاضبة، سراويل جينز وقمصان ملوّنة وحقائب على الظهر، هكذا تسير عشرات النساء في فرنسا ضمن التحركات التي باتت تعرف بـ”السترات الصفراء” للمطالبة بحقوقهن وبتخفيف الهوّة المعيشية الحاصلة، كما في غالبية الدول الأوروبية، بين المواطنين الفقراء والأثرياء.
بعد الأسبوع السادس على التظاهرات أو “الثورة الفرنسية” كما يحلو للبعض تسميتها، لفتتني أعداد النساء المشاركات، والتي إن لم نقل إنها تفوق فهي تعادل عدد الرجال. نراهن واقفات بقربهم بإصرار ويواجهن بكل عزيمة القنابل المسيلة للدموع بالشالات الصوفية وبدموعهن للوصول الى العدالة الاجتماعية التي يحلمن بها.
ففي مرسيليا، مكان إقامتي الحالية، تنزل كل سبت آلاف النساء من مختلف الأعمار والمستويات الاجتماعية والتعليمية، ويقفن بستراتهن الصفراء في المقدمة، ويحملن بدون خوف اللافتات الكبيرة والشعارات الموجّهة بشكل مباشر إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وحكومته. وهنّ أول من يسارع إلى الردّ على أسئلة الصحافيين، فيطالبن بالمساواة في الدخل بين المواطنين وبرفع القدرة الشرائية وخفض الضرائب. ويفعلن كل ذلك انطلاقاً من قناعة ومن عاطفة وحب ومن شعور بالقلق ليس على حاضرهن فحسب، بل أيضاً على مستقبل أولادهن حتى قبل مجيئهم إلى الحياة.
ولعبت وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي دوراً أساسياً في انتقال عدوى “السترات الصفراء” ليس فقط إلى بعض الدول الغربية، بل إلى الدول العربية، ولا سيما لبنان الذي قرر مواطنوه الانضمام إلى هذه الحركة وإعلاء صوت المطالب في وجه فساد الطبقة السياسية الحاكمة. وكالعادة ظهرت غلبة النساء بالعدد على الرجال.
ففي لبنان، ورغم أن المرأة تهيمن على أغلب قطاعات سوق العمل، كالصحافة بكامل مجالاتها، المكتوبة والمسموعة والالكترونية، ومع أنها باتت تسيطر على ما لا يقل عن 70 في المئة من مجمل العاملين في هذا القطاع، إلا أنها لا تزال، كما في سائر بلداننا العربية مستثناة من الكثير من المناصب السياسية والقيادية التي يفرض فيها الرجال هيمنةً محسومةً غير قابلة لأي تغيير في الوقت الراهن.
وبعد تظاهرات “طلعت ريحتكم” في العام 2015 وما رافقها من انتهاكات واعتداءات بحق المتظاهرات، عادت النساء في لبنان إلى التحرك بدافع مطلبي وعاطفي أيضاً لحماية مستقبل أولادهن، فنزلن إلى شوارع بيروت وارتدين الملابس “الكاجوال” وحملن اللافتات وكنّ الأكثر صخباً وتحركاً أمام الكاميرات لإعلاء الصوت الرافض لحالة الفساد وتردّي الأوضاع المعيشية والانهيار السياسي المترافق مع انتشار الأمراض ووفاة الأطفال أمام أبواب المستشفيات، مثل آية الديراني ومحمد وهبي، بسبب غياب الرعاية الصحية المجانية وعدم قدرة أهالي المرضى على دفع المبالغ المترتبة على العلاج.
ولا عجب، ففاتورة الاستشفاء في لبنان تصل إلى 250 مليون دولار سنوياً، وهي الأعلى في المنطقة، وذلك بسبب غياب الرقابة والمحاسبة، وعدم تطبيق اتفاقية أُبرمت بين وزارة الصحة والمستشفيات الخاصة، والتي تنص على استقبال أي مريض والتثبت من وضعه الصحي قبل سؤاله عن وضعه المادي أو نوع التغطية التأمينية التي يمتلكها، الأمر الذي أشعل الشارع اللبناني من جديد.
وفي مصر، سبقت النساء المصريات النساء الفرنسيات في النزول إلى الشارع، فلعبن دوراً أساسياً خلال ثورة يناير 2011، وحضرن في كل الميادين العامة وسُمع صدى صرخاتهن في كل الساحات. وقد نجحن في إحداث تغييرات جذرية في البنية السياسية والمجتمعية المصرية. لكن كانت النتيجة مقتل 133 شابة بالرصاص الحيّ و76 حالة أخرى إما نتيجة الإهمال الطبي في السجون أو جراء حوادث سير مفتعلة أمام السجون خلال زيارة ذويهن.
كذلك شهدت الفترة بين آب/أغسطس 2013 ونهاية كانون الأول/ديسمبر 2017 اعتقال 2500 امرأة تحت مسمى “معتقلة سياسية”. ولا يزال بعضهن يقبعن خلف القضبان بالتّهمة نفسها، وذلك وفقاً لتقرير التنسيقية المصرية للحقوق والحريات عن حالة حقوق الإنسان لعام 2017.
وما زالت المرأة المصرية تناضل حتى اليوم من أجل العيش بكرامة في وجه الأزمات الاقتصادية والسياسية وارتفاع الأسعار وصعوبة تأمين الحاجات الأساسية لأسرتها وانتشار البطالة. فتراها حاضرة ومتمكنة، تقبض على زناد حماية أطفالها أيضاً وتنتظر انطلاق الشرارة الأولى لأي ثورة جديدة قد تحصل لتكون أول المشاركين.
أما في سوريا، فكانت المرأة نصف “الثورة”، حيث شاركت في تظاهرات العام 2011 وهتفت مع الشبان للحرية والعدالة وتعرضت للاعتقال. ويقدّر عدد المعتقلات في السجون السورية منذ بداية الحرب بنحو 8 آلاف و633 سيدة. وهن يتحمّلن الاعتقال مع كل ما يرافقه من اعتداءات واغتصاب وانتهاكات لأبسط حقوقهن.
ورغم الهدوء النسبي الذي باتت تشهده الأراضي السورية، إلا أن دور المرأة لا يزال الأساس، فهي من يحتوي ويحمي من العوز في الداخل، وهي من يعالج المآسي المترتبة على اللجوء والتهجير والإقامة في المخيمات في الخارج. هذا ناهيك عن مشاركة آلاف الفتيات والنساء الكرديات السوريات في صراعهن الطويل مع تنظيم “داعش” في وحداتٍ عسكرية تدعى وحدات حماية المرأة YPJ . وهؤلاء كان لهن الدور الأكبر مع انتشار صورهن على “السوشيال ميديا” في المعارك وهن يربطن شعورهن جدائل ويحملن “الكلاشنيكوف” غير آبهات لشيء إلا الدفاع عن أنفسهن وعن عائلاتهن.
ودور المرأة الفلسطينية لا يختلف عن باقي النساء، فالفلسطينيات يدافعن عن أراضيهن بالحجارة والأسلحة البيضاء ويتحمّلن التعذيب في المعتقلات الإسرائيلية. وقد وصل عدد المحتجزات إدارياً إلى أكثر من 60 فلسطينية، بينهن 22 أسيرة يقبعن في سجن “هشارون” و14 أسيرة في معتقل “الدامون”. وهناك أكثر من 7 قاصرات، كان أبرزهن عهد التميمي التي أصبحت مثالاً للمقاومة الفلسطينية بعد اعتقالها مباشرة.
إذاً، يبدو أن الحال في العالمين العربي والغربي هو نفسه، والتحركات المطلبية المقبلة والثورات المحتملة مع سرعة المشاكل السياسية والاقتصادية والمعيشية ستفرض على النساء التحرك، فلن يستيقظن في الصباح لشرب فنجان النسكافيه بهدوء على الشرفة، ولن يقفن نصف ساعة أمام المرآة لتصفيف شعرهن ووضع الماكياج، ولن يشعرن بالحيرة لساعات قبل اختيار ملابسهن، وسيكنّ دائماً جاهزات للنزول إلى الشارع ورفع الصوت كالرجال.
شاركالأكثر قراءة

مشاهير العرب
عمرو أديب يعلق على الضجة الحاصلة بشأن حياته...

إطلالات النجوم
نانسي عجرم تنسق إطلالتها قي الرياض بحقيبة صغيرة...

إطلالات النجوم
مريم أوزيرلي أنيقة بإطلالة من توقيع خالد ومروان

إطلالات النجوم
ليندسي لوهان تختار الفستان الأسود القصير في...

إطلالات المشاهير
الملكة رانيا العبدالله… عندما تلتقي العصرية...
المجلة الالكترونية
العدد 1092 | كانون الثاني 2026


شؤون المرأة
مراسلة حربية وطبيبة وممرضة.. أمهات يتحدّين ظروف أعمالهن الصعبة من أجل أطفالهن

شؤون المرأة
مؤثّرات جمال عربيات تساهمن في ابتكار اتجاهات جديدة للموضة والمكياج

شؤون المرأة
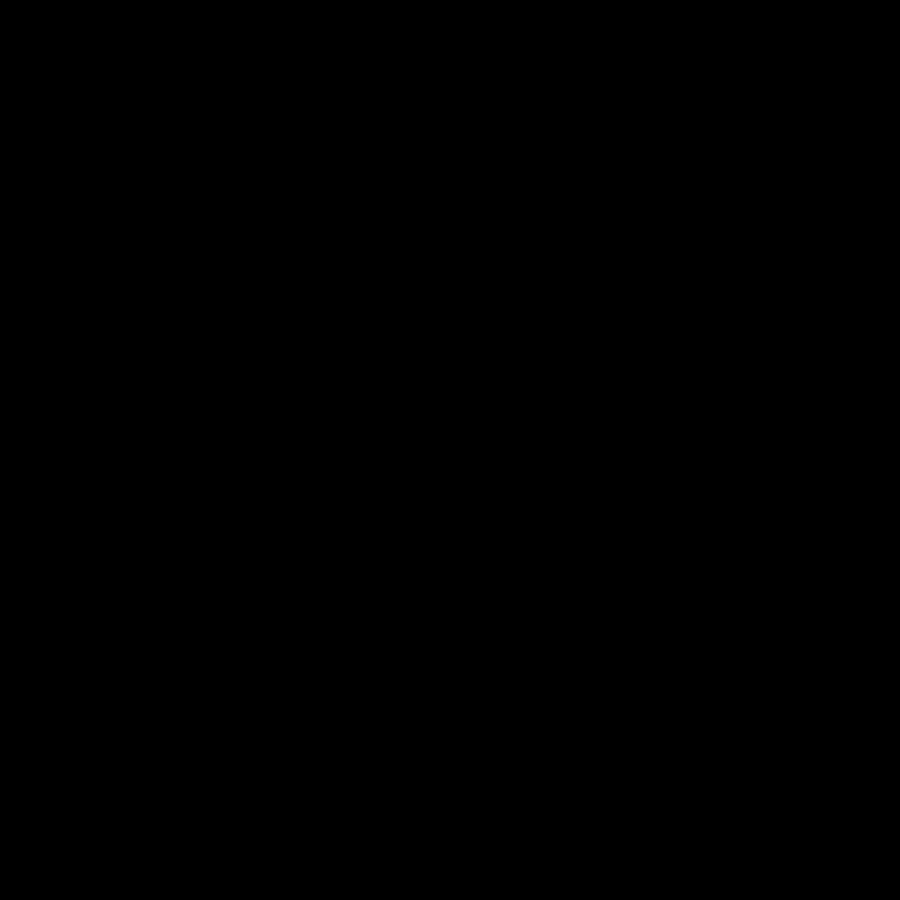
 إشترك
إشترك









