يواجهن سجناً أكبر هو نظرة المجتمع قصص سجينات سابقات



عادل طلعت

عزيزة

نوال مصطفى

أحلام

ميرفت خليل

رغم أن ظروفهن المادية القاسية كانت السبب الرئيسي لأن يحملن لقب سجينات، ورغم أن أياً منهن لم تقتل أو تسرق أو ترتكب فعلاً فاضحاً، فقد وجدن أنفسهن خلف القضبان بعدما عجزن عن سداد ما عليهن من ديون تراكمت لتدفع بهن خلف أسوار السجن.
لكن ماذا بعد الخروج من السجن؟ كيف يعاملهن المجتمع؟ وهل يجدن أنفسهن في سجن أكبر بسبب لقب «سجينة سابقة»؟.
خلعت الجلباب الأبيض واستعدت للرحيل من سجن النساء الذي أعطاها تذكرة للخروج. أنهت الإجراءات وودعت من حولها من سجينات وذكريات السنوات الثلاث التي أمضتها على فرشة رمادية مهترئة داخل زنزانة صغيرة تكدست بحكايات أخرى لم تجد لها أحلام حمدي مكاناً بين زحام همومها. ملابسها القديمة التي تركتها في هذه الخزانة قبل ثلاثة أعوام مضت، حذاؤها الباهت وكيس نقودها الصغير الذي احتفظت بداخله ببطاقة هوية ما زالت تذكّرها بتفاصيل حياة مضت دون فرصة للعودة، وغيرها من «الكراكيب» المتناثرة التي حملتها بتردد قبل أن يخبرها الحارس بأنها حرة الحركة وتستطيع الانصراف.
بملامح غير مصدقة خرجت من بوابات السجن الضخمة بنفس مثقلة بهموم أخرى، لمواجهة سجن آخر أكثر براحاً هو سجن المجتمع الذي كان لقاؤه أصعب من لقاء فرشتها الرمادية خلال ليالي السجن الباردة.
لم يكن دخولها السجن بداية القصة التي اختارت أحلام سردها بغصة لم تغب عن نبرة صوتها طوال الحديث. ظروف الحياة جعلتها تعيش في غرفة صغيرة مع زوج عاطل عن العمل وثلاثة أطفال تعلقوا برقبتها. لم يكن أمامها خيارات أخرى سوى الخروج للعمل، الذي بدأته بتجارة الملابس، تسدّد أقساطها لتجار الجملة بإيصالات أمانة وشيكات بيضاء، ترك فيها التاجر لنفسه حرية التصرف استغلالاً لظروفها القاسية، فراحت الديون تتراكم على كتفيها قبل أن تتعثر في الدفع لتجد نفسها بين جدران السجن.
«سنوات من الشقاء أمضيتها بين جدران السجن، لم أكن أحلم بالخروج يوماً، أو رؤية أطفالي مرة أخرى». هكذا بدأت أحلام حديثها عن حكايتها داخل جدران السجن العالية، لم تنس يوماً ما عاشته ليلة بعد أخرى من جوع ممزوج بألم وإهانة ووحدة وحرمان، حتى من رؤية أبنائها، بعد أن تبرأ منها زوجها وتزوج من أخرى بمجرد دخولها السجن، ومنع أولادها من زيارتها. دموع لم تستطع أحلام حبسها أثناء الحديث الذي أكملته قائلة: «دخلت السجن بعد قضية إيصالات أمانة لسداد أقساط الملابس التي كنت أتاجر بها في محاولة للإنفاق على أسرتي. ما رأيته داخل السجن من إهانة لم يكن بصعوبة فراق أولادي الذين حرمت من رؤيتهم حتى بعد خروجي من خلف القضبان».
21 عاماً هي فترة العقوبة التي قضت بها المحكمة على أحلام، قبل أن تستطيع الخروج بسداد الأقساط التي تولتها عنها «جمعية رعاية أطفال السجينات»، ضمن مشروع «سجينات الفقر» الذي ساعد سجينات إيصالات الأمانة على الخروج إلى الحياة، كما أوضحت أحلام التي واصلت سرد قصتها قائلة: «بعد خروجي من السجن أغلقت الدنيا أبوابها في وجهي مرة أخرى، لم أصدق ما قاله الحارس الذي أوصاني بعدم الرجوع... خطوت إلى الخارج وأنا أفكر في حياتي المقبلة التي لم أشاهد لها معالم واضحة، بعد أن رفض زوجي رجوعي إلى المنزل، ومنعني من زيارة أولادي». صمتت برهة كمن تتذكر أصعب المشاهد التي مرت عليها في الداخل والخارج، ثم اختارت المشهد الأصعب الذي سردته باكية: «بعد خروجي طردني زوجي وحرمني أولادي بحجة أنني لا أصلح للحياة بعد اليوم... لم يكن موقفه أحسن حالاً من موقف المجتمع الذي نبذني، ولم يفتح لي باباً للحياة مرة أخرى».
الامتعاض والردود القاسية والطرد أحياناً هي كل ما حصلت عليه أحلام من المجتمع الذي رفض وجودها بوصمة «السجن» التي التصقت بها... لم تستطع إيجاد عمل أو مسكن، رحلت من قريتها في المنيا هروباً من وصمة العار، وقررت الاختفاء عن الأعين متمنية أن ينساها الجميع ويتركها القدر للحظة استرخاء لم تنعم بها يوماً. لم تشعر بالحرية بعيداً عن فرشتها في زنزانة النساء بقدر ما شعرت بمزيد من الغربة والاحتقار من المجتمع، الذي لم يفرق بين تهمتها وتهمة المخدرات أو الدعارة...
الديون
لم تختلف قصتها كثيراً عن قصة أحلام، سوى في بعض التفاصيل البسيطة التي عاشتها ميرفت خليل في سجن القناطر.تهمتها لم تشعرها يوماً بالعار الذي أصر المجتمع على إلصاقه بها بمجرد ارتدائها الجلباب الأبيض... الديون التي غرقت فيها في محاولة لشراء غرفة نوم متواضعة وبعض الأجهزة الكهربائية المستعملة هي ما وضعت في يديها مقابض حديدية، ما زالت علاماتها مستقرة على يديها رغم خروجها بعد ستة أشهر، اختصرت خلالها تجربة لم تتوقع أن تعيشها، ولم تعرف كيفية الخروج منها حتى بعد تركها لبوابات السجن وجدرانه ذات الأسلاك الشائكة.
أما حكاية زوجها، الذي هرب بمجرد القبض عليها، فتسردها ميرفت قائلة: «في البداية بدأنا الاقتراض لتزويج ابنتي، بدأ الأمر بمجموعة من الشيكات لشراء غرفة نوم وأجهزة كهربائية وقعها زوجي الذي طلب مني التوقيع «كضامن» في حالة «التعثر في السداد». ثقتها بزوجها دفعتها للتوقيع دون تفكير قبل أن تصدمها الحياة صدمات متلاحقة بزوج اختار الهروب وتركها وحيدة، وحكم محكمة وزنزانة ضيقة ومئات الحكايات اليومية التي عاشتها ميرفت داخل سجن القناطر.
لم تكن تتخيل للحظة طوال سنوات عمرها التي جاوزت الخمس والأربعين أن تزور السجن أو تعبر من أمام قسم شرطة. جيرانها ومشهد القبض عليها ووقوفها داخل القفص، وليالي المعاناة داخل الزنزانة، هي ما تتذكرها ميرفت قائلة: «المواجهة الأصعب كانت مواجهة المجتمع بعد الخروج، وتحمل نظرات الأهل باعتباري سجينة أنهيت مدة عقوبتي وعليَّ مواجهة عقوبة جديدة فرضها عليَّ مجتمع نظر إلى قضيتي باعتبارها جريمة شرف، ولم يفرق في المعاملة بيني وبين الأخريات من صاحبات التهم الشائنة».
حياتها بعد السجن لم تكن أحسن حالاً، بعد أن حاولت اكتساب لقمة عيش ضئيلة بكشك صغير، جلست فيه صامتة في محاولة للهروب من الحكاية القديمة التي لن ينساها المجتمع بسهولة، حتى وإن نسيتها المحكمة التي قضت بخروجها بهموم أخرى حملتها ميرفت إلى جانب الفقر.
مجتمع لا يرحم
جلست على سرير خشبي متهالك بين السجينات اللواتي انتظرن الزيارة، في عقلها تزاحمت مشاهد متعاقبة من بداية القصة التي دخلت على إثرها السجن لتمضي ثلاث سنوات متواصلة. لم تلق بالاً لعذاب السجن، أو ما تعرضت له من إهانات متتالية وليالٍ لم تذق طوالها للنوم طعماً، بقدر ما شغلها أطفالها الأربعة الذين تركتهم خارج الأسوار في سجن آخر يطاردهم بوصمة عار أمهم السجينة. أصوات ابنها الصغير ذي الخمسة أعوام، الذي تهلل وجهه بمجرد رؤيتها، هي ما أخرجتها من شرودها في لحظات انتظار الزيارة، احتضنته بقوة ثم نظرت إلى إخوته محذرة من الخطأ بكلمة أمام الصغير الذي حرصت على إخفاء حقيقتها عنه، مثلما حاولت إخفاءها عن الجميع. أخبرته أنها في مستشفى تخضع لعملية توجِب بقاءها لفترة طويلة. حاولت إخفاءه داخل حضنها طوال فترة الزيارة، حتى لا تتعلق في ذاكرته صور السجينات... كان الخروج إليه للبداية من جديد هو شغلها الشاغل، بعد أن توفى زوجها أثناء سنوات العقوبة، تاركاً أطفالها الأربعة بين الجيران والأقارب ونظرات الشماتة وعبارات اللوم التي تركت على نفوسهم علامات الخجل التي حاولوا إخفاءها أثناء زيارتها الشهرية، وحتى بعد خروجها من السجن.
عزيزة محمد محمود واحدة من السيدات اللواتي حكم عليهن الفقر قبل حكم المحكمة، وحكم عليهن المجتمع بعد الخروج من سجن الدولة. قضيتها التي شابهت الحكايات السابقة هي ما انتهت بها خلف القضبان، تاركةً لها همَّ الاختفاء عن الأعين في محاولة لتغيير الواقع الذي لم تستيقظ منه سوى على خبر مغادرتها سجن القناطر.
تصمت قليلاً لاسترجاع ما مضى من سنوات، ثم تبدأ سرد قصتها قائلة: «المجتمع لا يرحم، والفقر هو سبب ما حدث. السجن تجربة قاسية خاصة على النساء اللواتي يضيف إلى عقوبتهن المجتمع هموماً أخرى، على عكس الرجل الذي يترك له المجتمع حرية الخطأ دون عقاب، حتى وإن عاقبته المحكمة، أو وضعته خلف القضبان».
مثل الباقيات لم تكن تجربة الخروج من السجن بالنسبة إليها أسهل من تجربة الدخول، ففي الخارج واجهت سجن العزلة أكثر من الداخل، وبدأت الاستعداد لهموم يومية من التبريرات أو رفض الكلام عن ماضيها مع أحد الجيران أو الأقارب، خوفاً من أن يكتشف ابنها الصغير حقيقة ما حدث. تقول: «لا أخجل من تهمتي، فأنا لم أدخل السجن في ما يخل بالآداب، إلا أنني أواجه يومياً نظرات المجتمع التي تضعني في خانة «سجينة سابقة». لم أكن أعلم أن ما سأواجهه بعد الخروج سيكون أصعب مما واجهته داخل جدران السجن. محاولاتي لشق طريقي من جديد كانت أصعب من محاولاتي لتحمل ليالي السجن الباردة، ونهار أيامه الشاقة، والاختفاء عن أعين ابني الصغير الذي أخشى على مستقبله من ماضٍ لم يكن ذنبه يوماً».
حياة جديدة
خلف الحكايات المستمرة لسيدات سجنهن الفقر قبل أن تسجنهن الدولة، تقف جمعية «رعاية أطفال السجينات» بجانبهن للخروج من أزمات لم يجدن لها حلولاً، وتكفلت بمشروع «سجينات الفقر» لمساعدتهن في الخروج من قضايا إيصالات الأمانة، وتقديم العون لغيرهن من سجينات الجرائم الأخرى وزيارة السجن بشكل شهري طوال أربعة وعشرين عاماً، هي مدة عمل الجمعية التي أسستها الأديبة والكاتبة الصحافية نوال مصطفى.
داخل الجمعية جلس مديرها عادل طلعت متابعاً لملفات لا تنتهي من السجينات اللواتي واجهن السجن، ثم خرجن لمواجهة المجتمع، وهو الدور الذي تحاول الجمعية مساعدتهن فيه، وعنه يقول: «الجمعية تعمل منذ أربعة وعشرين عاماً لرعاية أطفال السجينات داخل السجن في البداية، ورعاية السجينات والخروج بهن من الأزمة في المقام الثاني، والأولوية لإنقاذ السجينات اللواتي وضعهن الفقر فريسة لجشع التجار، وما يفرضونه عليهن من مبالغ طائلة لا وجود لها في الواقع، مستغلين ظروفهن القاسية وعدم قدرتهن على السداد... تبدأ الجمعية درس حال السجينة وما عليها من أحكام ومبالغ، ثم تتفاوض مع الدائن لخفض الديون ثم دفعها بالكامل، ويعطي القانون السجينة حق الخروج في حالة سداد ديونها، والحصول على حكم نهائي بالبراءة، وهو ما تقوم به الجمعية التي نجحت في إنهاء أزمة العديد من السجينات اللواتي عانين من المشكلة ذاتها».
أما عن بقية الأنشطة داخل سجن النساء، فيقول طلعت: «تتولى الجمعية رعاية أطفال السجينات الذين تبدأ حياتهم خلف القضبان ثم في الشارع بعد سن سنتين، كما تقوم بزيارة شهرية لتقديم مساعدات للسجينات وتوفير حياة جديدة للسجينة بعد الخروج من خلف القضبان، بمشروع من المشاريع الصغيرة التي تبدأ بها حياة ما بعد السجن، إلى جانب الزيارات في الأعياد والمناسبات وإعادة تأهيل السجينات بعد ما تعرضن له من تجارب قاسية داخل السجن».
البداية
أما مؤسسة الجمعية الأديبة نوال مصطفى فتقول: «البداية كانت عندما توجهت إلى سجن القناطر لكتابة تحقيق صحافي عن توقيع عقوبة الإعدام للمرة الأولى على أربع سيدات، وكان لقائي بأطفال السجينات للمرة الأولى هو ما أشعرني بأن الأمر يتجاوز التحقيقات الصحافية ووضعني في نطاق المسؤولية تجاه هؤلاء الأطفال وأمهاتهم، بعد أن احتلتني القضية وترك بداخلي مشهد الأطفال داخل الزنازين شعوراً في داخلي بأن الأمر أكبر من التحقيقات الصحافية. وهو ما دفعني للتفكير وقتها في تأسيس جمعية أهلية تعمل على رعايتهن ورعاية الأطفال وتغيير حياتهن، وخلق أول مكان لإعادة تأهيل السجينات وإعدادهن للقاء المجتمع بعد الخروج من السجن».
تكمل: «في بداية الأمر، لم يتقبل المجتمع فكرة الحديث عن السجينات اللواتي اعتبرهن الجميع فئة مذنبة يجب محاكمتها ونبذها، حتى وإن قضى الحكم بخروجهن من السجن. وكانت مواجهة المجتمع وتغيير هذه الثقافة أصعب ما واجهته أثناء رحلة عملي في هذا المجال. ما كنت أحاول إثباته أن السجينات لهن ظروف أخرى تتلخص في الفقر والجهل وتهميش المرأة واحتقارها، وظروف معيشتها التي لم تسمح لها بفرصة في التعليم أو الحياة الكريمة، وهو ما لمسته في قصص السيدات اللواتي تعاملت معهن داخل السجن، ومعاملتهن بالقهر دائماً وهو ما تسبب بإلقائهن خلف القضبان للتخلص منهن، ويرفض المجتمع الاعتراف بجرمه تجاههن إلى جانب غياب الوعي القانوني الذي يلقي بالسيدات داخل السجن وخاصة في قضايا إيصالات الأمانة والشيكات».
وتضيف: «بعد فترة من عملي مع أطفال السجينات والزيارات الشهرية المتواصلة للسجينات، اكتشفت كارثة سجينات الفقر، وهن اللواتي دفعهن الفقر لتوقيع إيصالات أمانة وشيكات نتيجة لأزمات مالية، وقد تدخل إحداهن السجن لمبالغ تافهة، وهي الفكرة التي نقلتها الجمعيات الكبرى بعد فترة لتتحول القضية إلى ملف أطلقوا عليه «الغارمين»، لكنني أفضل تسميته «سجينات الفقر»، لأن الفقر هو السبب الرئيسي وراء مأساة مئات السجينات. وقد بدأت بالضغط بأن سجينات الفقر غير مذنبات ولم يرتكبن جريمة حقيقية ومكانهن ليس السجن، فهن ضحايا لقصور المجتمع وعنف الزوج أو الأهل والظروف في أغلب الأحيان. ومن هنا بدأ المشروع بالتفاوض مع الدائنين وسداد الديون والخروج بهن من السجن، ومحاولة تأهيلهن للحياة من جديد بمشاريع صغيرة نحاول تطويرها للسماح للسجينة بمواجهة المجتمع مرة أخرى».
وعن نظرة المجتمع إلى من تحمل لقب سجينة سابقة، تقول: «سجن المجتمع هو سجن أكثر قسوة من سجن النساء، وهو ما تعيشه السجينة بعد الخروج لمواجهة نظرات المجتمع الذي قرر معاملتها كمجرمة مهما اختلفت الظروف والملابسات. تواجه وصمة العار ونبذها من الجميع، وهي النظرة التي لم تتغير كثيراً منذ عشرين عاماً حتى بعد اختلاف ثقافة التعامل مع السجينة، وإثارة القضية بشكل واسع. لكن ما زالت السجينات اللواتي أنهين مدتهن يعشن إحساس التحقير من المجتمع حولهن».
شاركالأكثر قراءة

إطلالات النجوم
أكثر الإطلالات جرأة على السجادة الحمراء في حفل...

إطلالات النجوم
سيرين عبد النور تتألق في العراق بفستان مجسم...

إطلالات النجوم
نانسي عجرم تحيّر الجمهور بإطلالتها.. عصرية أم...

إطلالات النجوم
نجوى كرم تلفت الأنظار بصيحة الجلد الجذابة

أخبار النجوم
ياسمين عبد العزيز وكريم فهمي يشوّقان الجمهور...
المجلة الالكترونية
العدد 1092 | كانون الثاني 2026

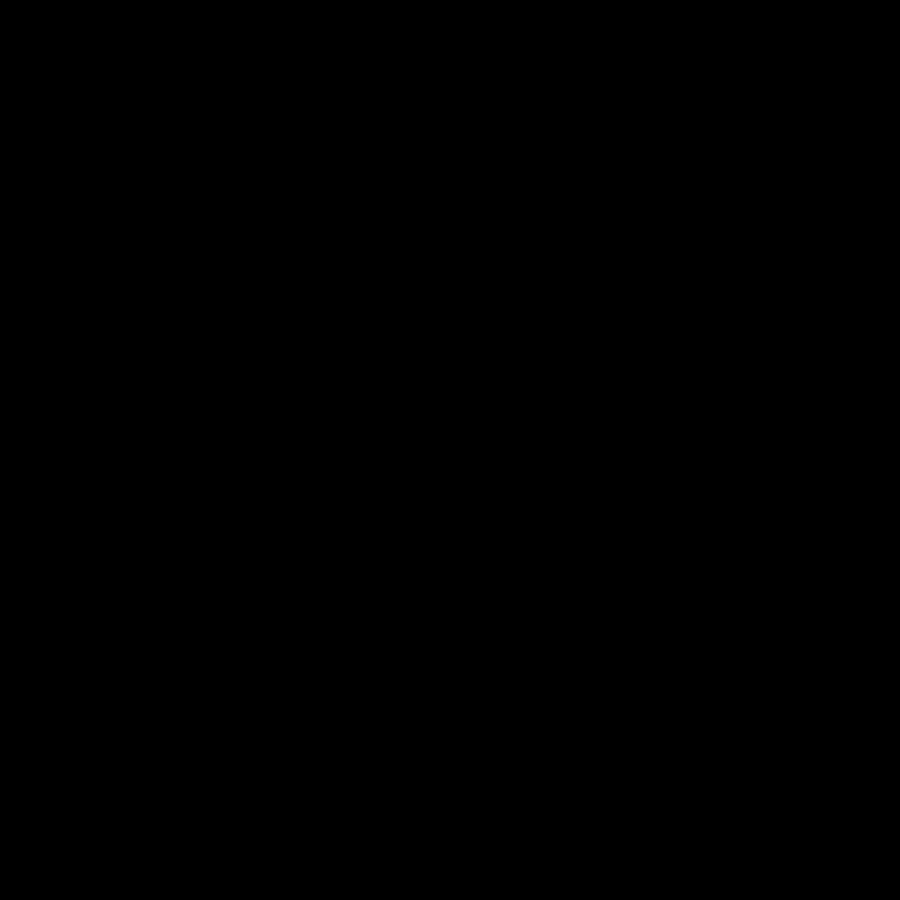
 إشترك
إشترك












