العنف والدم والحرمان: كوابيس تطارد الأطفال في مناطق النزاعات المسلحة!




ملك وحبيبة




آدم

ملك ماهر










المخرج مهدي فليفل






نورهان


الزميلة مايا بنّوت













فيما يعيش الأطفال حياتهم بشكل طبيعي في مناطق كثيرة من العالم، فإن هناك أطفالاً آخرين، خصوصاً في بعض بلادنا العربية، يعانون من وجودهم في مناطق تشهد نزاعات مسلحة. ومشاهد العنف والدم والقتل تحوّلت إلى كوابيس تطاردهم وتغتال أجمل أيامهم... ماذا يقول هؤلاء الأطفال وآباؤهم عن تلك المعاناة؟ وما هي نصائح علم النفس لتجنّب الأخطار النفسية التي يمكن أن يتعرّض لها هؤلاء الأطفال؟ نستعرض في هذا التحقيق شهادات وآراء من مصر وسورية ولبنان. ونبدأ من مصر التي شهدت بعض الاضطرابات الدموية في الآونة الأخيرة.
ملك وحبيبة (7 سنوات): أصيبتا بصدمة نفسية تبعها خوف وتبوّل لا إرادي
«عبد الفتاح السيسي بطل لأنه خلصنا من حكم الإخوان، لكنهم حتى الآن لا يلتزمون برأي الأغلبية ويخرجون في تظاهرات تشهد أحداث عنف. أمي دائماً تقول لي إن احترام رأي الأغلبية واجب، وبالتالي لا يمكنني أن أطالب بغلق تكييف الفصل إذا كانت الأغلبية لا تريد ذلك. ودائماً أسأل ماما متى ستكف التظاهرات وتستقر البلد، نفسي النور يعود إلى الشارع»... بتلك الكلمات أبدت ملك محمد (7 سنوات) رأيها في أحداث العنف الأخيرة التي تشهدها مصر.
تلتقط منها أطراف الحديث حبيبة محمد، شقيقتها التوأم، وتقول: «عندما أرى أحداً ذا ذقن طويلة في الشارع أخاف منه، كنت أشاهدهم في التظاهرات وفي التلفزيون يضربون الناس، ولكن ماما تقول لي إنه يوجد ناس طيبة بذقن وليسوا كلهم أشراراً. ولكني أخاف عندما أرى التظاهرات في الشارع، وعندما أنظر من النافذة وأرى الظلام المبكر في الشارع بسبب الحظر. أتمنى أن نعود إلى اللعب في النادي، وأن نذهب إلى جدتي كثيراً كعادتنا».
سماح: القاموس اللغوي لطفلتيَّ دخلته كلمات مثل مولوتوف وتظاهرات وخرطوش
وتؤكد والدة الطفلتين سماح عرفة، أنهما أصيبتا بصدمة نفسية في بداية أحداث ثورة «25 يناير»، أدّت إلى استيقاظهما ليلاً بفزع وصراخ، فضلاً عن الرعب المستمر طوال الوقت، بالإضافة إلى تبوّل لا إرادي في كل الأوقات.
تضيف: «منزلنا يقع في شارع الهرم الرئيسي بمحافظة الجيزة، وفي جمعة الغضب 28 كانون الثاني/يناير، شاهدنا من نافذة المنزل البلطجية يسرقون المحلات التجارية ويحرقونها. وقتها كنا في حالة ذهول ولم يخطر ببالي أنا وزوجي أن نبعد البنتين عن تلك المشاهد، بعدها رأتا دبابات الجيش في الشارع والجنود بالأسلحة، وما كان يؤثر عليهما بمزيد من الهلع سماعهما صوت إطلاق النيران كل ليلة، فأصيبتا بعدها بصدمة أدت إلى تلك الأعراض. وظللنا تحت العلاج الطبي والنفسي لمدة 8 أشهر حتى بدأتا تستقران نفسياً من جديد».
تتابع: «في تلك الأثناء كان عمرهما 4 سنوات، وكان سؤالهما الوحيد من يضرب من؟ ولم تستقرا نفسياً إلا عندما نفذنا تعليمات الطبيب النفسي وعزلناهما عن الجو السياسي، ولكنهما الآن أصبحتا أكثر وعياً وأرى أن هذه الأحداث انعكست عليهما بصورة إيجابية، فقد عرفتا معنى الوطن وأصبحتا أكثر حباً للبلد. وأعتقد لو أنني ظللت أعلمهما عشر سنوات معنى حب الوطن في الظروف العادية لما كانتا ستستوعبان مثل الآن».
وتؤكد سماح أن ابنتيها بعد تخطي الأزمة النفسية أصبحتا أكثر إدراكاً، فقد كانتا مهتمتين بالانتخابات الرئاسية وكانتا تسألانها من الذي سيكسب مرسي أم شفيق؟ وفي فترة حكم الرئيس المعزول محمد مرسي انعكس عليهما تأفف والديهما من سلبيات المرحلة وأصبحتا كارهتين لحكمه، وتضيف: «كنت أتعجب كيف يعيش أطفال فلسطين وسورية في النزاع المسلح. لكن ما مرت به ابنتاي علمني أنهم يكتسبون مناعة بعد الصدمة، ففي نهاية فترة حكم مرسي ازدادت مشاهد العنف بين الإخوان والمعارضة، والبنتان كانتا تشاهدان الأخبار معنا، وانعكست عليهما رغبتي ووالدهما في الخلاص من ذلك الحكم، لذا تريان وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي بطلاً منقذاً يشبه سوبرمان في أفلام الكرتون».
وتؤكد قائلة «أزرع فيهما دائماً ضرورة احترام الرأي المخالف، وفوجئت ذات يوم بأنهما تؤكدان لي أن أنصار مرسي لا يحترمون الرأي المخالف، وهو رأي الغالبية التي أرادت عزله، وقالتا لي نصاً: عدد التظاهرات التي شاهدناها في التلفزيون المطالبة بعزل مرسي كانت أكبر بكثير من تظاهرات الإخوان وعليهم احترام الرأي المخالف».
وتتابع: «رغم أن القاموس اللغوي لطفلتيَّ دخلته كلمات لا أعتقد أنهما كانتا ستعلمان عنها إلا في العشرينات من عمرها مثل مولوتوف وخرطوش وتظاهرات، فضلاً عن مصطلحات العنف، مثل الاشتباكات وفض الاعتصام، أرى أنها تربية سياسية لا بأس بها زادتهما وعياً. وأحاول قدر الإمكان استغلال الأحداث لأزرع فيهما القيم السياسية، مثل احترام رأي المعارضة، وأن الاختلاف لا يعني الخلاف».
آدم (5 سنوات): الشارع فيه أشرار ولا أحب سماع صوت الرصاص
«الشعب يريد إسقاط النظام» هتاف ردده المصريون على مدار ثلاث سنوات تقريباً، تجذّر في ذهن الطفل آدم أمير (خمس سنوات)، وكلما رأى بث «المليونيات» في التلفزيون حمل علم مصر وطاف يردد الهتاف نفسه داخل المنزل. يقول: «يوجد أشرار في الشارع، لا أحبهم وأريد أن يقضي الجيش عليهم. لا أريد أن أراهم في مصر مرة أخرى، لا أحب سماع صوت الرصاص».
تؤكد أمنية محمد، والدة آدم، أنه يتأثر بشدة من مشاهد العنف إذا رآها صدفة في التلفزيون، وتقول: «أصبح مدركاً لأصوات الرصاص وبمجرد سماعها يجري إليَّ ويقول لي: «اسمعي يا ماما صوت رصاص أنا خائف». لذا نحاول أنا ووالده تجنيبه مشاهدة التلفزيون، لأنني على اقتناع تام بأنه إذا رأى مشاهد العنف ستسلب منه براءة الطفولة، فضلاً عن الآثار النفسية التي سيعانيها ونحن في غنى عن ذلك، لذا مشاهدة أفلام الكرتون في غرفته أفضل حل أو اللعب بـ»البلاي ستيشن» مع والده، فمن المستحيل أن نشاهد التلفزيون وآدم موجود معنا ونكتفي بمتابعة الأخبار عبر هواتفنا المحمولة».
وتضيف: «أسعد عندما أرى آدم ذا وعي سياسي، أساعد أنا ووالده على تنميته، فهو يعلم أن والده يذهب إلى ميدان التحرير لأنه يريد مصر في أفضل حال، وأجلس معه لنرى المليونيات فهو يعلم أن والده هناك. وفي وقت الانتخابات الرئاسية السابقة كان يعرف أسماء المرشحين في الجولة الأخيرة. الآن ومع انتشار دبابات الجيش وجنوده في الشوارع، أحاول أن أفهمه أن دور الجيش هو حماية البلد حتى لا يخاف من السلاح الموجود في أيدي الجنود والضباط».
ملك ماهر (8 سنوات): مللت التظاهرات وأبي يفرض علينا حالة طوارئ
«مللت من التظاهرات والمعارضة والإخوان، لأن أبي فرض علينا حالة طوارئ، وألغينا المصيف وعيد ميلاد أخي طه»... بنبرة شجن عبرت ملك ماهر (8 سنوات) عن موقفها من المشهد السياسي الحالي في مصر.
تقول: «أسمع في الأخبار عن الصراعات الحالية والتظاهرات، وأنا أخاف من الذين يقومون بها لأنهم سبب العنف وعدم الاستقرار الذي نعيشه».
يؤكد والدها ماهر الجندي أنه يحاول إبعاد طفليه ملك وطه عن مشاهد العنف في التلفزيون، وإذا تسرب أي مشهد على غفلة يغيرون القناة على الفور، ويقول: «أحاول أن أتركهما يستمتعان بطفولتهما، لكني أربطهما بالواقع في الوقت نفسه، فهما يعلمان أننا ألغينا عيد ميلاد طه بسبب حظر التجوال، كما ألغينا المصيف هذا العام بسبب عدم الاستقرار الأمني، خاصةً أن ملك الكبرى أكثر وعياً».
ويضيف: «أبذل مجهوداً كبيراً حتى تفهم ملك أن المعارضة ليست سيئة دائماً، فقد ارتبط لديها لفظ «إخوان» بالسُبّة، وأصبحت تخاف أن ترى رجلاً ذا لحية أو امرأة منتقبة في الشارع. وأحاول أن أفهمها هي وشقيقها أن الإخوان جزء من الشعب المصري ويجب أن نعيش معاً في أمان».
طه ماهر (7سنوات): أريد الذهاب إلى المصيف الذي ألغاه أبي بسبب عدم الاستقرار
أما طه ماهر (سبع سنوات) فيؤكد أنه هو أيضاً كان يريد أن يذهب إلى المصيف ولا يحب التظاهرات، لأنها تتسبب بسقوط الكثير من القتلى.
الأب ماهر: ولداي يشعران بعدم الأمان
يعلق ماهر الجندي على كلام طفليه قائلاً: «طه وملك يشعران بعدم الأمان، خاصةً أننا نشاهد يومياً برنامج إبراهيم عيسى، وسمعنا تحذيراته قبل العام الدراسي من تعنيف المدرسين معارضي النظام الحالي للأطفال أو التوجيه السياسي لهم. وبعدها بيومين عند دخول المدارس حذرتهما وطلبت منهما أنه إذا تحدث معهم أي مدرس في أمر خارج عن المنهج أن يخبراني على الفور».
د. أحمد عبدالله: أطفال النزاع المُسلح يتشابهون في كل الأمكنة
من الناحية النفسية، يوضح الدكتور أحمد عبدالله، أستاذ الطب النفسي في جامعة الزقازيق، أن النزاعات المسلحة ومشاهد العنف التي يشاهدها الطفل المصري حالياً، سواء في التلفزيون أو الواقع، تؤثر عليه نفسياً بأعراض لا تختلف عن أعراض أطفال سورية أو فلسطين، فيصاب الطفل بصدمة نفسية، تجعله يتصرف وكأنه أصغر في العمر، كأن يصبح شديد التعلق بوالديه، ويصيبه التبوّل اللاإرادي، فضلاً عن ميله إلى العزلة وإصابته باضطرابات النوم والفزع ليلاً أثناء النوم.
ويؤكد عبدالله أن تلك الأعراض تصيب الأطفال دون العاشرة، لافتاً إلى دراسة أعدتها منظمة «اليونيسيف» على عينة من أطفال النزاعات المسلحة جاء فيها أن 62 في المئة من الأطفال (عينة الدراسة) تعرضوا لصدمات نفسية عندما شاهدوا جثثاً ملقاة على جانبي الشارع لأشخاص لا يعرفونهم، وأحيانا لأشخاص يعرفونهم، و20 في المئة من أطفال العينة العشوائية فقدوا أقرباء لهم بواسطة القتل أو الأَسر، كما أن 50 في المئة تعرضوا لاضطرابات نفسية من جراء النزاعات المسلحة كالأحلام المزعجة والكوابيس والخوف المستمر من كل شيء .
ولفتت الدراسة إلى أن جميع الأطفال الذين شملتهم يخافون الخروج من المنزل، وكانت رسومهم تعبر عن الألم المكبوت، كأن يرسموا صور الجثث والدم والطائرات وكل ما له علاقة بالغزو. وينصح عبدالله الآباء بأن «يُبعدوا الأطفال عن كل مصادر الأخبار السياسية، حفاظاً على نفسياتهم، ووقاية من الصدمات التي يتعرضون لها. كما عليهم إبعاد الأطفال عن الفيديوهات التي تحتوي على مشاهد عنف أو قتل على الإنترنت، ويجب أن يوفروا للأطفال بكل الطرق الشعور بالأمان الذي افتقدوه».
بلا مدارس... بلا منازل... بلا وطن... آباء الأطفال السوريين يأكلون الحصرم وأبناؤهم يضرسون
وهذه شهادات بعض الأطفال من سورية الذين عصفت بهم الأحداث الدامية هناك...
ماجد: فقد أهله ورفاقه ومدرسته
تغص الدموع في عيني ماجد المفتي (9 سنوات) الطفل الهارب من القصف في مدينة دير الزور السورية في شرق البلاد. يقول: «مات أبي برصاصة قناص وهو يحاول إنقاذي من بين ركام بيتنا، وأمي جُرحت برصاصةٍ في كتفها أصابتها بشلل تام في يدها اليمنى، مدرستي تهدمت، ورفاقي فيها معظمهم مات، والبقية لا أعرف عنهم شيئاً». ويتابع الطفل الأسمر حديثه والدموع تنهمر من مقلتيه: «لو أنني تمكنتُ من جلب صدريتي وحقيبتي المدرسية، لو أنهم سمحوا لي أن آخذ صورة أبي وأمي عن حائط البيت، كان القصف قوياً، كانت القذائف تنهال علينا من كل جهة... اليوم أعيش في مدرسة للاجئين مع أمي وأختي الصغيرة آية، أنا خائف على والدتي، وأريد أن أعمل لأجلب لها النقود والدواء». كلمات يقولها الطفل المفتي فيما أصدقاؤه يواصلون اللعب في باحة المدرسة التي التقينا فيها مجموعة من أطفال وأهالي الأسر اللاجئة في مدرسة مأمون منصور بدمشق، من هناك استطعنا بصعوبة التكلم مع بعض الأطفال بسبب التشديد الأمني عليهم، وعدم السماح للصحافة بالتصوير أو إجراء حوارات معهم.
أم ماجد: المساعدات ضئيلة والمستفيدون لا يزيدون عن ستين في المئة
تتدخل هنا أم ماجد مقاطعةً كلام ابنها الصغير: «المهم لدي اليوم أن يكمل ماجد دراسته، هذه كانت وصية المرحوم أبيه، الهلال الأحمر يقدم لنا سلالاً غذائية، وينسى الكتب المدرسية، ولوازم التعليم. لقد جلبوا لنا قبل أيام كميات لا تكفي للجميع، فالأطفال هنا معظمهم في سن الدخول إلى المدرسة، ولم يتسنَّ لهم الحصول على القرطاسية وملابس المدرسة. نمضي الشتاء في غرفة باردة من غرف الصف المدرسي الذي نسكن فيه مع خمس عائلات أخرى اضطرت للنزوح من ريف دمشق وحمص ودرعا».
وكالة اليونيسيف قدمت دعماً جزئياً لأطفال سورية من النازحين واللاجئين عن قراهم ومدنهم، لكن وحسب تقرير المنظمة العالمية أن عدد الأطفال المهجرين بفعل النزاع المسلح على الأرض السورية قد وصل إلى قرابة مليون طفل بلا مأوى أو غذاء أو دواء، هكذا يتم اليوم تخصيص قسم من المساعدات التي توفرها عدة منظمات وهيئات دولية على رأسها وكالة غوث للاجئين لأطفال سورية. لكن هذا الدعم يبدو ضئيلاً إذا ما عرفنا أن نسبة المستفيدين منه لا تتجاوز 60 في المئة من جمهور اللجوء السوري داخل البلاد وخارجها.
مناف عوض محمد (10 سنوات): ينقصنا المَلْبَس والغذاء والدواء
«أتناول القليل من البيض والحليب المجفف، مع بعض الخبز ومربى المشمش، هذا كل ما أحصل عليه من وجبتي اليومية. أمي تبيع السلال الغذائية التي تحصل عليها لتجلب نقوداً تصرفها علينا لشراء ثياب شتوية. الجو بارد، ونحن لم نأخذ شيئاً من ثيابنا عندما غادرنا حمص، وقتل أبي في حي الخالدية نهاية حزيران (يونيو) الماضي بعد مواجهات بين الميليشيات المسلحة هناك».
وتقول والدته آمنة التلاوي:
«أحتاج إلى بيع حصصنا من السلال الغذائية التي تقدمها لنا الوكالة. لدي ثلاثة أطفال وجميعهم بحاجة إلى ملابس شتوية ودواء، هذه طريقة درجتُ عليها منذ نزوحنا من حمص بواسطة الصليب الأحمر. زوجي مات مخلفاً لي أمانة كبيرة في عنقي، الأطفال لا يعرفون أننا في حرب، هم اليوم بحاجة ماسة إلى التعلم والطبابة وبعض الحلوى التي لم أعد قادرة على صنعها لهم في هذا الملجأ».
سارة المصري: جدتي هي كل ما تبقَّى لي من أُسرتي
رواية أكثر قسوة نستمع إليها من سارة المصري (10 سنوات): «لا أعرف شيئاً عن أمي أو أبي أو أخوتي، كل ما أتذكره هو جدتي لأبي تحملني في الليل وتمضي بي من مدينتنا داريا نحو هذه المدرسة، جدتي هي كل من تبقى لي من أسرتي. أمي وأبي وأخوتي علاء وعمر وأسماء، أنا أشتاق إليهم، أشتاق لمدرستي، لحديقة بيتنا، لأمي وطبخاتها الطيبة، هنا يوزعون علينا الأرز والسكر والحليب والخبز، لكنني لا أشعر بالفرح، ثم أنني بحاجة إلى دواء- مصابة بداء السكري- وإلى سرير ملون كالذي كان في بيتنا. أشتاق كثيراً إلى لعبتي ميمو تنام قربي على سريري».
مهند (12 سنة): اشتاق الى رفاقي في الحارة
نطل على حياة المخيم في مدرسة بحي المزة الدمشقي، نعاين المكان عن قرب، الحكايات لا تنتهي في هذا المنفى الاختياري. الأطفال رغم كل شيء يلعبون، يتصايحون، يتراكضون في الصفوف. وعلى أدراج المدرسة المخصصة للأسر اللاجئة لكن صوت الفتى مهند حمامي (12 سنة) يوقف حركتنا فنصغي إليه:
«الحياة هنا ليست سيئة. أنا وأبي وأمي نقيم في الصف، نفترش مصطبة تحت سبورة، في الليل أكتب بالطبشور على اللوح دروس الحساب والقراءة، رفاقي أيضاً يكبتون ما يحلو لهم، يرسمون نهراً وبيتاً وأشجاراً. نحن نتعلم الكثير يومياً، آنستي رشا تشرف على دروسنا، وجلبت لنا كرات ملونة نلعب بها في الباحة، لكنني أشتاق أحياناً إلى رفاقي في الحارة» كلام الطفل مهند النازح مع أهله من بلدة شبعا بريف دمشق لا يبدو بهذا الشكل مؤسفاً، فحديثه عن اللوح والسبورة والرسوم التي يخططها مع رفاقه فيه الكثير من التهكم والذكاء الخفي، نسأله: لكن كيف أمضيت الصيف هنا، فيجيب: «أمضيته في اللعب وكنتُ أساعد أبي في تقشير الصبّار وبيعه على باب المدرسة. وأحياناً كنتُ أبيع كيساً كاملاً من المحارم الورقية، متنقلاً بين محلات بيع الشاورما».
الأسرة الناجية
على مقربةٍ من ضجيج الأسر النازحة وعاداتها اليومية في طهو طعام الغداء وتناول الشاي، أو بعض الفاكهة الصيفية من بطيخ وعنب يتركنا المشهد -على مأساويته- بإصغاء تام إلى هرج ومرج الأطفال في ساحات المدرسة التي تمور باللاجئين. نقترب أكثر من هذه الفاجعة، نلاحظ أسرةً مكونة من أب وأم وثلاثة أطفال، الأسرة الصغيرة التي هربت من بلدة الكسوة قرب دمشق. نسألهم عن الحال، فينظرون إلينا متفحصين هيئتنا، وبعد ابتساماتٍ متبادلة تهدأ القلوب. يُطرق الأب ثم يفرج عن كلماته الأولى بحرقة:
«الحمد لله، غيرنا ماتوا، ولم يستطع أحد انتشالهم من تحت الردم». تكمل الأم: «المهم زوجي وأولادي بخير، كل ما أتمناه أن يوقف القتال، أن يتوقف الدم، أخوتي وأهلي لا أعرف عنهم شيئاً».
وتقول الطفلة هيا المدني (11 سنة):
«أنا حزينة على أبي وأمي، فهما لا يأكلان إلا وجبة واحدة كي يوفرا لي ولأخوتي الجزء الأكبر من الطعام. أنا خائفة عليهما، خائفة من الرصاص، فصوته لا يزال في أذني. الرصاص ظالم قتل خالي وزوجته، كسر زجاج نافذتي، وحطم جدران بيتنا. أشتاق إلى بيتنا، أشتاق إلى صديقاتي في المدرسة، إلى معلماتي، وكتبي، هناك كنتُ أرسم بالألوان شمساً وقمراً ونجوماً ووروداً».
يتدخل الأب أبو محمد: «أنقذتهم من القصف وهربت بهم في الليل، هربنا بثياب النوم، لم نأخذ معنا شيئاً... ما يقدم لنا لا يكفي، بل يجعلنا على قيد الحياة، ننام في فراش واحد في إحدى زوايا قاعات المدرسة وبمشاركة ست أسر، نتقاسم معها الهواء والغذاء والأسرار. هذا ليس إنسانياً، فلقد فقدتُ عملي بعد أن دُمّر دكاني الصغير في حي الكسوة. فقدتُ سيارة الشحن الصغيرة، فقدتُ كل شيء، ولم يتبق لي سوى الله الكريم».
أسامة العربيني (12 سنة): لا أريد أكثر من العودة الى البيت
الليل يهبط على المدرسة التي نجري تحقيقنا فيها، البعض يذهب لصلاة العشاء، والبعض الآخر ما زال يتمشى في ساحة المدرسة وكأنه نسخة من حنين خالص.أسامة العربيني (12 سنة) الهارب من ريف القصير، نسأله عن أمنياته في المستقبل فيجيب بحزن و بعد تردد: «كل ما أحتاجه هو العودة إلى البيت، لقد ماتت أختي الصغيرة وحدها هناك، أريد أن أعود إلى بستان الكرز الذي زرعه أبي. وأريد أن أذهب صباحاً إلى المدرسة مع رفيقيّ شادي وأيهم، فأنا لا أعرف عنهما شيئاً منذ رحيلنا عن القرية».
سامر وهديل: نبيع السمك الملون لنؤمن الدواء لوالدينا
سامر وهديل، الطفلان اللذان يعملان في بيع أحواض أسماك الزينة في الشارع المقابل لمدرسة اللاجئين بعد نزوحهما من حي التضامن قرب دمشق، نشتري منهما، نسألهما عن المدرسة، وكيف وصلا إلى هذا الحال. تجيب هديل (13 سنة): «ليس لنا دخل نحن نبيع الأسماك الملونة. أنا وأخي سامر نبيع السمك من أجل جلب ثمن الدواء لأبي في المستشفى، وأمي المريضة». يتدخل سامر (11 سنة): «نحن نحب المدرسة لكن كيف نستطيع الذهاب إلى مدرستنا، وقريتنا دمرت وبيتنا أحرق؟ أبي وأمي بحاجتنا، وعلينا أن نبيع الأسماك الملونة، وقبلها كنا نبيع الورود. ثمة أناس يشترون منا، والبعض الآخر يعطينا مالاً دون أن يشتري، أنا مسؤول عن أختي، وعن أبي وأمي»... إذاً هي قسوة لا يحتملها عقل بشري، فضحايا الحرب السورية هم هؤلاء الأطفال الذين تراهم أينما مشيت في شوارع العاصمة السورية، يبيعون الورد أو السمك أو العلكة أو يفترشون الأرصفة ومقاعد الحدائق العامة يدخلون عليك في مقهى «الروضة» المعروف في وسط البلد، هيئاتهم لا تشي بأنهم متسولون على الإطلاق، بل هم علامات فارقة في خد المدينة. وجوههم طافحة بالبكاء والتعب والجوع والحرمان، سحناتهم الباكية تجعل قلبك ينخلع من مكانه، كلما رأيتهم يتقاسمون رغيفاً من الخبز، أو يشربون من صنبورٍ عمومي في قلب زحام العاصمة، عشرات منهم ستراهم بالعين المجردة يضرسون حصرم الحرب التي أشعلها الكبار فوقعوا هشيماً في أوارها المتصاعد...
طفولة على مفارق الطرق
نُشر تقرير عن 10 أماكن تغيّر حياة الطفل مدى الحياة. أماكن لتمضية إجازة ممتعة حيث عجائب الدنيا التي يقرأ عنها الأطفال في الكتب، مثل، جزيرة ماركو في فلوريدا أو خليج شيكسبير في ميريلاند أو حتى موسكوكا في كندا... لكن هناك أماكن أخرى في العالم ليست لتمضية إجازة، قد تغيّر حياة طفل... مخيم أو رصيف أو مرمى جبل يهطل منه الرصاص.
المخرج الفلسطيني مهدي فليفل: دخولي مخيم «عين الحلوة» كان أفضل من زيارة «ديزني لاند»
مهدي فليفل، مخرج فلسطيني شاب تحدى في فيلمه الأول «عالم ليس لنا» A World Not Ours الذي يحمل عنوان مجموعة قصصية لغسان كنفاني، مقولة ديفيد بن غوريون الشهيرة عن الفلسطينين: «سيأتي يوم يموت فيه الكبار وينسى الصغار».
يقول مهدي: «البيئة التي خرجت منها لها دور، والإجازات الصيفية التي كنت أمضيها في المخيم رغم أنني كنت مقيماً في دبي ثم الدنمارك كانت مختلفة عن «صيفيات» أصدقائي الدنماركيين الذين كانوا يسافرون إلى مايوركا أو جزر اليونان... أما أنا فكنت أركض حافي القدمين وألاحق القطط وأتسلق شجر التين مع أصدقائي في المخيم، كنا نصاب بالجروح أو يتعرض أحدنا للضرب من عمه... كان يمرّ علينا يومان أو ثلاثة أيام دون استحمام وينقطع التيار الكهربائي...».
كنت أمسك سلاح أعمامي وأطارد القطط
- «دخولي إلى مخيم «عين الحلوة» كان أفضل من زيارة «ديزني لاند» هكذا تقول في الفيلم؟
كانت هذه العبارة نقل شعور طفل والفرحة التي تنتابه حين يزور المخيم. دخولي كطفل في سن 8 أو 9 سنوات إلى المخيم كان يوازي حلم طفل غربي بزيارة «ديزني لاند». كنت أمسك سلاح أعمامي وألعب ليلاً وأسهر وأشاهد مباريات كرة القدم وسط الشارع وأطارد القطط...
- ما الفرق بين تصويب الكاميرا وتصويب السلاح تجاه الهدف؟
تصويب قد يقتل وآخر قد ينقذ حياة. «عين الحلوة» هو المخيم الفلسطيني الأكبر في جنوب لبنان. يعيش فيه أكثر من 150 ألف لاجئ في لبنان في مساحة كيلومتر مربع واحد. حين أنشات وكالة الأمم المتحدة لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين (الأنروا) المخيم عام 1948 توزعت العائلات في أحياء حسب القرى التي أتوا منها من فلسطين. في السنوات الأولى، لم يبنٍ اللاجئون بيوتاً دائمة آملين في العودة إلى الوطن. لكنهم باتوا بحاجة إلى مساكن أكثر راحة حين لم يتحقّق الأمل. حين بلغت «عين الحلوة»، الجزيرة الفلسطينية المطوّقة بنقاط تفتيش الجيش اللبناني ال65، ولد فيلم مهدي فليفل. هو «بورتريه» حميم وهزلي عن أجيال ثلاثة. ولد مهدي في دبي وكبر في «عين الحلوة» قبل أن ينتقل إلى الدنمارك، لكن مهدي كان يشعر طوال الوقت بأن مخيم «عين الحلوة» هو بيته. حين كان يعود من إجازات الصيف التي أمضاها في المخيم كان يجد نفسه عاجزاً عن وصف المكان لأصدقائه في المدرسة، وكأنه ملزم الحديث عن أهله وأصدقائه الذين لا يزالون يعيشون هناك. مع مرور الزمن، اقترب من شغف والده التسجيلي. عبر الكاميرا، اكتشف مهدي أنه يستطيع الإضاءة على المخيم لفهم أعمق للحياة التي يعيشها من يسكنون هناك. التصوير كان لحفظ هويته والمكان الذي أتى منه.
أبو «إياد» صديقه وبطل فيلمه
عضو في منظمة «فتح» مذ كان في السابعة
هو صديق مقرب من مهدي، بسام اسمه الحقيقي. أما «أبو إياد» فهو اسمه القيادي في إحدى المنظمات الفلسطينية. من سن السابعة كان عضواً في منظمة «فتح»، وحياته كانت مكرسة لـ «القضية». لقد كبر «أبو إياد» متعباً من حياته في المخيم. زيارات مهدي تذكره بما يمكن أن تكون عليه الحياة خارج المخيم، بينما وجوده الروتيني يعكس قيمة ثورية واستفهاماً مخيفاً حول العودة الأسطورية إلى أرض الوطن فلسطين.
خبر من «عين الحلوة»
«توجه وفد من الفصائل الفلسطينية والقوى الإسلامية الى منزل أمير «فتح الإسلام» في مخيم عين الحلوة بلال بدر لضبط الوضع في المخيم بعد وفاة حسين يعقوب المعروف بحسين الطويل. وضم الوفد ممثلين لحركات «حماس» و»الجهاد الاسلامي» و»الحركة الاسلامية المجاهدة» و»عصبة الانصار» وعضو «اللجنة الشعبية» في مخيم عين الحلوة عدنان الرفاعي. وكان الطويل مطلوباً بتهم قتل عدد من قيادات حركة «فتح» في المخيم، وكان قد تعرض لمحاولة اغتيال الشهر الماضي سببت له الشلل التام».
نورهان في «باب التبانة»: أحب كثيراً إجراء المقابلات حين تشتد الاشتباكات
«نورهان صاحبة الشعر الأحمر»، ليست قصة تشبه حكايا الأطفال رغم أنها طفلة تشبه بطلات الرويات الصغيرات. وقفت نورهان مبتسمة خلف الجدار المهشم بقذيفة في منزلها في «باب التبانة»، شمال لبنان. تحب الكاميرا وكأنها باتت خبيرة في التموضع أمامها، أمام غير العربي منها غالباً. كانت «باب التبانة» في الماضي تسمى «بوابة الذهب» التي يتبضع منها المسافرون إلى سورية. لكنها اليوم منطقة فقيرة جداً وخطيرة جداً لموقعها المقابل لجبل محسن. مبكية حين تبدي توقها لإجراء المقابلات حين تشتد الاشتباكات بين منطقتَي «جبل محسن» و«باب التبانة». فهي لا تعي أن الانجذاب إلى إجراء مقابلة معها مرادف لموتها المحتمل.
تحب ابنة ال8 سنوات المدرسة لأنها تتابع حصة اللغة الفرنسية بشوق... لكن المدرسة قد تقفل أبوابها طوال أسبوعين أحياناً. مدرسة «دار السلام». تخاف جداً من الرصاص، «بيتنا مُواجه». تعني أنه مطل على جبل محسن. «نحن قريبون جداً من جبل محسن. كنت في الطابق الأول من المبنى حين بدأ الاشتباك. إلى أين أذهب؟ لا نملك مكاناً آخر غير منزلنا في شارع سورية. كما أنني أحب منزلي كثيراً وأفضل ملازمته والاحتماء في داخله». في باب التبانة وفي شارع سورية تحديداً تترك 700 عائلة منازلها حين تدور الإشتباكات ويصبح أفرادها وسط «خط النار». تضيف نورهان وهي تتأسف على الحالة التي بات عليها المنزل «الصالون محطم... أصيب ابن عمتي في رأسه وهو يشتري الحلوى». من جهة أخرى، يظهر حب الظهور والأضواء في شخصية الفتاة الصغيرة: «أحب كثيراً أن أجري المقابلات وأجيب عن أسئلة من يأتون إلى هنا حين يسوء الوضع وتشتد الإشتباكات». تضيف وكأنها تتحدث بلسان الكبار: «حين أصيب ابن عمتي عمر في رأسه... عمره 20 عاماً... دعَوت على رفعت عيد» (قائد جبل محسن). تضيف أن صديقتها كادت تموت أيضاً، «خرجت جنا من المنزل لإعادة وصل التيار الكهربائي من الطابق السفلي لكن القناص أصابها في رقبتها». لم تمتْ جنا لكن الرصاصة اخترقت طبقة سطحية من رقبها.
هكذا يعيش أطفال باب التبانة الذين يطمح بعضهم إلى منافسة المسلحين في لقاء الصحافيين.
تسكتُ نورهان قليلاً. تفتح عينيها الخضراوين جيداً: «نحن أطفال. لم أعد أحب الصعتر لكثرة ما أتناوله حين تنقطع الطرق. كلما أصلحنا زجاج النوافذ اخترقه الرصاص مجدداً». يتوقف والدها عن العمل حين تبدأ المعركة، «والدي سائق أجرة». يشارك والدها في المعارك أحياناً لحماية عائلته، ابنته التي حملت في سباق ماراثون طرابلس وردة حمراء وحين عادت إلى منزلها عقدت حاجبيها والتقطت شظايا. يقول والدها: «لا أحمل سلاحاً بدافع مذهبي ولا أكره العلويين، بل دفاعاً عن النفس. أشعر بالخجل من عائلتي أحياناً حين لا أستطيع تأمين متطلباتهم. نحن على موعد مع المعارك كل شهرين».
يذكُرنا العالم لاستعراض المسلحين وذخيرتهم
لا نزال في شمال لبنان، لا يزال الخطر سيّد الموقف. هنا «ضهر المغر». إنه يوم دراسي وسط الأسبوع لكنّ أطفالاً كثراً يقبعون في الطريق وبين الأزقة، بعضهم بملابس النوم. تقع بين «باب الحديد» و«جبل محسن». إنها أكثر المناطق اللبنانية فقراً حيث يسهل التعثر برصاصات فارغة تماماً كأعقاب السجائر، وحيث علقت صورة عملاقة على مبنى - قد ينهار في أي لحظة - كتب عليها «أثق بهذا الرجل».
هربت رانيا من منزلها في القبة إلى «ضهر المغر» حيث أهلها لتحمي طفلتيها الصغيرتين من التراشق العشوائي. انتقلت إلى مكان أقل خطراً لكن لا يمكن المجازفة وترك الجدار الآمن لشراء ربطة خبز أحياناً. تقول: «كما تربيت سيرتبّى أطفالي رغم أن الوضع ساء كثيراً بعد الأزمة في سورية». الأزمة السورية ولدت أزمة معيشية هناك حيث يقيم النازحون السوريون ويعملون في مكان تبلغ فيه البطالة مستوى عالياً.
هناك التقيت أيضاً سمر (15 عاماً)، طالبة في مدرسة «أبو سمرا» التي قد تغلق أبوابها في أي لحظة. فاختارت المعتدة بنفسها ثقافياً أن تكون - رغم صغر سنها- عضواً في دورة تمكين المرأة والتوعية الصحية التي تنظمها جمعية Utopia الأهلية في الحي. «أريد أن أكون فاعلة في المجتمع. وإصلاح الصورة المعمّمة عن المنطقة. لا أريد أن أجلس في المنزل حين أتزوج». خطيبها يكبرها بسنتين، هو أيضاً يكمل علمه أحياناً. سألتني هي: «أي فكرة لديك عن ضهر المغر»؟ لم أكن أعرف هذه المنطقة أبداً. تضيف: «الصورة الحقيقية عن ضهر المغر لا تظهر إعلامياً. يذكرنا العالم حين تحتدم الاشتباكات فقط لاستعراض المقاتلين وستراتهم وذخيرتهم». تعيش سمر صراعاً داخلياً إضافياً لا يشبه الصراع الخارجي. هي فعلاً تشعر بالخجل من سمعة المنطقة التي ولدت فيها حيث يجد التلميذ صعوبة في إكمال تعليمه. قد يختار الشارع، قد يحمل السلاح، قد يختار مهنة موقتة مدى الحياة أو قد يفقد حياته في أي لحظة. كانت تخشى أن يكون اللقاء فرصة إضافية لتعرية واقع ترفضه. هذا الواقع الذي يتسع معه التفاوت الاجتماعي الذي تعيشه طرابلس حسب ما يقول شادي نشابة مؤسس جمعية Utopia، مع زيادة البطالة والإدمان والتسرّب المدرسي الناتج عن النزاع المتجدّد بين «باب التبانة» و»جبل محسن».
وردة حمراء في شارع الحمرا 7 سنوات، وحتى الثالثة صباحاً يبيع الورد...
كنت أنتظر رؤية معاذ، الطفل السوري الذي التقيته صدفة في شارع الحمرا واشتريت منه وردة قبل أيام. لكنني وجدت طفلاً آخر يصغره سناً. كان محمد يجلس على الرصيف، يرتدي سترة حمراء ويحمل إناء فيه ورود حمراء. «لا أريد أن أظهر على التلفزيون. لا أحب أن أظهر في نشرة الأخبار»، يقول محمد من حلب، يستوقف المارة بعبارات رومانسية لتسير حياته الدرامية خارج سورية.
أكثر ما يزعجه في لبنان؟ «لا شيء». سألته عن معاذ: «معاذ صديقي. هو أيضاً من حلب لكنني تعرفت إليه في المدرسة هنا. أنا من علمته بيع الورد». في أي مدرسة؟ «أظن أنها في منطقة قصقص خاصة للسوريين لا تشبه المدارس العادية». كان عبد اللطيف يجلس قريباً. هو شقيق معاذ الصغير (5 سنوات) الذي يعاني من ركبته، يبيع الورد أيضاً. لم يكن أي منهم يعمل في سورية. كانوا يتعلمون فقط.
ما الفرق بين المدرسة هنا وتلك التي كان يجلس على مقاعدها في سورية سألت محمد: «يكثرون من دروس الإملاء هنا. إملاء إملاء على الدوام». من يعطيك الورد لبيعه؟ «من منطقة العدلية، استقل سيارة وأجلبه من هناك. أشتري الوردة ب500 ليرة لبنانية من هناك». وبكم تبيعها؟ «بألفَي ليرة. وقد أحصل على المزيد من المارة. لكنني لم أتمكن من بيع هذه الورود منذ يومين ولذلك أنا مضطر لخفض ثمنها». إن لم تتمكن من بيعها ما الذي قد يحصل؟ «ستغضب والدتي». ما المبلغ الأعلى الذي حصلت عليه في ليلة واحدة؟ «100 ألف ليرة، أعطتني إياها سيّدة لكنها لم تأخذ أي وردة». ماذا فعلت بهذا المبلغ؟ «أعطيته لوالدتي. ردت لي نصفه. فخبأته». هل تعمل والدتك؟ «تعمل في الوزارة، تعدّ القهوة وترتب المكان». هل ترغب في العودة إلى سورية؟ «لا. أخاف من الحرب، نعيش في الجنة هنا». ما أكثر ما تخشاه في الحرب؟ «الطائرة... أخاف أن تقصف المكان الذي أجلس فيه، والقناص». إلى أي وقت تبقى في شارع الحمرا؟ «حتى الثالثة صباحاً» يجيب محمد طفل السبع سنوات. أقل مبلغ جنيته؟ «20 ألف ليرة». هل تحب مهنة بيع الورد؟ «أنا صغير. عليّ أن أذهب إلى المدرسة فقط وألعب هناك بالألوان وأطبعها على الجدران». حضر معاذ لاحقاً، هو من الرقّة ويكبر محمد سناً لكنهما في الصف نفسه. أسأل معاذ، لم وضعوكما معاً؟ «لقد وضعوا كل الصغار معاً لأنها مدرسة مجانية. ينتهي الدوام الساعة ال12 ظهراً بينما في سورية الثانية بعد الظهر». بم تحلم؟ «أن أصبح طبيباً... أخاف أن يذبل الورد قبل أن أبيعه. لا أحب الورد». هل يعمل والداك؟ «والدي وجد عملاً في مجال البناء هنا. لكنني أحب مساعدته بعد أن خضع شقيقي الصغير لعملية في رجله». يقول لي محمد متأسفاً: «أنظري إلى ورد خليل (زميله في بيع الورد أيضاً) لقد ذبلت ورودي! سأبيعها ببضعة آلاف». هل تعرف العملة اللبنانية جيداً؟ يقول ابن السابعة «الألف ليرة السورية مرسوم عليها حافظ الأسد وهي كالمئة دولار هنا. بينما الألف ليرة اللبنانية لا تساوي شيئاً هنا». من هي الشخصية المرسومة على الألف ليرة لبنانية؟ «لا يوجد أي رجل». أين تقيم؟ «أعيش مع أمي في غرفة صغيرة في منطقة الظريف. إيجارها الشهري 450 دولاراً».
شاركالأكثر قراءة

إطلالات النجوم
أكثر الإطلالات جرأة على السجادة الحمراء في حفل...

إطلالات النجوم
سيرين عبد النور تتألق في العراق بفستان مجسم...

إطلالات النجوم
لماذا تفضّل أحلام الأزياء المطرزة في إطلالاتها؟

إطلالات النجوم
نانسي عجرم تحيّر الجمهور بإطلالتها.. عصرية أم...

أخبار النجوم
ياسمين عبد العزيز وكريم فهمي يشوّقان الجمهور...
المجلة الالكترونية
العدد 1092 | كانون الثاني 2026

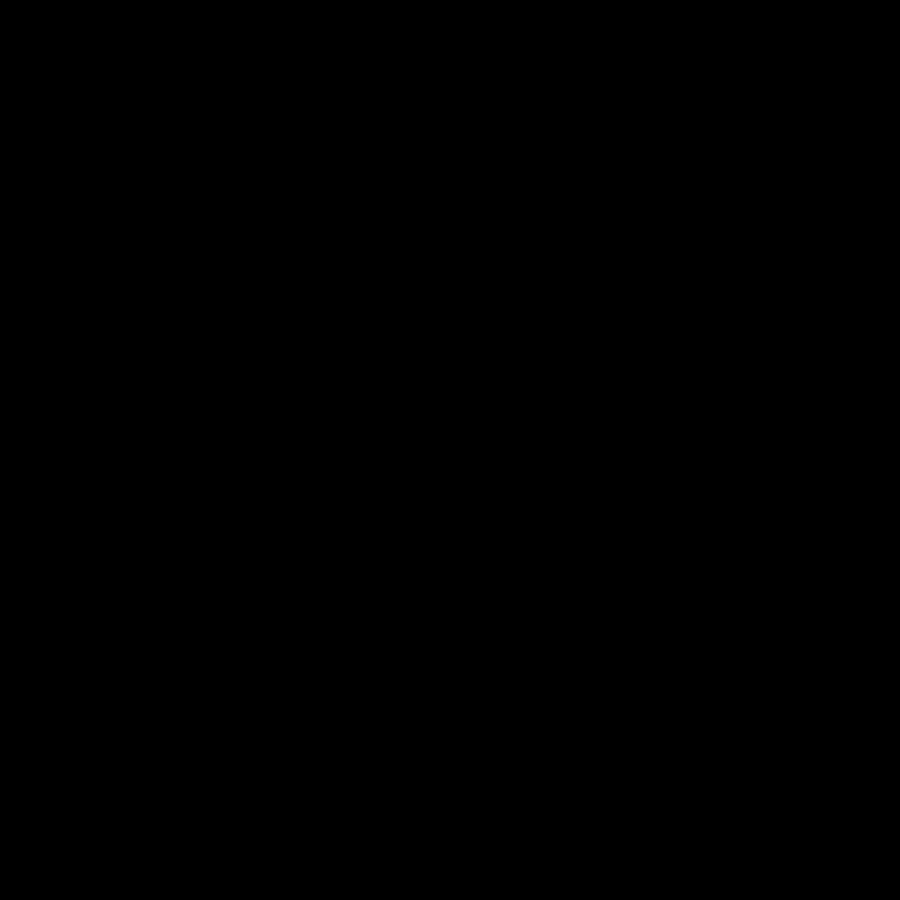
 إشترك
إشترك












