اسطنبول... المدينة التي يتقاطع فيها مجد التاريخ وبهاء العصر



















لم أكن أخطط لزيارة اسطنبول في إجازة عيد الأضحى، ولكن فاجأني أبناء عمي بعرض مغرٍ، تمضية إجازة عيد الأضحى في هذه المدينة التي تحضن الكثير من السحر والنوستالجيا التاريخية، رغم ارتباطها في ذاكرتنا المشرقية بفرمانات الباب العالي التي كانت في غالبيتها تحمل قرارات قاسية بحق سكان الولايات العثمانية. هكذا كان قرار السفر إلى إسطنبول مفاجئًا وعفويًا.
حملنا حقائبنا الصغيرة وحلّقنا بين بيروت واسطنبول التي وصلنا إليها مساءً، وكانت المدينة تضج حركة وكأن اليوم بنهاره وليله لا يكفي سكّان اسطنبول، بل ربما يستدينون الوقت غير آبهين لصيرورته، يتسابقون مع زائري المدينة على غلبته، والاستمتاع بأكبر قدر من مدينة تحضن كل أسرار الإمبراطورية العثمانية، بانتصاراتها وانكساراتها، مدينة وفيّة لمؤسس الجمهورية التركية الحديثة مصطفى كمال أتاتورك وفي الوقت نفسه فخورة بأمجاد سلاطينها وولاتها.
فالتاريخ هنا ليس استعراضاً للمعالم التي تروي أحداثه بل يقيم علاقة جميلة مع الحياة المعاصرة، وكلاهما يفخر بوجوده على طريقته.
وضعنا أمتعتنا في غرفنا وقررنا «اجتياح» اسطنبول ليلاً، إذ لا عذر لنا للتكاسل فاسطنبول تبعد عن بيروت ساعة ونصف الساعة، والناس تحتفل بأول أيام عيد الأضحى.
قررنا التوجّه إلى شارع الإستقلال في منطقة تقسيم الأكثر شهرة في اسطنبول، والقريب من الفندق الذي نزلنا فيه.
الشوارع الفرعية المندسة بين الفنادق تضجّ بالسياح، وقد خصصت للمشاة واصطفت في وسطها أحواض زهور تفصل بين طرفي الطريق حيث تنتشر مقاهي الرصيف عند أقدام الفنادق، بعضها يقدّم الشيشة والشاي فقط وبعضها يقدم الأطباق، والطريف أنه يمكن لمن يتنزّه أن يجلس على كرسي صغير وسط الطريق ويطلب كوب شاي ويشارك في لعبة الحياة على الطريقة التركية.
اجتزنا الشارع الفرعي ووصلنا إلى ميدان الإستقلال الذي يقف نصب لجنود أتراك في وسطه، كانت الحشود البشرية تتماوج بشكل مهيب والكل يستمتع بمساء اسطنبول... ولجنا في متاهة الإستقلال بعدما اشترينا الكستناء من أحد الباعة المتجولين.
هناك تلفتك النظافة التي تطغى على العربات وطريقة عرض الكستناء المشويّة المرصوفة بشكل أنيق تثير فيك شهية التهامها وإن لسعت حرارتها لسانك.
الحشود غفيرة في شارع الإستقلال وعليك أن تواكب اتجاهها وتحتفل معها، هنا عازف يلعب على البوزوك أو العود وينتظر منك أن ترمي في طبقه بعض النقود، وفي زاوية أخرى مجموعة متنكرة تستعرض أزياءها بفخر، يدهشك تنافس الألوان الموسيقية التي تصدح على طول الشارع. كل واحد في هذا الشارع قرّر الإحتفال على طريقته.
عدنا أدراجنا إلى الفندق لنستعد للسهر في نادي رينا الأشهر في اسطنبول، كانت الحادية عشرة ليلاً والطرق مزدحمة والزمن يراقب صبر سكان اسطنبول وزوّارها، ونحن بدرونا لم نيأس وصمّمنا على أن نصل إلى المكان علماً أن سائق التاكسي كان يقود وكأنه شوماخر في حلبة السباق. لم تستطع ابنة عمي أن تكبت دهشتها عندما رأت جسر البوسفور المعلّق فوق المضيق بأبّهة لم يستطع الليل أن يحجب أناقة هندستها.
وأخيرًا وصلنا إلى رينا حيث كان الإحتفال مستمراً رغم أن الساعة تخطت منتصف الليل، وعندما تركنا المكان عند الثانية صباحًا كان المكان قد ارتفع عدد روّاده بشكل كبير، وشعرنا بأن الكل ينظر إلينا باستغراب كيف نغادر والسهرة في بدايتها.
استيقظت على همهمات ابنة عمي تقول: «واو عيناي لا تصدّقان ما تريانه». إنها المرة الأولى التي تزور فيها اسطنبول، علّقت: «ديانا معقول هذا الجمال، أريد أن أسكن هنا». المدينة كانت بدأت تغسل وجهها بلفحات تشرين الباردة لتبقى شابة لا تدهمها تجاعيد الزمن المنافس الأبدي لشباب المدن.
بين الجامع الأزرق وبلاط «الباب العالي» توبكابي تجوال في التاريخ الإسلامي
في البهو كان ينتظرنا ابن عمنا، حاملاً بيده خريطة المدينة متأهبًا لمساعدتنا على اكتشاف اسطنبول التي يزورها باستمرار فصار يعرفها كما يعرف مدينته الأم.
ركبنا المترو الذي خرج من بطن المدينة ليرمينا وسط التاريخ المتناثر على سطحها في منطقة مسجد السلطان أحمد أو كما يعرف بالمسجد الأزرق.
كل شيء في هذه المنطقة ينطق بالتاريخ الإسلامي المجيد، الجوامع والقصور العثمانية تقف بشموخ منذ قرون تستقبل زوّار المنطقة بصمت جميل، فتبدو الحدائق العامة المتحلّقة حولها التي اندست فيها مقاهي الرصيف محطة لابد اجتيازها للدخول إلى متاهة التاريخ.
اخترقنا البوابة الكبيرة للجامع الأزرق الذي تتوسطه ساحة كبيرة لا تزال تحتفظ برونقها، حيث كل تفصيل فيها مشغول بالرخام. حاولنا الولوج إلى قلب المسجد لكن الحشود الكبيرة التي وقفت في الصف أحبطت عزيمتنا.
فقرر ابن عمي أن نذهب إلى قصر توبكابي وتعني «الباب العالي»، مشينا إليه واخترقنا بوابته الكبيرة لنفاجأ بأننا دخلنا إلى مكان أقرب إلى مدينة صغيرة منه إلى قصر فاجتزنا الحديقة التي تغص بالزوّار والصف الطويل الذي احتشد فيها الناس من جميع الجنسيات.
يئسنا في البداية فإذا أردنا الإلتزام بالصف فهذا يعني أننا لن نصل إلى كشك بيع البطاقات قبل أربع ساعات، فاقترح ابن عمي خطة طريفة، بأن نسير وكأننا لا نعرف ماذا يحدث ثم نخترق الصف في بدايته، طبقنا خطته وقد نجحت ولكن المفارقة أن هناك من لاحظ الأمر وغض الطرف وابتسم لنا.
فقلنا لأنفسنا تخيّلوا لو كنا في زمن السلطان وعرف بمخالفتنا القانون في عقر «الباب العالي» فأي فرمان كان سيصدره! المفارقة الثانية كانت حين تحدّثت إلينا شابة عربية وطلبت منا المساعدة في شراء ثلاث بطاقات لأنها لم تعرف أنها تحتاجها وأن والدتها وأختها في انتظارها عند البوابة الثانية، لم نقتنع كثيرًا بادعائها ولكن ساعدناها لأننا لم نكن أحسن حالا منها.
بدأ مشوارنا في أجنحة البلاط السلطاني، واستوقفتنا الباحة التي كان السلطان يقف عندها ليحيّي الجند، أو عندما كان يصدر فرماناته، ثم انتقلنا إلى المتحف الذي يضم تذكارات تجعلك تشعر برهبة التاريخ والإيمان.
ففي هذا المتحف شاهدنا عصا النبي موسى، وسيوف الصحابة وشعرة النبي محمد صلى الله عليه وسلّم وسيفيه. وعلى الرغم من اختلاف أعراق الزوار وأديانهم فالخشوع كان سيد المكان. خرجنا من المتحف مذهولين بما رأيناه.
أخذنا استراحة شاي في أحد المقاهي الموجودة في القصر والتي تسلّقت على أطرافه لتشرف على مضيق البوسفور، وكانت كلها مزدحمة بالرواد، ولكن استطعنا أن نجد مكانًا للإستمتاع بمشهد عز نظيره.
بعد توبكابي دخلنا متاهة اسطنبول العصرية متوجهين نحو مركز جواهر التجاري لتناول الغداء في مطعم «اسكندر». إنهالت علينا الأطباق التركية التي لا يمكن مقاومة طعمها اللذيذ، فكان لزاماً علينا أن ننسى مسألة الرشاقة.
عند المساء تجولنا في شارع الإستقلال متوجهين إلى ناد ليلي نصحنا به موظف الفندق، فقلة تعرف هذا النادي على ذمة الموظف وتقصده النخبة أي أصحاب الذوق الفني الصعب. بالفعل وصلنا إلى النادي وكانت هناك فرقة موسيقة تملك مغنيتها صوتاً رائعاً تخال للحظة أنه مسجل.
وداع اسطنبول على طريقتها
أمسيتنا الأخيرة في اسطنبول انتهت موسيقيًا ولكن تبقّى لنا نهار بأكمله، فما كان علينا إلا أن نودع اسطنبول على طريقتها. قررنا صباحًا أن نتوجه نحو البوسفور وتناول الفطور في أحد المقاهي المنتشرة على ضفته. بالفعل كان المكان يستحق المغامرة، أن تتناول فطورك بالقرب من البوسفور حيث يلتقي البحران، مرمرة والبحر الأسود، فيمتزج موجاهما وتياراهما ليغازلهما طير النورس الذي يحلق بكثافة محدقًا إلى جوف البوسفور علّه يحصل على صيد وفير.
بعد الجولة البوسفورية، أسرعنا الخطى نحو المحطة وكدنا أن نركب القطار الخطأ لو لم نسأل، ولكن المفارقة أننا عدنا وانتظرنا في المحطة الخطأ لولا أن أحد الركاب نزل من المقصورة مسرعاً ونبهنا إلى أن هذه المحطة ليست متوجهة إلى ميدان تقسيم... شكرناه وسألنا أنفسنا كيف يقال عن الأتراك إنهم باردو الطباع...
ركبنا القطار الذي نقلنا إلى مركز إيستينيا بارك التجاري خلال عشرين دقيقة، وقد ساعدنا في الوصول إلى المركز زوجان لاحظا ارتباكنا فعرضا علينا أن نرافقهما لأنهما ذاهبان إلى المركز التجاري، وركبنا معهما الميني باص وكانت مغامرة طريفة لأن الباص كان مكتظًا وعلينا أن ندفع عن كل واحد منا ليرة وربع الليرة، فساعدنا الركاب الذين كانو جميعًا واقفين يحاولون تثبيت أقدامهم، ومع ذلك كان هناك شاب راكب أعطى نقودنا للسائق، فانهالت عليه الطلبات وهو لم يمانع وصار يمازح باللغة التركية.
وصلنا إلى المركز وكان يغص بالناس، هنا المشهد يختلف قليلاً عن مركز جواهر. رغم أن الإجراءات الأمنية نفسها حيث يخضع كل زائر للتفتيش عبر البوابة الإلكترونية، فإن مظاهر الثراء واضحة في رواده، فهنا يستعرض أصحاب الطبقة الراقية سياراتهم، وأسلوب عيشهم تقرأه في مشيتهم وفي ارتيادهم للمقاهي لاسيما في الجناح المفتوح... أما نحن فلم نكترث لاستعراضاتهم بل كان همنا تناول الغداء والعودة إلى الفندق لنلحق بطائرة العودة إلى بيروت.
تركنا اسطنبول بغصّة، فخلال يومين استطاعت هذه المدينة أن تخضعنا لفرمانها العالي وتجعلنا مأخوذين بجمالها، فنحن اكتشفنا النادر من أسرارها. مدينة جمعت بين القارتين فغرقت في بوسفورها كل التناقضات الإثنية ليطفو على وجه مياهها جمال يتسرب إلى أحيائها وأزقتها، فلا عجب أن تقول الأغنية «إذا سألت البحر عن اسطنبول تلعثمت أمواجه في الحديث عنها».
شاركالأكثر قراءة

إطلالات النجوم
كريستينا أغيليرا تتألق بمجوهرات شوبارد الماسية...

إطلالات النجوم
نانسي عجرم تحيّر الجمهور بإطلالتها.. عصرية أم...

أخبار النجوم
محامي زينة يكشف حقيقة دفع أحمد عز 2.5 مليون...

أخبار النجوم
مطالبات بطرد محمود السراج من مصر بعد تصريحات...

إطلالات النجوم
ديمة قندلفت تتألق في أسبوع باريس للأزياء...
المجلة الالكترونية
العدد 1092 | كانون الثاني 2026


سياحة وسفر
في نيويورك البيضاء… حيث يصبح الحب أكثر دفئاً في فندق "ذا مارك"

سياحة وسفر
وجهات السفر الشهيرة على تيك توك

سياحة وسفر
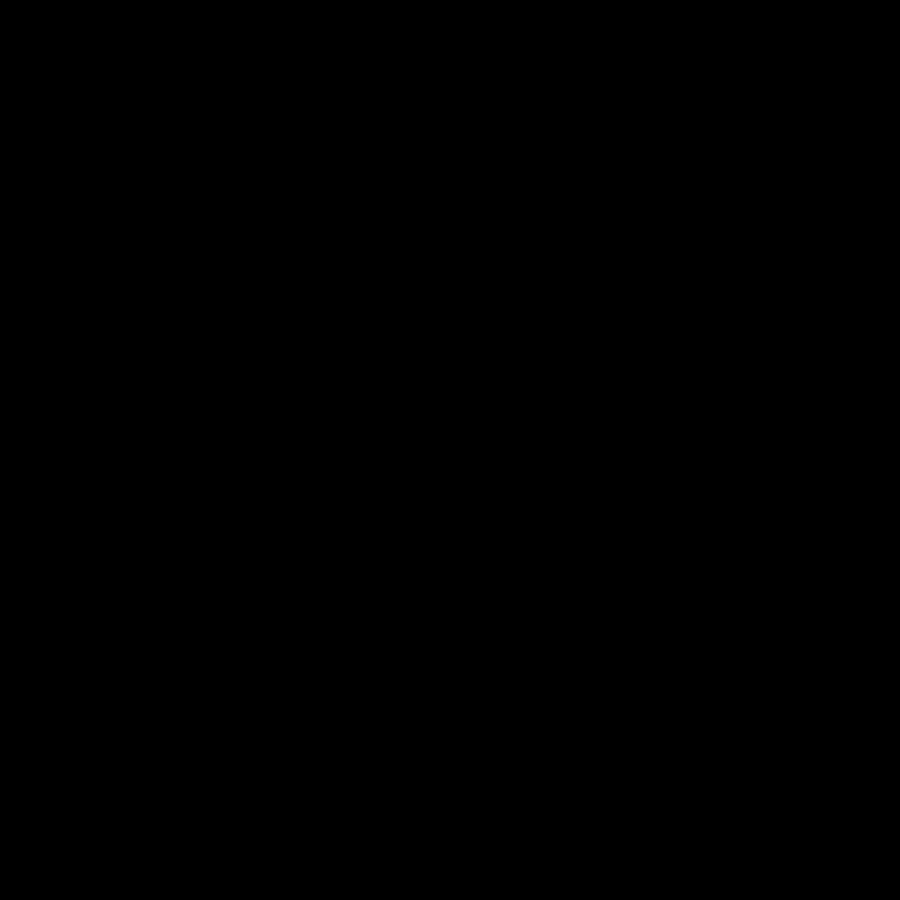
 إشترك
إشترك









