الدكتورة سفانة المشهدي تكتشف عوالم أمراض الشيخوخة وألزهايمر





أطلقت جناحيها خارجةً من قفص الطموح المحدود نحو غربة العلم والنجاح، في رحلة اختارت هي أن تفتح أبوابها الموصدة، وتتفرد بمجال عكس شغفها وكشف تساؤلاتها، لتخدم ببحوثها الإنسانية والوطن على حد سواء. الدكتورة الباحثة في مجال العلوم العصبية وأمراض الشيخوخة سفانة المشهدي، هي كبيرة باحثي العلوم العصبية في مدينة الملك فهد في الرياض، والحاصلة على درجة الدكتوراه وزمالة البحث العلمي في الخلايا الجذعية من جامعة “شيفيلد” البريطانية، وزمالة أمراض الشيخوخة من “معهد ماساتشوسيتس للتكنولوجيا” في الولايات المتحدة الأميركية... في هذا الحوار، نستعرض شريط ذكريات نجاح الدكتورة المشهدي وطموحاتها المستقبلية.
- د. سفانة، حدّثينا أولاً عن طفولتك وكيف اكتشفت ميولك إلى علم الأحياء؟
ترعرعت في كنف أسرة هادئة ومستقرة وتحرص على تربية أولادها الثلاثة على المبادئ السليمة. والدي هو اللواء المتقاعد أنور المشهدي، رجل مباحث في وزارة الداخلية، وأمي هي البروفيسورة هند الخليفة أستاذة علم الاجتماع في جامعة الملك سعود في الرياض. كبرت في هذا الجو العائلي، وأتمتع منذ الصغر بقدرة عالية على الاعتماد على النفس وتحمّل المسؤولية، كما أن تلقيّ العلم في مدارس التربية الإسلامية في مدينة الرياض أثّر فيّ كثيراً، فهي كانت الأفضل من حيث المستوى الأكاديمي والكادر التعليمي والتربوي، ولكن لطالما أحسست بمحدودية النظم والقوانين الصارمة التي أثّرت في مظهري وتصرفاتي داخل المدرسة، ليكون البيت وتحديداً أحضان أمي، الملاذ الذي أحلّق فيه وسط خيالات القصص التي كانت ترويها لي كل ليلة قبل الخلود الى النوم، مما نمّى فيّ حب الأدب والقراءة، لأكتشف ميولي الى علم الأحياء من خلال سلسلة كتب “الباب المفتوح” التي كانت عبارة عن نافذة علمية تفتح عقل قارئها على العالم الداخلي لجسم الإنسان، ولطالما كان تفوّقي الدراسي أنا وإخوتي مدعاة فخر لوالدينا.
- في مراهقتك، ألم يراودك حلم الزواج؟
في الثانوية العامة، كنت حريصة جداً على تحصيل الدرجات العلمية، لأنني في ذلك الوقت لم أكن أهدف الى النجاح بحد ذاته، بل الى إرضاء والديّ اللذين كنت أخشى أن أخيب ظنّهما وظنّ معلماتي والمحيطين بي، لأجد نفسي مدفوعة الى الأمام وتحقيق النجاح من دون أن أخطط لذلك، فتابعت دراستي ووقع اختياري على كلية العلوم الطبية التطبيقية - قسم المختبرات الطبية في جامعة الملك سعود، وتعمّقت خلال خمس سنوات في دراسة جسم الإنسان ووظائفه الحيوية في الصحة والمرض، وواصلت دراستي بحب وشغف واضعةً نصب عينيّ هدف إتمام تعليمي الأكاديمي والحصول على وظيفة وتكوين أسرة، ولم أفكر يوماً بمتابعة دراساتي العليا، واقتنعت بما وصلت إليه أكاديمياً، خصوصاً بعدما ارتبطت بابن عمّي، وحصلت على وظيفة في مدينة الملك فهد الطبية في مختبر علم الأمراض والأنسجة عام 2005.
- كيف اتخذت قرار الابتعاث، وما الهدف الذي كان يرتسم أمامك حينها؟
الاختيار بالنسبة إليّ قوة كامنة تمنحني لذة الشعور بالتحرّر لممارسة هذا الحق، فكنت في طفولتي أتصوّر أن عقلي مقسم إلى قسمين: قسم يُملي عليّ اتخاذ قرارات متمردة قد تكون خاطئة، والآخر لاتخاذ القرارات السليمة الصائبة، عاقدةً داخلي مناظرةً درامية أبطالها الأصوات الداخلية للوعي الداخلي والضمير، التي ولّدت في داخلي مسؤولية القرار والاختيار، إلى أن باتت مسؤولياتي تكبر أكثر فأكثر مع ولادة ابنيّ “ريان” و “مهرة”، ولم أعد أقوى على التوفيق بين مسؤوليات بيتي وأولادي ووظيفتي، فشعرت أن قدرتي على التحكم باختياراتي بدأت تتلاشى مع صخب الحياة، وفي عام 2009، أي بعد ولادة ابنتي “مهرة” بعام واحد، لاح أمامي خيار الابتعاث بعد أن أعلنت مدينة الملك فهد الطبية عن توافر فرص الابتعاث لقسم المختبرات لدراسة الماجستير في مختلف دول العالم. وعلى الرغم من الضغوط والمسؤوليات الملقاة على عاتقي، شجّعتني والدتي على التفكير في الموضوع والتقدّم للابتعاث، مؤكدةً لي أنني سألقى الدعم من الجميع، وبعد مفاتحة زوجي بالأمر، وجدت منه التشجيع والدعم للقيام بهذه الخطوة من دون أي تردد، فما كان مني إلا أن اتّخذت القرار متلهفةً لتحقيق الحلم.
- من الصعب الموازنة بين مسؤوليات الأمومة والطموح، وخصوصاً طموح الدراسة والتقدّم في المجال العلمي، كيف تتذكرين تلك الأيام؟
بسبب ظروف عمله، لم يستطع زوجي مرافقتي في بعثة الماجستير، فاضطررت للسفر الى بريطانيا مع طفليّ الصغيرين من دون والدهما حاملةً المسؤولية لوحدي. في ذلك الحين، كان عمر ابني ثلاث سنوات، وابنتي سبعة أشهر. وصلت الى مدينة “شيفيلد” مُحمّله بالطموح والآمال، يملأني شعور بالمسؤولية ليس تجاه نفسي وأسرتي وولديّ فحسب، بل تجاه وطني الذي أتاح لي وللكثيرين هذه الفرص لنستثمر من خلالها طاقاتنا ونطوّر أنفسنا. تجاذبتني مجموعة من المشاعر المتناقضة ما بين الخوف والأمل والإحساس بالمسؤولية، هذا فضلاً عن الطموح الشخصي... وسرعان ما التحقت بالجامعة لتتبدّى صعوبات المنهج الدراسي، حيث إن دراسة الماجستير في بريطانيا عبارة عن سنة واحدة فقط، تتم فيها تغطية 10 مواد خلال تسعة أشهر، تليها كتابة البحث ورسالة الماجستير. عانيت الكثير بسبب طول الدوام وكثافة المنهج، إذ كنت أدخل قاعة المحاضرات في الثامنة صباحاً وأغادرها عند السادسة مساءً، مسرعةً إلى الحضانة لاصطحاب طفليّ ونحن في حالة من التعب والجوع... في البداية عانيت توتراً شديداً وإرهاقاً لا يطاق، نجحت في التغلّب عليهما ما إن بدأت تنظيم وقتي. لكن مع حلول فصل الشتاء، بدأت تواجهني مشكلة مرض طفليّ بصورة متكررة، مما كان يمنعني من الذهاب إلى الجامعة، ولطالما أثّر فيّ بكاؤهما حين كنت أستودعهما في الحضانة، وأتركهما قاصدةً الجامعة، مما كان يزيد من آلامي ويشوّش أفكاري... أيام عصيبة مرت عليّ استطعت اجتيازها والتأقلم معها بدعم من زوجي وأهلي الذين حفزوني على مواصلة هذه الطريق، وتشجيع من المشرفين في الجامعة الذين كانوا يساعدون الطلبة بالاستماع الى همومهم ومشاكلهم لتخطّي الصعاب.
معايشتي لمرضى ألزهايمر ومعاناتهم أثارت داخلي التساؤلات ودفعتني للبحث عن الأسباب
- رغم الخيارات المتاحة أمامك، لماذا اخترت دراسة المخ والأعصاب وأمراض الشيخوخة، وفي بريطانيا تحديداً؟
علاقتي الوطيدة بوعيي الداخلي، أثارت فضولي للتعرف على مفاتيح العقل ومكامن قدرة الإنسان وكيفية تحكّمه بتصرفاته وردود فعله وتعامله مع العالم المحيط، فلطالما راودتني التساؤلات عن آلية عمل هذا الدماغ وأسباب شيخوخته ونسيانه لما قد حُفر في ثناياه من ذكريات، وكنت أفكر في مدى صعوبة أن يأسر النسيان الإنسان، فيعجز عن التعرّف على الأماكن والأسماء وحتى على نفسه. ولعل معايشتي لأعراض مرض ألزهايمر التي يعانيها عدد من أقاربي، قد دفعتني للتعرّف على الأسباب بالبحث والقراءة، لأجد ندرةً في عدد الدراسات التي أُجريت على العوامل المحفزة التي تزيد من احتمالية الخَرَف. ومن هنا اخترت دراسة الجزيئات الحيوية والعصبية في كلية الطب، وتحديداً في بريطانيا لحبّي لهذه الدولة الأوروبية الراقية، ولتطور البحث العلمي في صروحها الجامعية العريقة، وخصوصاً ما يتعلق بقسم العلوم العصبية والشيخوخة، وحصلت على القبول من جامعة “شيفيلد” لدراسة الماجستير في هذا القسم.
- الصعوبات التي مررت بها كان يمكن أن تثنيك عن متابعة مسيرتك العلمية وتحول دون نيلك الدكتوراه، ما الذي شجّعك على المواصلة؟
بعد تأقلمي مع صعوبات الغربة، تجدّدت في داخلي الرغبة لمتابعة الدراسة في هذا الصرح الأكاديمي العريق، فأقنعت زوجي بمرافقتي في هذه الرحلة، وساعدني أنه هو أيضاً كان يطمح الى استكمال دراساته العليا، وهكذا زالت العراقيل... وكنت من أوائل المبتعثات من مدينة الملك فهد الطبية لدراسة الدكتوراه، حيث حظيت بدعم كبير من أساتذتي، الدكتور محمود يماني، والدكتور خالد المسرع، والدكتور عدنان الوطبان، الذين آمنوا بقدراتي وشجّعوني على متابعة الدراسة، وكان لهم الفضل في نجاحي.
فرحتي لحظة اكتشافي الفروق تحت المجهر أعجز عن وصفها
- التعمق في دراسة الأعصاب والدماغ يلزمه صفاء ذهن وقوة تركيز عالية، إضافة إلى الصبر والكثير من الاجتهاد، كيف استطعت تنظيم وقتك والتكيّف مع متطلبات الدراسة؟
بالإضافة إلى مساعدة الأهل والزوج والدكاترة المشرفين ومساعدتهم، لا بد من الجهد الشخصي والصبر والمتابعة.
مشروعي للدكتوراه كان يتضمّن دراسة ميدانية كبيرة عن الشيخوخة في بريطانيا شملت 450 شخصاً تفوق أعمارهم السبعين عاماً، حيث وافق هؤلاء الأشخاص على التبرّع بأدمغتهم عند وفاتهم لخدمة البحث العلمي ودراسة أسباب الخرف، وبالتحديد ألزهايمر، وهكذا كان. وخلال بحثنا في هذا المجال، وجدنا أن حرباً حقيقيةً تشتعل بين الخلايا العصبية والخلايا المساندة للأعصاب في الدماغ. وبعد البحث المتواصل، توصّلنا إلى نتيجة مفادها أن خلل وظائف “الجينوم” هو أحد الأسباب الرئيسة التي تؤدي إلى فقد الخلايا العصبية المساندة قدرتها على دعم الأعصاب. هذا البحث وُثّق بمقالين منشورين في مجلات مُحكّمة عالمياً، وفاز بجوائز عدة، من ضمنها أفضل بحث علميّ في مؤتمر الأبحاث العصبية في جامعة “باث” في بريطانيا عام 2013. وعلى الرغم من الجهد والضغط الهائل الذي تعرّضت له وما زلتُ خلال عملي في البحوث على هذا النسيج “الغالي” الذي هو “مخ الإنسان”، تبقى أجمل اللحظات لحظة اكتشافي تحت المجهر للفروق بين الأعصاب في أنسجة مخ الشخص المصاب بألزهايمر وبين أنسجة مخ الشخص السليم.
- وصلت الى مرحلة متقدّمة علميّاً وحققت الكثير من طموحاتك الشخصية، ما نصيب الوطن من هذا العائد كنوع من رد الجميل؟
استحوذ بحث الدكتوراه على أغلب وقتي، إلا أنني كنت أنتظر الفرصة المناسبة لأعود بالنفع على بلدي، فكانت بدايةً مساهمتي المتواضعة في إرساء أسس التعاون بين مدينة الملك فهد الطبية وجامعة “شيفيلد” في مجال العلوم العصبية، وتحقق هذا الطموح عام 2013، حين فُتح باب التواصل بين المنشأتين وتم التباحث في أوجه التعاون المشتركة من خلال زيارة وفد من مدينة الملك فهد برئاسة الرئيس التنفيذي لمركز العلوم العصبية الدكتور محمود اليماني، حيث كانت ثمرة هذا الاتفاق إجراء أبحاث مشتركة في علوم الشيخوخة بين البلدين، ولاحقاً استقطبت مدينة الملك فهد عدداً من الطلبة الذين كانوا على وشك إنهاء بحوث الدكتوراه في الجامعة للعمل بعد التخرج في المركز الوطني للعلوم العصبية في مدينة الملك فهد الطبية، وبارك هذه الجهود الرؤساء التنفيذيون في المنشأتين، وكذلك كانت محل احتفاء من سفير المملكة العربية السعودية لدى المملكة المتحدة، الأمير محمد بن نواف بن عبدالعزيز آل سعود، حيث جاء تكريمي من السفارة كإحدى طالبات الدكتوراه المتميزات لعام 2014.
- لذّة النجاح والتفوّق قد تدفع الإنسان إلى الاكتفاء والغرور، هل انتابك هذا الشعور عند حصولك على شهادة الدكتوراه؟
كانت مناقشتي لبحث الدكتوراه في شهر كانون الثاني/ يناير من العام 2015، في يوم غدت فيه “شيفيلد” بيضاء كالسحاب لكثافة الثلج، منظر بعث في نفسي التفاؤل والانشراح، وانتابتني مشاعر الاطمئنان والثقة في النفس، فها أنا أمّ لثلاثة أبناء تتّجه بكل فخر لتقديم بحثها الذي خرج مكتملاً كطفلها الرابع، بفضل الله وبتعبي وجهدي وبدعاء والديّ ودعم زوجي، وبعد ساعتين من مناقشة الأطروحة أمام المحكّمين نالت إعجابهم، لتتوّج ثمرة عملي بالنجاح والتفوق، رُشّحت إثرها لنيل الزمالة البحثية في الخلايا الجذعية مدعومةً من مدينة الملك فهد الطبية. كان هذا البحث الأول والوحيد في بريطانيا، وكان يتضمّن أخذ خزعة بسيطة من جلد مريض ألزهايمر من العيادة وزرع الخلايا الجلدية في المختبر ومن ثم إعادة برمجة “الجينوم” بطرق مُحْكمة، بهدف تحويل الخليّة الجلدية إلى الخلية العصبية الأم، ومن ثم إلى كلّ الخلايا العصبية المساندة، وبهذه الطريقة بات في مقدورنا أخذ خلية عصبية من جسم المريض والتي تحتوي على الشفرة الجينية المسبّبة للمرض، طبعاً من دون المساس بالجهاز العصبي، وهذا النوع من البحوث العصبية المتطورة سمح لنا باستخدام خلايا مرضى ألزهايمر لإجراء دراسات علاجية متخصصة لكل مريض على حدة.
- بعد أشهر من عودتك إلى أرض الوطن اختبرت غربةً ثانية، لماذا؟
بعد انتهائي من الزمالة البحثية في الخلايا الجذعية، عدت بلهفة إلى أرض الوطن، وتم تعييني في عام 2016 كبيرة الباحثين في وحدة العلوم العصبية في مدينة الملك فهد الطبية تحت رئاسة الدكتور عدنان الوطبان والدكتور خالد المسرع، ثمّ كان ترشيحي لبرنامج زمالة ابن خلدون لإجراء الزمالة البحثية للعلوم العصبية في الجامعة الأولى على مستوى العالم “معهد ماساتشوسيتس للتكنولوجيا” في مدينة بوسطن الأميركية، وقد تم اختياري كواحدة من خمس عالمات على مستوى المملكة للذهاب لمدة عام بهدف إجراء البحوث وتعزيز التعاون بين البلدين. وفي الحقيقة كانت تلك التجربة ثرية ورائعة وساعدتني على ربط جزيئات بحوثي السابقة وتتويجها بالعمل في أرقى المعامل بين “معهد ماساتشوسيتس” و”هارفارد”، كما دعمتْ زمالة ابن خلدون تطوّر العالِمات السعوديات في مجالات عدة أخرى عدا البحث العلمي، من خلال ورش عمل وبرامج تعليم تنفيذي في كلّيتي “سلون” و “هارفارد” لإدارة الأعمال، وها قد شارفت الزمالة على الانتهاء، ولكن أثرها المهني والعلمي والشخصي سيبقى ما حييت، ففي تلك السنة تعلّمت كيف يكون المرء عالِماً ناجحاً، وكيف يكون أكثر شمولية وأعمق رؤية من خلال اكتساب المهارات ودمج الأفكار والمفاهيم الجديدة بشكل يتوافق مع مهاراتنا الحالية، وتوسعت مداركي لجهة التطوّر السريع في التكنولوجيا وعالم “الروبوتات” والذكاء الاصطناعي الذي يغزو عصرنا الحالي.
- سلسلة نجاحات وإنجازات علمية متواصلة تسجّلها العالمات والباحثات السعوديات وأنت إحداهن، أين هي الأضواء الإعلامية وهل من تقصير في هذا المجال؟
أعتقد أن التركيز الإعلامي على إنجازات البحث العلمي للسيدات السعوديات ليس كافياً، وأرجّح أن السبب وراء ذلك هو كون البحث العلمي الأساس في المملكة لا يزال يخطو خطواته الأولى، إضافة إلى كون مسؤولي المنشآت الطبية أو مجالات إدارات الأعمال مثلاً يفضلون المردود السريع والفوري لدعم الباحثين الشباب وتسليط الضوء عليهم وعلى إنجازاتهم، من دون النظر الى كون طبيعة البحوث العلمية عموماً تحتاج إلى نفَس طويل ودعم بعيد المدى. وأعتقد أن النجاح الحقيقي يكمن في متابعة التقدم من دون النظر الى الشهرة وعناوين الصحف، فالهدف الحقيقي هو خدمة الإنسانية وخدمة الوطن. ثمّ إن أنظار الإعلام تُصوّب على السياسيين والرياضيين ورجال الأعمال أكثر من الأبحاث وتطور العلوم، فالأخرى جمهورها ضئيل وعائداتها بطيئة.
شاركالأكثر قراءة

إطلالات النجوم
أكثر الإطلالات جرأة على السجادة الحمراء في حفل...

إطلالات النجوم
سيرين عبد النور تتألق في العراق بفستان مجسم...

إطلالات النجوم
نانسي عجرم تحيّر الجمهور بإطلالتها.. عصرية أم...

إطلالات النجوم
لماذا تفضّل أحلام الأزياء المطرزة في إطلالاتها؟

أخبار النجوم
ياسمين عبد العزيز وكريم فهمي يشوّقان الجمهور...
المجلة الالكترونية
العدد 1092 | كانون الثاني 2026

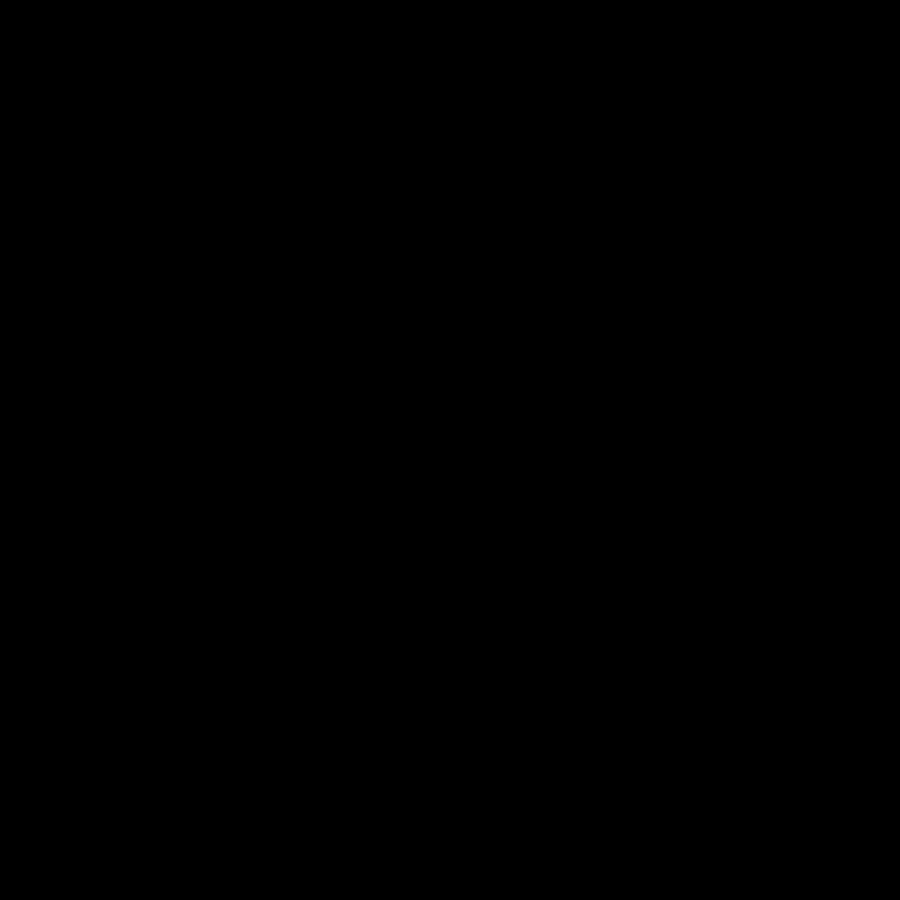
 إشترك
إشترك












