السفير الأديب الباحث والكاتب د. خالد زيادة يعترف: «وقعت في حب جارتي... وكان حباً صامتاً»


قبل أن يُسند اليه منصب سفير لبنان في مصر وفي جامعة الدول العربية، كتب الدكتور خالد زيادة الكثير عن وقائع الحياة والتاريخ، وكان للشعر والرواية والقصة بعض الظلال في مرآة هذا الكاتب الذي أنهى سنواته التسع سفيراً وعاد الى مكانه بين الحروف والكلمات والأبحاث، والتقته «لها» فدار بينهما حديث يرسم معالم حياة عبرت، وأخرى تتقدم.
- كيف تعرّف بنفسك؟
المهنة التي مارستها أطول مدة في حياتي العمليّة كانت التعليم الجامعي. وحين عُينت سفيراً للبنان في مصر، ومندوباً في جامعة الدول العربية، كنت أُعرّف بنفسي في الكتب التي أصدرتها وأعدت طباعتها في القاهرة: «أستاذ جامعي يشغل حالياً منصب سفير لبنان في جمهورية مصر العربية». هذا من الناحية المهنية، أما من ناحية الكتابة بالمعنى الواسع للكلمة، فقد اتجهت باكراً للبحث في مسائل التاريخ الفكري والثقافي وتطور المؤسسات المنتجة للثقافة. فمن هذه الوجهة أعرّف بنفسي كباحث، وقد تعودت على ذلك، لكن بعد مرور الوقت على تعريفي كمؤرخ، وبعض المراسلات التي كانت تأتيني، كانت تصل إلى قسم التاريخ، رغم أنني لم أدرس التاريخ، وقد دَرَسْت لمدة ربع قرن في معهد العلوم الاجتماعية، وفي الاصل درست الفلسفة في الجامعة اللبنانية. هذه الالتباسات لا تُزعجني، بل على العكس، تشعرني بنوع من التعدّد، فقد خضت في التاريخ والاجتماع والأدب.
- تؤرخ وتتعامل مع الزمن بناسه وأمكنته، ماذا قطفت من العلاقة مع التاريخ؟
قراءاتي المبكرة حين كنت لا أزال على مقاعد الدراسة قبل الجامعية كانت تتراوح بين الأدب والشعر والمؤلفات التاريخية والفكرية. وكان لهذا تأثير في اتجاهاتي اللاحقة. ولا شك في أن قراءة التاريخ العربي كانت تجذبني في المحيط العروبي الذي نشأت فيه. ولكن في المرحلة الجامعية، كنت قد اتجهت إلى الاهتمام بتاريخ الأفكار والمؤثرات الثقافية. وفي اختصار، أنا لست مؤرخاً بالمعنى الحرفي للكلمة، وإنما أستخدم التاريخ كإطار لفهم العلاقات المبكرة بين عالم العرب والإسلام من جهة، وعالم أوروبا والغرب من جهة أخرى. كما اشتغلت على سجلات المحاكم الشرعية التي ترجع إلى ثلاثة قرون من الزمن، وبحثت فيها عن الجذور الماضية للظواهر الاجتماعية الراهنة.
أما عن الناس والأمكنة، فقد كتبت ثلاثية عن مدينة طرابلس صدرت عن «دار النهار»، وأعدت نشرها في مصر في مجموعة واحدة تحت عنوان «مدينة على المتوسط» أتحدث فيها عن تبدلات الأمكنة والأوقات والبشر منذ خمسينات القرن العشرين. تلك الفترة شهدت تغيرات متسارعة في الحياة المدينية، وانتقالاً للسكان من الأحياء القديمة إلى تلك الحديثة، وتبدّلاً في العادات... إلاّ أن الاندفاع إلى التحديث أورث مشكلات عدة لم تكن مرئية في ذلك الحين.
- هل ترى نفسك تحمل قلم النقد في سبيل كشف حقيقة تتوخّاها؟
هذا السؤال عميق ومهم، يواجهه كل كاتب: لماذا نكتب وما الذي نبحث عنه وما الذي نريد أن نقوله؟ وأظن أن أجيال الكتّاب العرب في القرن العشرين كانوا قد اعتقدوا أنهم في أعمالهم يقدمون جزءاً من الحقيقة لقرائهم. وأمام طغيان القضايا والتحولات الاجتماعية والسياسية، كان الباحثون والأدباء يظنون أنهم يكشفون عن الحقائق والوقائع في كتاباتهم. والحقيقة أن العرب بعامة لم يكونوا على امتداد القرن العشرين، وحتى زمننا الراهن يملكون ترف الكتابة من أجل الإمتاع، ذلك أن عصر أبي حيان التوحيدي، و«الإمتاع والمؤانسة» قد ولّى منذ زمن بعيد.
وبالنسبة إليّ، أنا الذي نشأتُ في بيئة تضج بالقضايا السياسية والوقائع الكبرى، والذي شهدتُ في مطلع حياتي، وكنت لا أزال على مقاعد الدراسة نكسة 1967 وحرب لبنان 1975 وما تلاهما من وقائع، تلعب الكتابة دوراً في الكشف والتنوير. لكنني أظن أنني كنت متنبهاً لتجنب كل الحمولات الأيديولوجية.
- ما الذي يقلقك اليوم؟
أمور كثيرة تقلقني، أولاً مرور الوقت من دون أن أحقق كل ما أرغب في كتابته، وثانياً الاوضاع العربية والمحيطة بلبنان، والتي لن نرى نهاية قريبة لها.
- تجربتك الديبلوماسية كسفير، هل كانت مُثقلة بالهموم أم أعطتك فرصة ما؟
لا شك في أن المسؤولية التي كنت أحملها كسفير في مصر ومندوب للبنان في جامعة الدول العربية كانت دقيقة وحساسة، خصوصاً أنني أمثّل بلداً يعيش حالة اضطراب وانقسام، فكان عليّ أن أحافظ على مقدار رفيع من الدقة في ترجمة المواقف الرسمية، وإلى ذلك فإن المهمة في مصر وجامعة الدول العربية كانت غنية جداً، فخلال ما يقرب من التسع سنوات تعلمت الكثير عن مصر أولاً، وعن العلاقات العربية- العربية. ولكنني في الوقت نفسه كنت حريصاً على متابعة عملي الأكاديمي والبحثي، ونشرت بعض الكتب والأعمال الجديدة. كما استفدت من تعرفي إلى العديد من المثقفين المصريين الذين صاروا أصدقائي، والأهم من ذلك أنني عايشت كل أحداث مصر منذ 2011، مما أغنى تجربتي، وبالتالي أثّر في فهمي للواقع العربي.
- هل الديبلوماسية ساعدتك على إنجاز كتابات جديدة؟
في العادة، كنت أقول حين يوجّه إليّ سؤال حول الفارق بين العمل الأكاديمي والعمل الديبلوماسي، إن الديبلوماسية هي فرع من فروع العلوم السياسية. كانت تلك طريقتي في التقريب بين المجالين، ومع ذلك لم أكن ديبلوماسياً تقليدياً ووظيفياً، فقد وجدت أنني بطريقة ما أتابع تقاليد العلاقات الثقافية بين لبنان ومصر، وأذكّر بتراث النهضويين اللبنانيين الذين برزوا في مصر، لهذا عمدت إلى تنظيم ندوة حول جرجي زيدان في دار الهلال، وشاركت في إحياء ذكرى تأسيس اللبناني نجيب متري لدار المعارف، وغير ذلك من النشاطات.
أما تأثير الديبلوماسية في كتاباتي فيحدث بطريقة غير مباشرة، لأن تجربتي التي امتدت على عدد من السنوات وخبرتُ فيها مسائل في السياسة والعلاقات بين الدول، قد عمّقت معرفتي بشؤونٍ ما كان لي أن أخبرها بالقراءة مثلاً. في ذهني أن أكتب عن مصر وليس عن مهمتي كسفير، أن أكتب شيئاً عن العلاقات الثقافية والتبدّل الذي طرأ عليها خلال ما يزيد عن القرن من الزمن.
- كيف يمكن الكاتب أن يمارس عملاً سياسياً، هل من تعارض بين الثقافة والسياسة؟
هذه مسألة قديمة قيل فيها الكثير، ولكن من خلال اشتغالي على موضوع المثقف سابقاً وحالياً، وجدت أن الأمر يتعلق بموضوعات متمايزة:
أولاً : هناك فارق بين مجال الاختصاص، فالمجال الثقافي مغاير للمجال السياسي، وكل مجال يحتاج إلى تفرغ نسبي وإلى أدوات عمل مختلفة.
ثانياً : هناك فارق في الثقافات، وخصوصاً الحديثة منها، فقد ورثنا في لبنان الموقف اللاتيني، والفرنسي تحديداً، حيث الثقافة تتعارض مع السلطة، وهذا تقليد فرنسي متبع منذ أيام ديكارت وروسو مروراً بهيغو وصولاً إلى سارتر. ولكن في التجربة الانكلوساكسونية فإن المثقفين والفلاسفة كانوا رجال إدارة وسلطة من فرنسيس بيكون في مطلع القرن السابع عشر، إلى جون لوك في نهايته... وكذلك الأمر في التجربة التاريخية الألمانية حيث صاغ المفكرون الألمان (فخته، هيغل وماركس) مفاهيم الدولة والسياسة.
ثالثاً: عادةً ما نطالب المثقف بدور اجتماعي وسياسي ونلومه على صمته. هذا يعني أننا نطالب المثقف بموقف من القضايا التي تفتح أمامه باب السياسة.
رابعاً: في العالم غير الأوروبي، كان قادة الأحزاب الثورية من المثقفين، فالذين كانوا أكثر إدراكاً لمشاكل بلدانهم، اعتقدوا ان وعيهم يدعوهم إلى الخوض في السياسة.
خامساً : لا بد من التمييز بين الوظيفة والدور في ما يتعلق بالمثقف، الوظيفة هي أن يتقن ما يقوم به من عمل (جامعي، صحافي، أدبي...)، أما الدور فهو ما يدعوه المجتمع للقيام به. والمسألة تكمن في المزاوجة بين الوظيفة والدور.
- وأخيراً، كيف تحضر المرأة في كتاباتك؟
من المؤسف أن المراحل الزمنية التي أتناولها في كتاباتي لم يكن للمرأة حضور بارز فيها. يعوض ذلك حضور المرأة في حياتي الواقعية. في كتابي «يوم الجمعة يوم الأحد»، وهو الجزء الأول من ثلاثية «مدينة على المتوسط»، تحدثت عن تجاربي الأولى في «حب» جارتي، وكان حباً صامتاً. ثم أشرت إلى علاقاتنا كصِبية مع بنات المدارس اللواتي نصادفهن في طريقنا إلى المدرسة، وعن تجارب الصِبية مع زميلات النشاط الحزبي. في رواية «حكاية فيصل» التي كتبتها عن الثورة العربية، كان ظهور المرأة معدوماً في وقائعها، ومع ذلك جعلت الملك فيصل يلتقي بعدد من النساء، في أوروبا خاصة.
- وماذا عن الحب في حياتك؟
الحب هو منازلة كبيرة يستخدم خلالها كل شخص أسلحته الذاتية، التي لا يمكن أن تنفع فيها أي مساندة خارجية، وينتهي الحب حين تفقد هذه الأسلحة فعاليتها وإغواءها.-

حفلات ومناسبات لها
"انكر إنوفيشنز" Anker Innovations تفتتح أول متجر لها في دولة الإمارات العربية المتحدة

حفلات ومناسبات لها
بحضور 100 ضيف من عالم الأعمال والثقافة والعلوم... عشاء على شرف محمد بن زايد آل نهيان في فرنسا

حفلات ومناسبات لها
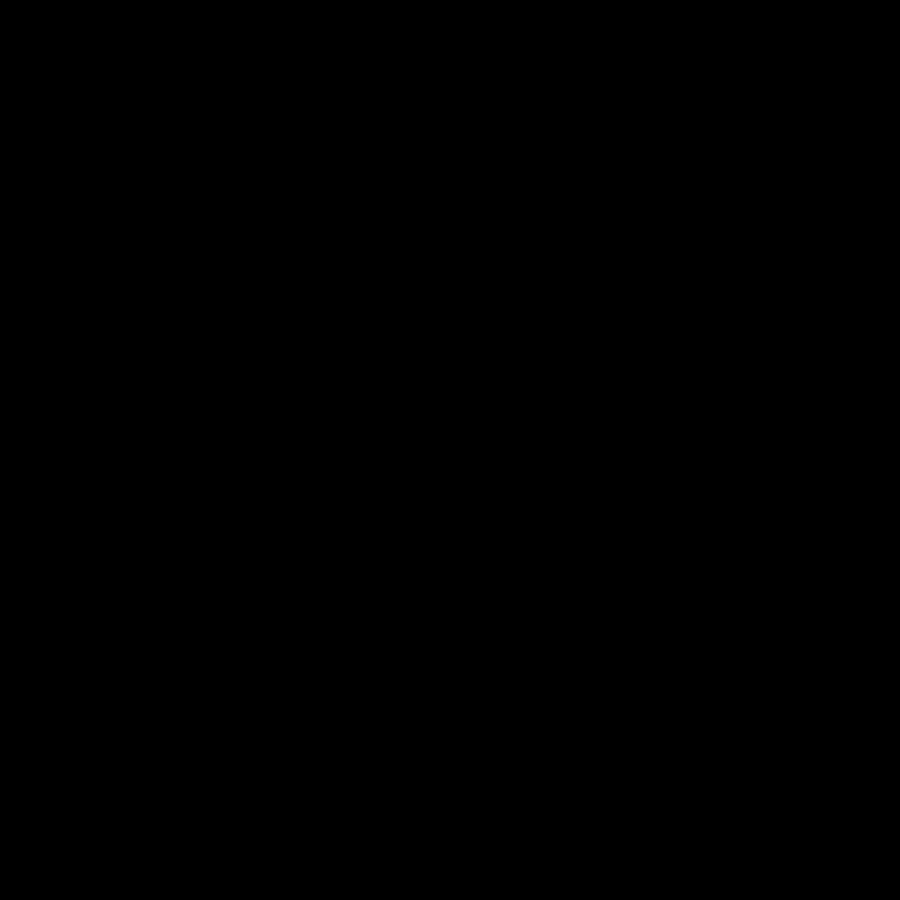

 إشترك
إشترك














